[ ص: 174 ] باب
ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=29577نقط ما زيدت الألف في رسمه
اعلم أن كتاب المصاحف زادوا الألف في الرسم بإجماع منهم في أصل مطرد ، وخمسة أحرف مفترقة . فأما الأصل المطرد فهو ما جاء من لفظ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=259مائة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=65مائتين . وأما الخمسة الأحرف فأولها في ( التوبة ) : " ولأاوضعوا خلالكم " . وكذا في ( النمل ) : " أو لأاذبحنه " وفي ( يوسف ) : " ولا تايئسوا من روح الله إنه لا يايئس من روح الله " . وفي ( الرعد ) : " أفلم يايئس الذين ءامنوا " .
وحكى
محمد بن عيسى الأصبهاني أن في المصاحف كلها : " ولا تقولن لشايء " في ( الكهف ) بألف بين الشين والياء . قال : وكذلك ذلك في مصاحف
عبد الله في كل القرآن .
وفي مصاحف أهل بلدنا القديمة المتبع في رسمها مصاحف أهل
المدينة : " وجايء بالنبيين " في ( الزمر ) ، و " جايء يومئذ بجهنم " في
[ ص: 175 ] ( والفجر ) بألف زائدة بين الجيم والياء . وفيها أيضا في ( آل عمران ) : " لإالى الله تحشرون " وفي ( والصافات ) : " لإالى الجحيم " بزيادة ألف . ولم أجد أنا ذلك كذلك مرسوما في شيء من مصاحف أهل
العراق القديمة .
* * *
فأما زيادتهم الألف في
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=259مائة فلأحد أمرين : إما للفرق بين
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=259مائة وبين
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=60منه ، من حيث اشتبهت صورتهما . ثم ألحقت التثنية بالواحد فزيدت فيها الألف ، لتأتيا معا على طريقة واحدة من الزيادة . وهو قول عامة النحويين . قال القتبي : زادوا الألف في
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=259مائة ليفصلوا بها بينها وبين
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=60منه ، ألا ترى أنك تقول : " أخذت مائة " ، و " أخذت منه " . فلو لم تكن الألف لالتبس على القارئ . وإما تقوية للهمزة من حيث كانت حرفا خفيا بعيد المخرج ، فقووها بالألف ؛ لتتحقق بذلك نبرتها . وخصت الألف بذلك معها من حيث كانت من مخرجها ، وكانت الهمزة قد تصور بصورتها . وهذا القول عندي أوجه ؛ لأنهم قد زادوا الألف بيانا للهمزة وتقوية لها في كلم لا تشتبه صورهن بصور غيرهن ، فزال بذلك معنى الفرق ، وثبت معنى التقوية والبيان ؛ لأنه مطرد في كل موضع .
فإذا نقط هذا الضرب جعلت الهمزة نقطة بالصفراء ، وحركتها من فوقها نقطة بالحمراء ، في الياء نفسها . وجعل على الألف دارة صغرى ؛ علامة لزيادتها في الخط وسقوطها من اللفظ ، سواء جعلت فرقا بين مشتبهين في الصورة أو تقوية وبيانا . وصورة نقط ذلك كما ترى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=259مائة ،
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=65مائتين .
[ ص: 176 ] وقد غلط بعض أئمتنا في نقط هذا الضرب غلطا فاحشا ، فزعم أن الهمزة تقع فيه على الألف دون الياء ، إذ الألف صورتها من حيث كانت متحركة بالفتح ، والياء هي المزيدة . وهذا ما لم يتقدمه إلى القول به أحد من الناس ممن علم وممن جهل .
هذا مع علم هذا الرجل بأن الألف في ذلك زيدت للفرق ، فكيف تكون مع ذلك صورة للهمزة ، وبأن الهمز إنما ترسم صوره على حسب ما تؤول في التسهيل ؛ دلالة على ذلك . والهمزة في ذلك إذا سهلت أبدلت ياء مفتوحة ؛ لانكسار ما قبلها ؛ فالياء صورتها ، لا شك . ولا تجعل بين الهمزة والألف رأسا ؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها مكسورا . فكذلك لا يكون ما قرب بالتسهيل منها . وهذا قول جميع النحويين . والله يغفر له .
* * *
وأما زيادتهم الألف في " ولأاوضعوا " ، و " أو لأاذبحنه " فلمعان أربعة . هذا إذا كانت الزائدة فيهما المنفصلة عن اللام ، وكانت الهمزة المتصلة باللام . وهو قول أصحاب المصاحف .
فأحدها أن تكون صورة لفتحة الهمزة ، من حيث كانت الفتحة مأخوذة منها . فلذلك جعلت صورة لها ، ليدل على أنها مأخوذة من تلك الصورة ، وأن الإعراب قد يكون بهما معا .
والثاني أن تكون الحركة نفسها ، لا صورة لها . وذلك أن العرب لم تكن أصحاب شكل ونقط ، فكانت تصور الحركات حروفا ؛ لأن الإعراب قد يكون بها كما يكون بهن . فتصور الفتحة ألفا ، والكسرة ياء ، والضمة واوا .
[ ص: 177 ] فتدل هذه الأحرف الثلاثة على ما تدل عليه الحركات الثلاث ، من الفتح والكسر والضم .
ومما يدل على أنهم لم يكونوا أصحاب شكل ونقط ، وأنهم كانوا يفرقون بين المشتبهين في الصورة بزيادة الحروف ، إلحاقهم الواو في "عمرو" فرقا بينه وبين "عمر" . وإلحاقهم إياها في "أولئك" فرقا بينه وبين "إليك". وفي "أولي" فرقا بينه وبين
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=14إلى . وإلحاقهم الياء في قوله : " والسماء بنيناها بأييد " فرقا بين "الأيد" الذي معناه القوة ، وبين "الأيدي" التي هي جمع "يد". وإلحاقهم الألف في "مائة" فرقا بينه وبين "منه" و "منة" و "مية" ، من حيث اشتبهت صورة ذلك كله في الكتابة .
وحكى غير واحد من علماء العربية ، منهم
أبو إسحاق إبراهيم بن السري وغيره : أن ذلك كان قبل الكتاب العربي ، ثم ترك استعمال ذلك بعد ، وبقيت منه أشياء لم تغير عما كانت عليه في الرسم قديما ، وتركت على حالها . فما في مرسوم المصحف من نحو " ولأاوضعوا " هو منها .
والثالث أن تكون دليلا على إشباع فتحة الهمزة وتمطيطها في اللفظ ، لخفاء الهمزة وبعد مخرجها ، وفرقا بين ما يحقق من الحركات وبين ما يختلس منهن . وليس ذلك الإشباع والتمطيط بالمؤكد للحروف ، إذ ليس من مذهب أحد من أئمة القراءة ، وإنما هو إتمام الصوت بالحركة لا غير .
والرابع أن تكون تقوية للهمزة وبيانا لها ، ليتأدى بذلك معنى خفائها . والحرف الذي تقوى به قد يتقدمها ، وقد يتأخر بعدها .
[ ص: 178 ] وإذا كانت الزائدة من إحدى الألفين المتصلة في الرسم باللام ، وكانت الهمزة المنفصلة عنها ، وهو قول الفراء وأحمد بن يحيى وغيرهما من النحاة ، فزيادتها لمعنيين :
أحدهما الدلالة على إشباع فتحة اللام وتمطيط اللفظ بها .
والثاني تقوية للهمزة وتأكيدا لبيانها بها . وإنما قويت بزيادة الحرف في الكتابة ، من حيث قويت بزيادة المد في التلاوة ، لخفائها وبعد مخرجها . وخصت الألف بتقويتها وتأكيد بيانها ، دون الياء والواو ، من حيث كانت الألف أغلب على صورتها منهما ، بدليل تصويرها ، بأي حركة تحركت من فتح أو كسر أو ضم ، بها دونهما ، إذا كانت مبتدأة . هذا مع كونها من مخرجها . فوجب تخصيصها بذلك دون أختيها .
فإذا نقط ذلك على المذهب الذي تكون فيه الهمزة المختلطة باللام ، وتكون الألف الزائدة المنفصلة عنها جعلت الهمزة نقطة بالصفراء في الطرف الأول من طرفي اللام ألف ؛ لأنه الألف التي هي صورة الهمزة . وجعلت حركتها نقطة بالحمراء في رأس الألف الزائدة المنفصلة ، إذا جعلت صورة لها .
وإذا جعلت الحركة نفسها لم تجعل النقطة عليها ، ولا على الهمزة . وأعريتا معا منها ، لأن الحرف لا يحرك بحركتين إحداهما نقط والثانية خط .
وإذا جعلت بيانا للهمزة أو علامة لإشباع فتحتها ، جعلت النقطة الحمراء
[ ص: 179 ] التي هي الحركة على الهمزة نفسها ، وجعل على الألف دارة صغرى ، علامة لزيادتها في الخط وسقوطها من اللفظ ، من حيث رسمت لمعنى يتأدى بصورتها فقط .
وصورة نقط ذلك على الأول كما ترى : " ولأاوضعوا " ، " أو لأاذبحنه " . وعلى الثاني : " ولأاوضعوا " ، " أو لأاذبحنه " . وعلى الثالث والرابع : " ولأاوضعوا " ، " أو لأاذبحنه " .
وإذا نقط ذلك على المذهب الذي تكون فيه الهمزة المنفصلة عن اللام ، وتكون الألف الزائدة المختلطة بها ؛ جعلت الهمزة نقطة بالصفراء ، وحركتها عليها نقطة بالحمراء ، على الألف المنفصلة . وجعل على الألف المختلطة باللام دارة صغرى ؛ علامة لزيادتها . سواء جعلت تقوية للهمزة ، أو علامة لإشباع حركتها . وصورة نقط ذلك كما ترى : " ولأاوضعوا " ، " أو لأاذبحنه " ،
[ ص: 180 ]
[ ص: 174 ] بَابٌ
ذِكْرُ
nindex.php?page=treesubj&link=29577نَقْطِ مَا زِيدَتِ الْأَلِفُ فِي رَسْمِهِ
اعْلَمْ أَنَّ كُتَّابَ الْمَصَاحِفِ زَادُوا الْأَلِفَ فِي الرَّسْمِ بِإِجْمَاعٍ مِنْهُمْ فِي أَصْلٍ مُطَّرِدٍ ، وَخَمْسَةِ أَحْرُفٍ مُفْتَرِقَةٍ . فَأَمَّا الْأَصْلُ الْمُطَّرِدُ فَهُوَ مَا جَاءَ مِنْ لَفْظِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=259مِائَةَ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=65مِائَتَيْنِ . وَأَمَّا الْخَمْسَةُ الْأَحْرُفِ فَأَوَّلُهَا فِي ( التَّوْبَةِ ) : " وَلَأَاوْضَعُوا خِلَالَكُمْ " . وَكَذَا فِي ( النَّمْلِ ) : " أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ " وَفِي ( يُوسُفَ ) : " وَلَا تَايْئَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَايْئَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ " . وَفِي ( الرَّعْدِ ) : " أَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِينَ ءَامَنُوا " .
وَحَكَى
مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْأَصْبَهَانِيُّ أَنَّ فِي الْمَصَاحِفِ كُلِّهَا : " وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ " فِي ( الْكَهْفِ ) بِأَلِفٍ بَيْنَ الشِّينِ وَالْيَاءِ . قَالَ : وَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي مَصَاحِفِ
عَبْدِ اللَّهِ فِي كُلِّ الْقُرْآنِ .
وَفِي مَصَاحِفِ أَهْلِ بَلَدِنَا الْقَدِيمَةِ الْمُتَّبَعِ فِي رَسْمِهَا مَصَاحِفُ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ : " وَجِايءَ بِالنَّبِيِّينَ " فِي ( الزُّمَرِ ) ، وَ " جِايءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ " فِي
[ ص: 175 ] ( وَالْفَجْرِ ) بِأَلِفٍ زَائِدَةٍ بَيْنَ الْجِيمِ وَالْيَاءِ . وَفِيهَا أَيْضًا فِي ( آلِ عِمْرَانَ ) : " لَإِالَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ " وَفِي ( وَالصَّافَّاتِ ) : " لَإِالَى الْجَحِيمِ " بِزِيَادَةِ أَلِفٍ . وَلَمْ أَجِدْ أَنَا ذَلِكَ كَذَلِكَ مَرْسُومًا فِي شَيْءٍ مِنْ مَصَاحِفِ أَهْلِ
الْعِرَاقِ الْقَدِيمَةِ .
* * *
فَأَمَّا زِيَادَتُهُمُ الْأَلِفَ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=259مِائَةَ فَلِأَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا لِلْفَرْقِ بَيْنَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=259مِائَةً وَبَيْنَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=60مِنْهُ ، مِنْ حَيْثُ اشْتَبَهَتْ صُورَتُهُمَا . ثُمَّ أُلْحِقَتِ التَّثْنِيَةُ بِالْوَاحِدِ فَزِيدَتْ فِيهَا الْأَلِفُ ، لِتَأْتِيَا مَعًا عَلَى طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الزِّيَادَةِ . وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ النَّحْوِيِّينَ . قَالَ الْقُتَبِيُّ : زَادُوا الْأَلِفَ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=259مِائَةً لِيَفْصِلُوا بِهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=60مِنْهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ : " أَخَذْتُ مِائَةً " ، وَ " أَخَذْتُ مِنْهُ " . فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْأَلِفُ لَالْتَبَسَ عَلَى الْقَارِئِ . وَإِمَّا تَقْوِيَةً لِلْهَمْزَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَتْ حَرْفًا خَفِيًّا بَعِيدَ الْمَخْرَجِ ، فَقَوَّوْهَا بِالْأَلِفِ ؛ لِتَتَحَقَّقَ بِذَلِكَ نَبْرَتُهَا . وَخُصَّتِ الْأَلِفُ بِذَلِكَ مَعَهَا مِنْ حَيْثُ كَانَتْ مِنْ مَخْرَجِهَا ، وَكَانَتِ الْهَمْزَةُ قَدْ تُصَوَّرُ بِصُورَتِهَا . وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدِي أَوْجَهُ ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ زَادُوا الْأَلِفَ بَيَانًا لِلْهَمْزَةِ وَتَقْوِيَةً لَهَا فِي كَلِمٍ لَا تَشْتَبِهُ صُوَرُهُنَّ بِصُوَرِ غَيْرِهِنَّ ، فَزَالَ بِذَلِكَ مَعْنَى الْفَرْقِ ، وَثَبَتَ مَعْنَى التَّقْوِيَةِ وَالْبَيَانِ ؛ لِأَنَّهُ مُطَّرِدٌ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ .
فَإِذَا نُقِطَ هَذَا الضَّرْبُ جُعِلَتِ الْهَمْزَةُ نُقْطَةً بِالصَّفْرَاءِ ، وَحَرَكَتُهَا مِنْ فَوْقِهَا نُقْطَةً بِالْحَمْرَاءِ ، فِي الْيَاءِ نَفْسِهَا . وَجُعِلَ عَلَى الْأَلِفِ دَارَةٌ صُغْرَى ؛ عَلَامَةً لِزِيَادَتِهَا فِي الْخَطِّ وَسُقُوطِهَا مِنَ اللَّفْظِ ، سَوَاءٌ جُعِلَتْ فَرْقًا بَيْنَ مُشْتَبِهَيْنِ فِي الصُّورَةِ أَوْ تَقْوِيَةً وَبَيَانًا . وَصُورَةُ نَقْطِ ذَلِكَ كَمَا تَرَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=259مِائَةَ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=65مِائَتَيْنِ .
[ ص: 176 ] وَقَدْ غَلِطَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا فِي نَقْطِ هَذَا الضَّرْبِ غَلَطًا فَاحِشًا ، فَزَعَمَ أَنَّ الْهَمْزَةَ تَقَعُ فِيهِ عَلَى الْأَلِفِ دُونَ الْيَاءِ ، إِذِ الْأَلِفُ صُورَتُهَا مِنْ حَيْثُ كَانَتْ مُتَحَرِّكَةً بِالْفَتْحِ ، وَالْيَاءُ هِيَ الْمَزِيدَةُ . وَهَذَا مَا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ إِلَى الْقَوْلِ بِهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ عَلِمَ وَمِمَّنْ جَهِلَ .
هَذَا مَعَ عِلْمِ هَذَا الرَّجُلِ بِأَنَّ الْأَلِفَ فِي ذَلِكَ زِيدَتْ لِلْفَرْقِ ، فَكَيْفَ تَكُونُ مَعَ ذَلِكَ صُورَةً لِلْهَمْزَةِ ، وَبِأَنَّ الْهَمْزَ إِنَّمَا تُرْسَمُ صُوَرُهُ عَلَى حَسَبِ مَا تَؤُولُ فِي التَّسْهِيلِ ؛ دَلَالَةً عَلَى ذَلِكَ . وَالْهَمْزَةُ فِي ذَلِكَ إِذَا سُهِّلَتْ أُبْدِلَتْ يَاءً مَفْتُوحَةً ؛ لِانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا ؛ فَالْيَاءُ صُورَتُهَا ، لَا شَكَّ . وَلَا تُجْعَلُ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْأَلِفِ رَأْسًا ؛ لِأَنَّ الْأَلِفَ لَا يَكُونُ مَا قَبْلَهَا مَكْسُورًا . فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ مَا قُرِّبَ بِالتَّسْهِيلِ مِنْهَا . وَهَذَا قَوْلُ جَمِيعِ النَّحْوِيِّينَ . وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ .
* * *
وَأَمَّا زِيَادَتُهُمُ الْأَلِفَ فِي " وَلَأَاوْضَعُوا " ، وَ " أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ " فَلِمَعَانٍ أَرْبَعَةٍ . هَذَا إِذَا كَانَتِ الزَّائِدَةُ فِيهِمَا الْمُنْفَصِلَةَ عَنِ اللَّامِ ، وَكَانَتِ الْهَمْزَةُ الْمُتَّصِلَةَ بِاللَّامِ . وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْمَصَاحِفِ .
فَأَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ صُورَةً لِفَتْحَةِ الْهَمْزَةِ ، مِنْ حَيْثُ كَانَتِ الْفَتْحَةُ مَأْخُوذَةً مِنْهَا . فَلِذَلِكَ جُعِلَتْ صُورَةً لَهَا ، لِيُدَلَّ عَلَى أَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ تِلْكَ الصُّورَةِ ، وَأَنَّ الْإِعْرَابَ قَدْ يَكُونُ بِهِمَا مَعًا .
وَالثَّانِي أَنْ تَكُونَ الْحَرَكَةُ نَفْسَهَا ، لَا صُورَةً لَهَا . وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَكُنْ أَصْحَابَ شَكْلٍ وَنَقْطٍ ، فَكَانَتْ تُصَوِّرُ الْحَرَكَاتِ حُرُوفًا ؛ لِأَنَّ الْإِعْرَابَ قَدْ يَكُونُ بِهَا كَمَا يَكُونُ بِهِنَّ . فَتُصَوِّرُ الْفَتْحَةَ أَلِفًا ، وَالْكَسْرَةَ يَاءً ، وَالضَّمَّةَ وَاوًا .
[ ص: 177 ] فَتَدُلُّ هَذِهِ الْأَحْرُفُ الثَّلَاثَةُ عَلَى مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ ، مِنَ الْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَالضَّمِّ .
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا أَصْحَابَ شَكْلٍ وَنَقْطٍ ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُشْتَبِهَيْنِ فِي الصُّورَةِ بِزِيَادَةِ الْحُرُوفِ ، إِلْحَاقُهُمُ الْوَاوَ فِي "عَمْرٍو" فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ "عُمَرَ" . وَإِلْحَاقُهُمْ إِيَّاهَا فِي "أُولَئِكَ" فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ "إِلَيْكَ". وَفِي "أُولِي" فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=14إِلَى . وَإِلْحَاقُهُمُ الْيَاءَ فِي قَوْلِهِ : " وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْيدٍ " فَرْقًا بَيْنَ "الْأَيْدِ" الَّذِي مَعْنَاهُ الْقُوَّةُ ، وَبَيْنَ "الْأَيْدِي" الَّتِي هِيَ جَمْعُ "يَدٍ". وَإِلْحَاقُهُمُ الْأَلِفَ فِي "مِائَةٍ" فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ "مِنْهُ" وَ "مِنَّةٍ" وَ "مَيَّةَ" ، مِنْ حَيْثُ اشْتَبَهَتْ صُورَةُ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي الْكِتَابَةِ .
وَحَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ ، مِنْهُمْ
أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السَّرِيِّ وَغَيْرُهُ : أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ ، ثُمَّ تُرِكَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ بَعْدُ ، وَبَقِيَتْ مِنْهُ أَشْيَاءُ لَمْ تُغَيَّرْ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الرَّسْمِ قَدِيمًا ، وَتُرِكَتْ عَلَى حَالِهَا . فَمَا فِي مَرْسُومِ الْمُصْحَفِ مِنْ نَحْوِ " وَلَأَاوْضَعُوا " هُوَ مِنْهَا .
وَالثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ دَلِيلًا عَلَى إِشْبَاعِ فَتْحَةِ الْهَمْزَةِ وَتَمْطِيطِهَا فِي اللَّفْظِ ، لِخَفَاءِ الْهَمْزَةِ وَبُعْدِ مَخْرَجِهَا ، وَفَرْقًا بَيْنَ مَا يُحَقَّقُ مِنَ الْحَرَكَاتِ وَبَيْنَ مَا يُخْتَلَسُ مِنْهُنَّ . وَلَيْسَ ذَلِكَ الْإِشْبَاعُ وَالتَّمْطِيطُ بِالْمُؤَكِّدِ لِلْحُرُوفِ ، إِذْ لَيْسَ مِنْ مَذْهَبِ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ إِتْمَامُ الصَّوْتِ بِالْحَرَكَةِ لَا غَيْرُ .
وَالرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ تَقْوِيَةً لِلْهَمْزَةِ وَبَيَانًا لَهَا ، لِيَتَأَدَّى بِذَلِكَ مَعْنَى خَفَائِهَا . وَالْحَرْفُ الَّذِي تُقَوَّى بِهِ قَدْ يَتَقَدَّمُهَا ، وَقَدْ يَتَأَخَّرُ بَعْدَهَا .
[ ص: 178 ] وَإِذَا كَانَتِ الزَّائِدَةُ مِنْ إِحْدَى الْأَلِفَيْنِ الْمُتَّصِلَةَ فِي الرَّسْمِ بِاللَّامِ ، وَكَانَتِ الْهَمْزَةُ الْمُنْفَصِلَةَ عَنْهَا ، وَهُوَ قَوْلُ الْفَرَّاءِ وَأَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِمَا مِنَ النُّحَاةِ ، فَزِيَادَتُهَا لِمَعْنَيَيْنِ :
أَحَدُهُمَا الدَّلَالَةُ عَلَى إِشْبَاعِ فَتْحَةِ اللَّامِ وَتَمْطِيطِ اللَّفْظِ بِهَا .
وَالثَّانِي تَقْوِيَةً لِلْهَمْزَةِ وَتَأْكِيدًا لِبَيَانِهَا بِهَا . وَإِنَّمَا قُوِّيَتْ بِزِيَادَةِ الْحَرْفِ فِي الْكِتَابَةِ ، مِنْ حَيْثُ قُوِّيَتْ بِزِيَادَةِ الْمَدِّ فِي التِّلَاوَةِ ، لِخَفَائِهَا وَبُعْدِ مَخْرَجِهَا . وَخُصَّتِ الْأَلِفُ بِتَقْوِيَتِهَا وَتَأْكِيدِ بَيَانِهَا ، دُونَ الْيَاءِ وَالْوَاوِ ، مِنْ حَيْثُ كَانَتِ الْأَلِفُ أَغْلَبَ عَلَى صُورَتِهَا مِنْهُمَا ، بِدَلِيلِ تَصْوِيرِهَا ، بِأَيِّ حَرَكَةٍ تَحَرَّكَتْ مِنْ فَتْحٍ أَوْ كَسْرٍ أَوْ ضَمٍّ ، بِهَا دُونَهُمَا ، إِذَا كَانَتْ مُبْتَدَأَةً . هَذَا مَعَ كَوْنِهَا مِنْ مَخْرَجِهَا . فَوَجَبَ تَخْصِيصُهَا بِذَلِكَ دُونَ أُخْتَيْهَا .
فَإِذَا نُقِطَ ذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ الْهَمْزَةُ الْمُخْتَلِطَةُ بِاللَّامِ ، وَتَكُونُ الْأَلِفُ الزَّائِدَةُ الْمُنْفَصِلَةَ عَنْهَا جُعِلَتِ الْهَمْزَةُ نُقْطَةً بِالصَّفْرَاءِ فِي الطَّرَفِ الْأَوَّلِ مِنْ طَرَفَيِ اللَّامِ أَلِفٍ ؛ لِأَنَّهُ الْأَلِفُ الَّتِي هِيَ صُورَةُ الْهَمْزَةِ . وَجُعِلَتْ حَرَكَتُهَا نُقْطَةً بِالْحَمْرَاءِ فِي رَأْسِ الْأَلِفِ الزَّائِدَةِ الْمُنْفَصِلَةِ ، إِذَا جُعِلَتْ صُورَةً لَهَا .
وَإِذَا جُعِلَتِ الْحَرَكَةُ نَفْسَهَا لَمْ تُجْعَلِ النُّقْطَةُ عَلَيْهَا ، وَلَا عَلَى الْهَمْزَةِ . وَأُعْرِيَتَا مَعًا مِنْهَا ، لِأَنَّ الْحَرْفَ لَا يُحَرَّكُ بِحَرَكَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا نَقْطٌ وَالثَّانِيَةُ خَطٌّ .
وَإِذَا جُعِلَتْ بَيَانًا لِلْهَمْزَةِ أَوْ عَلَامَةً لِإِشْبَاعِ فَتَحْتِهَا ، جُعِلَتِ النُّقْطَةُ الْحَمْرَاءُ
[ ص: 179 ] الَّتِي هِيَ الْحَرَكَةُ عَلَى الْهَمْزَةِ نَفْسِهَا ، وَجُعِلَ عَلَى الْأَلِفِ دَارَةٌ صُغْرَى ، عَلَامَةً لِزِيَادَتِهَا فِي الْخَطِّ وَسُقُوطِهَا مِنَ اللَّفْظِ ، مِنْ حَيْثُ رُسِمَتْ لِمَعْنًى يَتَأَدَّى بِصُورَتِهَا فَقَطْ .
وَصُورَةُ نَقْطِ ذَلِكَ عَلَى الْأَوَّلِ كَمَا تَرَى : " وَلَأَاوْضَعُوا " ، " أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ " . وَعَلَى الثَّانِي : " وَلَأَاوْضَعُوا " ، " أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ " . وَعَلَى الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ : " وَلَأَاوْضَعُوا " ، " أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ " .
وَإِذَا نُقِطَ ذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ الْهَمْزَةُ الْمُنْفَصِلَةَ عَنِ اللَّامِ ، وَتَكُونُ الْأَلِفُ الزَّائِدَةُ الْمُخْتَلِطَةَ بِهَا ؛ جُعِلَتِ الْهَمْزَةُ نُقْطَةً بِالصَّفْرَاءِ ، وَحَرَكَتُهَا عَلَيْهَا نُقْطَةً بِالْحَمْرَاءِ ، عَلَى الْأَلِفِ الْمُنْفَصِلَةِ . وَجُعِلَ عَلَى الْأَلِفِ الْمُخْتَلِطَةِ بِاللَّامِ دَارَةٌ صُغْرَى ؛ عَلَامَةً لِزِيَادَتِهَا . سَوَاءٌ جُعِلَتْ تَقْوِيَةً لِلْهَمْزَةِ ، أَوْ عَلَامَةً لِإِشْبَاعِ حَرَكَتِهَا . وَصُورَةُ نَقْطِ ذَلِكَ كَمَا تَرَى : " وَلَأَاوْضَعُوا " ، " أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ " ،
[ ص: 180 ]


 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية موسوعة التربية
موسوعة التربية كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام




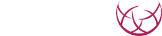








 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات