[ ص: 57 ] باب
ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=29577_28885التنوين اللاحق الأسماء ، وكيفية صورته ، وموضع جعله
اعلم أن التنوين حرف من الحروف ، وهو ساكن في الخلقة ، ومخرجه من الخيشوم ، ولا يقع أبدا إلا في أواخر الأسماء خاصة .
والدليل على أنه حرف من الحروف لزوم التغيير الذي يلحق جميع الحروف السواكن له ، من التحريك للساكنين في نحو : " رحيما النبي " ، ومن إلقاء حركة الهمزة عليه في نحو :
nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=4كفوا أحد ، ومن الحذف في نحو : "
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=30عزير ابن الله ، و " أحد الله " على قراءة من قرأ ذلك كذلك ، ومن الإدغام في نحو :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173غفور رحيم ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=109يومئذ لا تنفع ، و " أليم ما يود " ، وشبه ذلك . فلولا أنه كسائر السواكن لم يلحقه ما يلحقهن من التغيير بالوجوه المتقدمة .
[ ص: 58 ] وإنما لزم الأطراف خاصة ، من حيث كان مخصوصا بمتابعة حركة الإعراب التي تلزم ذلك الموضع ، وتختص به ، وذلك من حيث كان الإعراب داخلا لإفادة المعاني ، وكان زائدا على الاسم .
فإن كان الاسم الذي يقع آخره مجرورا جعل تحت الحرف نقطتان ؛ إحداهما الحركة ، والثانية علامته . وسواء كان الحرف مخففا أو مشددا . وإن كان مرفوعا جعل أمام الحرف نقطتان أيضا . وإن كان منصوبا فكذلك أيضا . إلا أن أهل النقط مختلفون في الموضع الذي تجعل فيه النقطتان . وسنذكر ذلك مشروحا ، ونبين وجه الصواب من اختلافهم ، فيما بعد إن شاء الله . فالمجرور نحو قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=61من رب ،
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=58رب رحيم ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=25من عذاب أليم ، وشبهه . والمرفوع نحو قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=18صم بكم عمي ، وما أشبهه .
* * *
فإن قال قائل : من أين جعل أهل النقط علامة التنوين الذي هو نون خفيفة في اللفظ نقطة كنقطة الحركة ؟ قيل : من حيث جعلها علامة لذلك من ابتدأ النقط من السلف ؛ اتباعا له ، واقتداء به . كما حدثنا
محمد بن علي الكاتب ، قال : نا
محمد بن القاسم ، قال : نا أبي ، قال : نا
أبو عكرمة قال : قال
العتبي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبو الأسود للرجل الذي أمسك عليه المصحف ، حين ابتدأ بنقطه : فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة ؛ فانقطه نقطتين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو : ويعني بالغنة التنوين ؛ لأنه غنة من الخيشوم .
[ ص: 59 ] فإن قال : فمن أين اصطلحوا على جعل علامته علامة الحركة ؟ قيل : من وجهين : أحدهما أنه لما كان مخصوصا بمتابعة الحركات دون السواكن ؛ جعلوا علامته في النقط علامتهن ؛ إشعارا بذلك التخصيص ، وإعلاما به . والثاني أن الحركة لما لزمت أوائل الكلم ، ولزم التنوين أواخرهن ، واجتمعا معا في الثبات في الوصل ، والحذف في الوقف ؛ تأكد ما بين الحركة والتنوين بذلك ، فجعلت علامته علامتها ، دلالة على ذلك التأكيد ، وتنبيها على تناسب ما بينهما في أن كل واحد منهما يثبت بثبات الآخر ، ويسقط بسقوطه .
فإن قيل : فهلا جعلوا علامته علامة السكون ، من حيث كان ساكنا ؟ قيل : لم يفعلوا ذلك لما عدمت صورته في الخط ؛ لزيادته . والسكون والحركة لا يجعلان إلا في حرف ثابت الخط قائم الصورة .
فإن قيل : فلم لم يرسم نونا في الخط ، على اللفظ ؟ قيل : لم يرسم نونا ، من حيث كان زائدا في الاسم الذي يلحق آخره ؛ فرقا بين ما ينصرف وبين ما لا ينصرف من الأسماء ؛ لئلا يشتبه الزائد لمعنى الذي يلحقه التغيير في بعض الأحوال ، بالأصلي اللازم الذي لا يتغير ، كقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=77وأحسن كما أحسن الله إليك ، و " لا تمنن تستكثر " ، و " لا تحزن عليهم " ، وشبه ذلك . فلو رسم التنوين نونا ، وهو زائد يتغير في حال الوقف ؛ لاشتبه بالنون الأصلية في هذه المواضع التي لا يلحقها تغيير في وصل ولا وقف . ففرق بينهما بالحذف والإثبات
[ ص: 60 ] ليتميزا بذلك . ولأجل الفرق بينهما خولف في التسمية بينهما ، فقيل للأصلي : " نون " ، وللزائد : " تنوين " ؛ لينفصلا بذلك ، وتعلم المخالفة بينهما به .
* * *
فأما المنصوب المنون فإنه يبدل منه في حال الوقف ألفا لخفته . وكذلك جاء مرسوما في الكتابة ؛ دلالة على ذلك .
واختلف نقاط المصاحف في كيفية نقطه على أربعة أوجه :
فمنهم من ينقط بأن يجعل نقطتين بالحمراء على تلك الألف المرسومة ، ويعري الحرف المتحرك منهما ، ومن إحداهما . وصورة ذلك كما ترى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23غفورا رحيما ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=48شيئا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31خطئا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=67هزوا ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=130كلا ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=10غلا . وكذا إن كان الاسم المنون مقصورا ، وصورت لامه ياء ؛ دلالة على أصله ، يجعلون النقطتين أيضا على تلك الياء ؛ لأنها تصير ألفا في الوقف . وذلك في نحو قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=2هدى ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=156غزى ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196أذى ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مسمى ، وشبهه . وهذا مذهب
أبي محمد اليزيدي ، وعليه نقاط أهل المصرين
البصرة والكوفة ، ونقاط أهل
المدينة .
ومنهم من يجعل النقطتين معا على الحرف المتحرك ، ويعري تلك الألف وتلك الياء منهما ، ومن إحداهما . وصورة ذلك في الألف كما ترى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11عليما حكيما ،
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31خطئا ، " متكئا " ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=77كفوا . وفي الياء :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=125مصلى ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=156غزى ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=15مصفى ، وشبهه . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل وأصحابه .
[ ص: 61 ] ومنهم من يجعل إحدى النقطتين - وهي الحركة - على الحرف المتحرك ، ويجعل الثانية - وهي التنوين - على الألف ، وعلى الياء . وصورة ذلك في الألف كما ترى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=18عذابا أليما ،
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=57ملجئا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=260جزءا . وفي الياء :
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=41مولى عن مولى ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=156غزى ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=58سوى ، وشبهه .
ومنهم من يجعل نقطة واحدة على الحرف المتحرك ، ونقطتين على الألف . وصورة ذلك كما ترى :
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=38وعادا وثمودا ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=29مثلا رجلا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=34ردءا . وفي الياء :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=2هدى ،
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=44عمى ،
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=156غزى ،
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=36سدى ، وشبهه . وذهب إلى هذين الوجهين قوم من متأخري النقاط . ولا إمام لهم فيهما علمناه .
* * *
فأما علة من جعل النقطتين معا على الألف ؛ فإنه لما كان التنوين ملازما للحركة ، متابعا لها ، غير منفك منها ، ولا منفصل عنها في حال الوصل ، ولا منفرد دونها في اللفظ ، يلزمه ما يلزمها من الثبات في الوصل ، ويلحقه ما يلحقها من الحذف في الوقف ، وكان النقط - كما قدمناه - موضوعا على الوصل دون الوقف ، بدليل تعريبهم أواخر الكلم ، وتنوينهم المنون منها ، وكان ذلك من فعل من ابتدأ بالنقط من السلف الذين مخالفتهم خروج عن الاتباع ، ودخول في الابتداع ، وكان الذين عنوا بكتابة المصاحف من الصحابة - رضي الله عنهم - قد رسموا بعد الحرف المتحرك في جميع ما تقدم ألفا ، وهي التي تعوض من التنوين في حال الوقف ، أو ياء تعود ألفا فيه ، ولم يكن بد من إثبات علامته
[ ص: 62 ] في النقط ، دلالة على صرف ما ينصرف من الأسماء ، جعل نقطة على الحرف المعوض منه ، وهو الألف ، وعلى الحرف الذي ينقلب إلى لفظها ، وهو الياء ، وضم إليها النقطة الأخرى التي هي الحركة ، فحصلتا معا على الألف ، ففهم بذلك وكيد حالهما ، وعرف به شدة ارتباطهما ، وعلم أنهما لا يفترقان ولا ينفصلان ، لا لفظا ولا نقطا ، باجتماعهما على حرف واحد ، وملازمتهما مكانا واحدا .
وصارت الألف بذلك أولى من الحرف المتحرك ، من قبل أنهما لو جعلتا عليه لبقيت الألف عارية من علامة ما هي عوض منه ، مع الحاجة إلى معرفة ذلك ، فتصير حينئذ غير دالة على معنى ، ولا مفيدة شيئا ، فيبطل ما لأجله رسمت ، وله اختيرت ، من بين سائر الحروف . وتكون لا معنى لها في رسم ولا لفظ ، إلا الزيادة لا غير ، دون إيثار فائدة ، ولا دلالة على معنى يحتاج ويضطر إليه . فلما كانت الألف بخلاف ذلك ، وكان رسمها إنما هو للدلالة على الوقف ، والإعلام بأنها مبدلة فيه من التنوين ؛ وجب أن تجعل النقطة - التي هي علامته - عليها ضرورة ، إذ هي هو . وإذا وجب ذلك لم يكن بد من ضم النقطة الثانية إليها ، فتحصلان معا على الألف ، إذ لا تفترقان ولا تنفصلان كما بيناه .
وهذا المذهب في نقط ذلك أختار ، وبه أقول ، وعليه الجمهور من النقاط .
* * *
وأما علة من جعل النقطتين معا - الحركة والتنوين - على الحرف المتحرك ؛ فإنه لما كانت إحداهما هي الحركة جعلها على الحرف المتحرك ؛ دلالة على تحريكه بها ، ثم ضم إليها الثانية التي هي التنوين ، لامتناعهما من الانفصال والافتراق .
وأما علة من جعل إحدى النقطتين على الحرف المتحرك ، والثانية على الألف ؛ فإنه لما كانت إحداهما هي الحركة جعلها على الحرف المحرك بها ، ولما كانت
[ ص: 63 ] الثانية هي التنوين جعلها على الحرف المبدل منه ، وهو الألف ، تأدية لهذا المعنى ، وإعلاما به .
وأما علة من جعل ثلاث نقط ، نقطة على الحرف المتحرك ، ونقطتين على الألف ؛ فإنه لما كانت إحدى النقطتين حركة الحرف المتحرك جعلها عليه ، كما تجعل سائر الحركات على الحروف المتحركة بهن . ثم أعادها مع التنوين ؛ لارتباطه بها وملازمته إياها ، وامتناع كل واحد منهما من الانفصال عن صاحبه ، أعني التنوين عن الحركة ، والحركة عن التنوين ؛ تأكيدا ودلالة على هذا المعنى . فتحقق له بذلك وجهان : أحدهما إيفاء المتحرك حقه من حركته . والثاني تأدية تأكيد ما بين الحركة والتنوين من المصاحبة والملازمة .
وهذه المذاهب الثلاثة فاسدة ، لا تصح عند التحقيق . أما الأول منها الذي ينفرد الحرف المتحرك فيه بالنقطتين ، فإن الألف المرسومة بعده بتعريتها من ذلك تخلو من المعنى الذي لأجل تأديته رسمت ، فيبطل معنى الرسم بذلك . وأما الثاني الذي تجعل فيه إحدى النقطتين على الحرف المتحرك ، والثانية على الألف ؛ فإن ما بين التنوين والحركة من الارتباط والملازمة والاتصال والاشتراك في الإثبات والحذف يذهب ويبطل بذلك . وأما الثالث الذي تجعل فيه ثلاث نقط ؛ نقطة على الحرف المتحرك ، ونقطتان على الألف ، فإن الحرف المتحرك تجتمع له حركتان : حركة عليه ، وحركة على الألف . وغير جائز أن يحرك حرف بحركتين ، وأن تجمعا له ، ويدل بهما عليه . هذا مع الخروج بذلك عن فعل السلف ، والعدول به عن استعمال الخلف .
وإذا فسدت هذه المذاهب الثلاثة بالوجوه التي بيناها ؛ صح المذهب الأول
[ ص: 64 ] الذي اخترناه ، وذهبنا إليه ، واختاره وذهب إليه أهل التحقيق والضبط ، واستعمله الجمهور من أهل النقط .
قال
أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي : أخبرنا
عبيد الله بن محمد بن يحيى اليزيدي ، عن عمه
أبي عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل قال : قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11عليما حكيما بنقطتين فوق الميم طولا ، واحدة فوق الأخرى . قال : ولا أنقط على الألف ؛ لأن التنوين يقع على الميم نفسها . قال
أبو عبد الرحمن : قال
أبو محمد - يعني أباه اليزيدي - : ولكنني أنقط على الألف ؛ لأني إذا وقفت قلت :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11عليما ، فصار ألفا على الكتاب . قال : ولو كان على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل ؛ لكان ينبغي إذا وقف أن يقول :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=29عليم ، يعني بغير ألف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12915ابن المنادي : والعمل في ذلك عند أكثر النقاط نقط الألف المنصوبة بنقطتين : إحداهما للنصب ، والأخرى للتنوين . فإذا صاروا إلى الوقف صاروا إلى الألف .
قال : وذكر
أبو عبد الرحمن أن أهل
الكوفة وبعض النقاط ينقطون المنصوب إذا استقبلته الحروف الحلقية فإذا استقبلته غيرها لم ينقطوا لدلالة الألف على النصب . قال : وكان
اليزيدي يذهب إلى أصل هذا القول ، وخالفه من قال بقوله من سائر النقاط ، فنقطوا المنون في حالاته الثلاث الرفع والنصب والجر ، استقبلته حروف الحلق أو لم تستقبله ، وهو المعمول به حتى الآن عند النقاط . وكذلك هو في المصاحف العتق ، وهو أوثق وأحسن .
[ ص: 65 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو : ولم نر شيئا من المصاحف يختلف في نقطه عن ذلك ، وهو الوجه ، وبه العمل . وبالله التوفيق .
فصل
واعلم أن الاختلاف الذي ذكرناه بين أهل النقط ، في جعل النقطتين ، إنما هو في الكلم اللائي رسمت الألف المبدلة من التنوين فيهن ، على ما بيناه . فأما ما لم ترسم فيه تلك الألف لعلة ، وذلك إذا وليها همزة قبلها ألف كقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=22ماء ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=41غثاء ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=17جفاء ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=171دعاء ونداء ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=138افتراء ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=22مراء ، وشبهه ، وذلك حين كره اجتماع ألفين لاتفاق صورتيهما ، ككره اجتماع ياءين وواوين لذلك ، فإن الاختيار عندي في نقط ذلك أن تجعل النقطتان معا على الهمزة ، لعدم صورة المبدل من التنوين في هذا الضرب ؛ لأنه إنما عدل بهما عن المتحرك في الضرب الأول لما وجدت تلك الصورة قائمة ، فإذا عدمت وجب أن تلزما الحرف المتحرك لا غير .
وقد يجوز عندي في نقط هذا الضرب وجهان ، سوى هذا الوجه :
أحدهما أن ترسم بالحمرة ألف قبل الألف السوداء ، وتوقع الهمزة نقطة بالصفراء بينهما ، وتجعل حركتها مع التنوين نقطتين على الألف السوداء ؛ لأنها هي المبدلة من التنوين في ذلك ، وهي المرسومة على هذا الوجه .
والثاني أن ترسم ألف بالحمرة بعد الألف السوداء ، وتوقع الهمزة نقطة
[ ص: 66 ] بالصفراء بينهما أيضا ، وتجعل حركتها مع التنوين نقطتين على الألف الحمراء ؛ لأنها هي المعوضة من التنوين ، وهي المحذوفة من الرسم لكراهة اجتماع الألفين ، لوقوعها في موضع الحذف والتغيير ، وهو الطرف ، فكانت بالحذف أولى من التي هي في وسط الكلمة ، ولأن من العرب من لا يعوض منه في حال الخفض والرفع ، حكى ذلك عنها
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء nindex.php?page=showalam&ids=13676والأخفش .
وصورة نقط هذا الضرب على الوجه الأول الذي اخترناه وقلنا به ، كما ترى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=22ماء ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=41غثاء ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=17جفاء ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=171دعاء ونداء . وعلى الثاني : " مئا " ، و " غثئا " ، و " جفئا " ، و " دعئا " ، و " ندءا " . وعلى الثالث : " ماءا " ، و " غثاءا " ، و " جفاءا " ، و " دعاءا ونداءا " .
فصل
وإذا كان آخر الاسم الذي يلحقه التنوين في حال نصبه هاء تأنيث ، نحو قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=28وآتاني رحمة ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=12بما صبروا جنة ، و " دانية عليهم " ، وشبهه ؛ فإن النقطتين معا تقعان في ذلك على الهاء التي هي تاء في الوصل لا غير ، لامتناع إبدال التنوين فيه في حال الوقف بامتناع وجود التاء التي يلحقها مع حركة الإعراب هناك ، ولذلك بطل تصوير ما يبدل منه في حال الوقف في هذا النوع .
فصل
فأما النون الخفيفة ؛ فإنها بمثابة التنوين في الزيادة والبدل والرسم ، ولم تأت
[ ص: 67 ] في القرآن إلا في موضعين : أحدهما في (يوسف ) قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=32وليكونا من الصاغرين ، والثاني في
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=14اقرأ قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=15لنسفعا بالناصية ، والقراء مجمعون على إبدال النون فيهما في الوقف ألفا ، كالتنوين الذي يلحق الأسماء المنصوبة ؛ لأن قبل كل واحد منهما ما يشبه الألف ، وهي الفتحة . ولتأدية كيفية الوقف رسما كذلك . والنقاط متفقون أيضا على جعل نقطتين بالحمرة على تلك الألف ؛ لاشتراك ما أبدلت منه مع التنوين في المعاني المذكورة من الزيادة والبدل والرسم ومصاحبة الفتحة .
وكذلك اتفقوا على جعلهما على الألف في نحو :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=76وإذا لا يلبثون ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=53فإذا لا يؤتون ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=140إذا مثلهم ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=75إذا لأذقناك ، وما أشبهه . وذلك من حيث أشبه ذلك النون الخفيفة في اللفظ والرسم والوقف ، ووافقها في هذه الأشياء ، فجرى بذلك مجراها في اللفظ ، وذلك مما لا خلاف فيه ، وبالله التوفيق والإعانة .
[ ص: 57 ] بَابٌ
ذِكْرُ
nindex.php?page=treesubj&link=29577_28885التَّنْوِينِ اللَّاحِقِ الْأَسْمَاءَ ، وَكَيْفِيَّةِ صُورَتِهِ ، وَمَوْضِعِ جَعْلِهِ
اعْلَمْ أَنَّ التَّنْوِينَ حَرْفٌ مِنَ الْحُرُوفِ ، وَهُوَ سَاكِنٌ فِي الْخِلْقَةِ ، وَمَخْرَجُهُ مِنَ الْخَيْشُومِ ، وَلَا يَقَعُ أَبَدًا إِلَّا فِي أَوَاخِرِ الْأَسْمَاءِ خَاصَّةً .
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ حَرْفٌ مِنَ الْحُرُوفِ لُزُومُ التَّغْيِيرِ الَّذِي يَلْحَقُ جَمِيعَ الْحُرُوفِ السَّوَاكِنِ لَهُ ، مِنَ التَّحْرِيكِ لِلسَّاكِنَيْنِ فِي نَحْوِ : " رَحِيمًا النَّبِيُّ " ، وَمِنْ إِلْقَاءِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ عَلَيْهِ فِي نَحْوِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=4كُفُوًا أَحَدٌ ، وَمِنَ الْحَذْفِ فِي نَحْوِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=30عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ ، وَ " أَحَدُ اللهُ " عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَمِنَ الْإِدْغَامِ فِي نَحْوِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173غَفُورٌ رَّحِيمٌ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=109يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ ، وَ " أَلِيمٌ مَّا يَوَدُّ " ، وَشِبْهِ ذَلِكَ . فَلَوْلَا أَنَّهُ كَسَائِرِ السَّوَاكِنِ لَمْ يَلْحَقْهُ مَا يَلْحَقُهُنَّ مِنَ التَّغْيِيرِ بِالْوُجُوهِ الْمُتَقَدِّمَةِ .
[ ص: 58 ] وَإِنَّمَا لَزِمَ الْأَطْرَافَ خَاصَّةً ، مِنْ حَيْثُ كَانَ مَخْصُوصًا بِمُتَابَعَةِ حَرَكَةِ الْإِعْرَابِ الَّتِي تَلْزَمُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ ، وَتَخْتَصُّ بِهِ ، وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ كَانَ الْإِعْرَابُ دَاخِلًا لِإِفَادَةِ الْمَعَانِي ، وَكَانَ زَائِدًا عَلَى الِاسْمِ .
فَإِنْ كَانَ الِاسْمُ الَّذِي يَقَعُ آخِرَهُ مَجْرُورًا جُعِلَ تَحْتَ الْحَرْفِ نُقْطَتَانِ ؛ إِحْدَاهُمَا الْحَرَكَةُ ، وَالثَّانِيَةُ عَلَامَتُهُ . وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَرْفُ مُخَفَّفًا أَوْ مُشَدَّدًا . وَإِنْ كَانَ مَرْفُوعًا جُعِلَ أَمَامَ الْحَرْفِ نُقْطَتَانِ أَيْضًا . وَإِنْ كَانَ مَنْصُوبًا فَكَذَلِكَ أَيْضًا . إِلَّا أَنَّ أَهْلَ النَّقْطِ مُخْتَلِفُونَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تُجْعَلُ فِيهِ النُّقْطَتَانِ . وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ مَشْرُوحًا ، وَنُبَيِّنُ وَجْهَ الصَّوَابِ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ ، فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَالْمَجْرُورُ نَحْوُ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=61مِن رَّبٍّ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=58رَبٍّ رَّحِيمٍ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=25مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ، وَشِبْهِهِ . وَالْمَرْفُوعُ نَحْوُ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=18صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ ، وَمَا أَشْبَهَهُ .
* * *
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مِنْ أَيْنَ جَعَلَ أَهْلُ النَّقْطِ عَلَامَةَ التَّنْوِينِ الَّذِي هُوَ نُونٌ خَفِيفَةٌ فِي اللَّفْظِ نُقْطَةً كَنُقْطَةِ الْحَرَكَةِ ؟ قِيلَ : مِنْ حَيْثُ جَعَلَهَا عَلَامَةً لِذَلِكَ مَنِ ابْتَدَأَ النَّقْطَ مِنَ السَّلَفِ ؛ اتِّبَاعًا لَهُ ، وَاقْتِدَاءً بِهِ . كَمَا حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَاتِبُ ، قَالَ : نَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : نَا أَبِي ، قَالَ : نَا
أَبُو عِكْرِمَةَ قَالَ : قَالَ
الْعُتْبِيُّ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11822أَبُو الْأَسْوَدِ لِلرَّجُلِ الَّذِي أَمْسَكَ عَلَيْهِ الْمُصْحَفَ ، حِينَ ابْتَدَأَ بِنَقْطِهِ : فَإِنْ أَتْبَعْتُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْحَرَكَاتِ غُنَّةً ؛ فَانْقُطْهُ نُقْطَتَيْنِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أَبُو عَمْرٍو : وَيَعْنِي بِالْغُنَّةِ التَّنْوِينَ ؛ لِأَنَّهُ غُنَّةٌ مِنَ الْخَيْشُومِ .
[ ص: 59 ] فَإِنْ قَالَ : فَمِنْ أَيْنَ اصْطَلَحُوا عَلَى جَعْلِ عَلَامَتِهِ عَلَامَةَ الْحَرَكَةِ ؟ قِيلَ : مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَخْصُوصًا بِمُتَابَعَةِ الْحَرَكَاتِ دُونَ السَّوَاكِنِ ؛ جَعَلُوا عَلَامَتَهُ فِي النَّقْطِ عَلَامَتَهُنَّ ؛ إِشْعَارًا بِذَلِكَ التَّخْصِيصِ ، وَإِعْلَامًا بِهِ . وَالثَّانِي أَنَّ الْحَرَكَةَ لَمَّا لَزِمَتْ أَوَائِلَ الْكَلِمِ ، وَلَزِمَ التَّنْوِينُ أَوَاخِرَهُنَّ ، وَاجْتَمَعَا مَعًا فِي الثَّبَاتِ فِي الْوَصْلِ ، وَالْحَذْفِ فِي الْوَقْفِ ؛ تَأَكَّدَ مَا بَيْنَ الْحَرَكَةِ وَالتَّنْوِينِ بِذَلِكَ ، فَجُعِلَتْ عَلَامَتُهُ عَلَامَتَهَا ، دَلَالَةً عَلَى ذَلِكَ التَّأْكِيدِ ، وَتَنْبِيهًا عَلَى تَنَاسُبِ مَا بَيْنَهُمَا فِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَثْبُتُ بِثَبَاتِ الآخَرِ ، وَيَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَهَلَّا جَعَلُوا عَلَامَتَهُ عَلَامَةَ السُّكُونِ ، مِنْ حَيْثُ كَانَ سَاكِنًا ؟ قِيلَ : لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ لَمَّا عُدِمَتْ صُورَتُهُ فِي الْخَطِّ ؛ لِزِيَادَتِهِ . وَالسُّكُونُ وَالْحَرَكَةُ لَا يُجْعَلَانِ إِلَّا فِي حَرْفٍ ثَابِتِ الْخَطِّ قَائِمِ الصُّورَةِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَلِمَ لَمْ يُرْسَمْ نُونًا فِي الْخَطِّ ، عَلَى اللَّفْظِ ؟ قِيلَ : لَمْ يُرْسَمْ نُونًا ، مِنْ حَيْثُ كَانَ زَائِدًا فِي الِاسْمِ الَّذِي يَلْحَقُ آخِرَهُ ؛ فَرْقًا بَيْنَ مَا يَنْصَرِفُ وَبَيْنَ مَا لَا يَنْصَرِفُ مِنَ الْأَسْمَاءِ ؛ لِئَلَّا يَشْتَبِهَ الزَّائِدُ لِمَعْنَى الَّذِي يَلْحَقُهُ التَّغْيِيرُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، بِالْأَصْلِيِّ اللَّازِمِ الَّذِي لَا يَتَغَيَّرُ ، كَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=77وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ، وَ " لَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ " ، وَ " لَا تَحْزَنْ عَلَيهِمْ " ، وَشِبْهِ ذَلِكَ . فَلَوْ رُسِمَ التَّنْوِينُ نُونًا ، وَهُوَ زَائِدٌ يَتَغَيَّرُ فِي حَالِ الْوَقْفِ ؛ لَاشْتَبَهَ بِالنُّونِ الْأَصْلِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا يَلْحَقُهَا تَغْيِيرٌ فِي وَصْلٍ وَلَا وَقْفٍ . فَفُرِقَ بَيْنَهُمَا بِالْحَذْفِ وَالْإِثْبَاتِ
[ ص: 60 ] لِيَتَمَيَّزَا بِذَلِكَ . وَلِأَجْلِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا خُولِفَ فِي التَّسْمِيَةِ بَيْنَهُمَا ، فَقِيلَ لِلْأَصْلِيِّ : " نُونٌ " ، وَلِلزَّائِدِ : " تَنْوِينٌ " ؛ لِيَنْفَصِلَا بِذَلِكَ ، وَتُعْلَمَ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَهُمَا بِهِ .
* * *
فَأَمَّا الْمَنْصُوبُ الْمُنَوَّنُ فَإِنَّهُ يُبْدَلُ مِنْهُ فِي حَالِ الْوَقْفِ أَلِفًا لِخِفَّتِهِ . وَكَذَلِكَ جَاءَ مَرْسُومًا فِي الْكِتَابَةِ ؛ دَلَالَةً عَلَى ذَلِكَ .
وَاخْتَلَفَ نُقَّاطُ الْمَصَاحِفِ فِي كَيْفِيَّةِ نَقْطِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ :
فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْقُطُ بِأَنْ يَجْعَلَ نُقْطَتَيْنِ بِالْحَمْرَاءِ عَلَى تِلْكَ الْأَلِفِ الْمَرْسُومَةِ ، وَيُعْرِيَ الْحَرْفَ الْمُتَحَرِّكَ مِنْهُمَا ، وَمِنْ إِحْدَاهُمَا . وَصُورَةُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23غَفُورًا رَّحِيمًا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=48شَيْئًا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31خَطَئًا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=67هُزُوًا ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=130كُلًّا ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=10غِلًّا . وَكَذَا إِنْ كَانَ الِاسْمُ الْمُنَوَّنُ مَقْصُورًا ، وَصُوِّرَتْ لَامُهُ يَاءً ؛ دَلَالَةً عَلَى أَصْلِهِ ، يَجْعَلُونَ النُّقْطَتَيْنِ أَيْضًا عَلَى تِلْكَ الْيَاءِ ؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ أَلِفًا فِي الْوَقْفِ . وَذَلِكَ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=2هُدًى ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=156غُزًّى ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196أَذًى ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مُسَمًّى ، وَشِبْهِهِ . وَهَذَا مَذْهَبُ
أَبِي مُحَمَّدٍ الْيَزِيدِيِّ ، وَعَلَيْهِ نُقَّاطُ أَهْلِ الْمِصْرَيْنِ
الْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ ، وَنُقَّاطُ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ .
وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ النُّقْطَتَيْنِ مَعًا عَلَى الْحَرْفِ الْمُتَحَرِّكِ ، وَيُعْرِي تِلْكَ الْأَلِفَ وَتِلْكَ الْيَاءَ مِنْهُمَا ، وَمِنْ إِحْدَاهُمَا . وَصُورَةُ ذَلِكَ فِي الْأَلِفِ كَمَا تَرَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11عَلِيمًا حَكِيمًا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31خَطَئًا ، " مُتَّكَئًا " ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=77كُفُوًا . وَفِي الْيَاءِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=125مُصَلًّى ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=156غُزًّى ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=15مُصَفًّى ، وَشِبْهِهِ . وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=14248الْخَلِيلِ وَأَصْحَابِهِ .
[ ص: 61 ] وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ إِحْدَى النُّقْطَتَيْنِ - وَهِيَ الْحَرَكَةُ - عَلَى الْحَرْفِ الْمُتَحَرِّكِ ، وَيَجْعَلُ الثَّانِيَةَ - وَهِيَ التَّنْوِينُ - عَلَى الْأَلِفِ ، وَعَلَى الْيَاءِ . وَصُورَةُ ذَلِكَ فِي الْأَلِفِ كَمَا تَرَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=18عَذَابًا أَلِيمًا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=57مَلْجَئًا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=260جَزَءًا . وَفِي الْيَاءِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=41مَوْلًى عَنْ مَوْلًى ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=156غُزًّى ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=58سُوًى ، وَشِبْهُهُ .
وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ نُقْطَةً وَاحِدَةً عَلَى الْحَرْفِ الْمُتَحَرِّكِ ، وَنُقْطَتَيْنِ عَلَى الْأَلِفِ . وَصُورَةُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=38وَعَادًا وَثَمُودًا ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=29مَثَلًا رَّجُلًا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=34رِدْءًا . وَفِي الْيَاءِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=2هُدًى ،
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=44عَمًى ،
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=156غُزًّى ،
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=36سُدًى ، وَشِبْهُهُ . وَذَهَبَ إِلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ قَوْمٌ مِنْ مُتَأَخِّرِي النُّقَّاطِ . وَلَا إِمَامَ لَهُمْ فِيهِمَا عَلِمْنَاهُ .
* * *
فَأَمَّا عِلَّةُ مَنْ جَعَلَ النُّقْطَتَيْنِ مَعًا عَلَى الْأَلِفِ ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ التَّنْوِينُ مُلَازِمًا لِلْحَرَكَةِ ، مُتَابِعًا لَهَا ، غَيْرَ مُنْفَكٍّ مِنْهَا ، وَلَا مُنْفَصِلٍ عَنْهَا فِي حَالِ الْوَصْلِ ، وَلَا مُنْفَرِدٍ دُونَهَا فِي اللَّفْظِ ، يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُهَا مِنَ الثَّبَاتِ فِي الْوَصْلِ ، وَيَلْحَقُهُ مَا يَلْحَقُهَا مِنَ الْحَذْفِ فِي الْوَقْفِ ، وَكَانَ النَّقْطُ - كَمَا قَدَّمْنَاهُ - مَوْضُوعًا عَلَى الْوَصْلِ دُونَ الْوَقْفِ ، بِدَلِيلِ تَعْرِيبِهِمْ أَوَاخِرَ الْكَلِمِ ، وَتَنْوِينِهِمُ الْمُنَوَّنَ مِنْهَا ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ مَنِ ابْتَدَأَ بِالنَّقْطِ مِنَ السَّلَفِ الَّذِينَ مُخَالَفَتُهُمْ خُرُوجٌ عَنِ الِاتِّبَاعِ ، وَدُخُولٌ فِي الِابْتِدَاعِ ، وَكَانَ الَّذِينَ عُنُوا بِكِتَابَةِ الْمَصَاحِفِ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَدْ رَسَمُوا بَعْدَ الْحَرْفِ الْمُتَحَرِّكِ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ أَلِفًا ، وَهِيَ الَّتِي تُعَوَّضُ مِنَ التَّنْوِينِ فِي حَالِ الْوَقْفِ ، أَوْ يَاءً تَعُودُ أَلِفًا فِيهِ ، وَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ إِثْبَاتِ عَلَامَتِهِ
[ ص: 62 ] فِي النَّقْطِ ، دَلَالَةً عَلَى صَرْفِ مَا يَنْصَرِفُ مِنَ الْأَسْمَاءِ ، جُعِلَ نُقْطَةً عَلَى الْحَرْفِ الْمُعَوَّضِ مِنْهُ ، وَهُوَ الْأَلِفُ ، وَعَلَى الْحَرْفِ الَّذِي يَنْقَلِبُ إِلَى لَفْظِهَا ، وَهُوَ الْيَاءُ ، وَضُمَّ إِلَيْهَا النُّقْطَةُ الْأُخْرَى الَّتِي هِيَ الْحَرَكَةُ ، فَحَصَلَتَا مَعًا عَلَى الْأَلِفِ ، فَفُهِمَ بِذَلِكَ وَكِيدُ حَالِهِمَا ، وَعُرِفَ بِهِ شِدَّةُ ارْتِبَاطِهِمَا ، وَعُلِمَ أَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ وَلَا يَنْفَصِلَانِ ، لَا لَفْظًا وَلَا نَقْطًا ، بِاجْتِمَاعِهِمَا عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ ، وَمُلَازَمَتِهِمَا مَكَانًا وَاحِدًا .
وَصَارَتِ الْأَلِفُ بِذَلِكَ أَوْلَى مِنَ الْحَرْفِ الْمُتَحَرِّكِ ، مِنْ قِبَلِ أَنَّهُمَا لَوْ جُعِلَتَا عَلَيْهِ لَبَقِيَتِ الْأَلِفُ عَارِيَةً مِنْ عَلَامَةِ مَا هِيَ عِوَضٌ مِنْهُ ، مَعَ الْحَاجَةِ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ ، فَتَصِيرُ حِينَئِذٍ غَيْرَ دَالَّةٍ عَلَى مَعْنًى ، وَلَا مُفِيدَةٍ شَيْئًا ، فَيَبْطُلُ مَا لِأَجْلِهِ رُسِمَتْ ، وَلَهُ اخْتِيرَتْ ، مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْحُرُوفِ . وَتَكُونُ لَا مَعْنَى لَهَا فِي رَسْمٍ وَلَا لَفْظٍ ، إِلَّا الزِّيَادَةَ لَا غَيْرُ ، دُونَ إِيثَارِ فَائِدَةٍ ، وَلَا دَلَالَةٍ عَلَى مَعْنًى يُحْتَاجُ وَيُضْطَرُّ إِلَيْهِ . فَلَمَّا كَانَتِ الْأَلِفُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَكَانَ رَسْمُهَا إِنَّمَا هُوَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْوَقْفِ ، وَالْإِعْلَامِ بِأَنَّهَا مُبْدَلَةٌ فِيهِ مِنَ التَّنْوِينِ ؛ وَجَبَ أَنْ تُجْعَلَ النُّقْطَةُ - الَّتِي هِيَ عَلَامَتُهُ - عَلَيْهَا ضَرُورَةً ، إِذْ هِيَ هُوَ . وَإِذَا وَجَبَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ ضَمِّ النُّقْطَةِ الثَّانِيَةِ إِلَيْهَا ، فَتَحْصُلَانِ مَعًا عَلَى الْأَلِفِ ، إِذْ لَا تَفْتَرِقَانِ وَلَا تَنْفَصِلَانِ كَمَا بَيَّنَّاهُ .
وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي نَقْطِ ذَلِكَ أَخْتَارُ ، وَبِهِ أَقُولُ ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنَ النُّقَّاطِ .
* * *
وَأَمَّا عِلَّةُ مَنْ جَعَلَ النُّقْطَتَيْنِ مَعًا - الْحَرَكَةَ وَالتَّنْوِينَ - عَلَى الْحَرْفِ الْمُتَحَرِّكِ ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا هِيَ الْحَرَكَةَ جَعَلَهَا عَلَى الْحَرْفِ الْمُتَحَرِّكِ ؛ دَلَالَةً عَلَى تَحْرِيكِهِ بِهَا ، ثُمَّ ضَمَّ إِلَيْهَا الثَّانِيَةَ الَّتِي هِيَ التَّنْوِينُ ، لِامْتِنَاعِهِمَا مِنَ الِانْفِصَالِ وَالِافْتِرَاقِ .
وَأَمَّا عِلَّةُ مَنْ جَعَلَ إِحْدَى النُّقْطَتَيْنِ عَلَى الْحَرْفِ الْمُتَحَرِّكِ ، وَالثَّانِيَةَ عَلَى الْأَلِفِ ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا هِيَ الْحَرَكَةَ جَعَلَهَا عَلَى الْحَرْفِ الْمُحَرَّكِ بِهَا ، وَلَمَّا كَانَتِ
[ ص: 63 ] الثَّانِيَةُ هِيَ التَّنْوِينُ جَعَلَهَا عَلَى الْحَرْفِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ ، وَهُوَ الْأَلِفُ ، تَأْدِيَةً لِهَذَا الْمَعْنَى ، وَإِعْلَامًا بِهِ .
وَأَمَّا عِلَّةُ مَنْ جَعَلَ ثَلَاثَ نُقَطٍ ، نُقْطَةً عَلَى الْحَرْفِ الْمُتَحَرِّكِ ، وَنُقْطَتَيْنِ عَلَى الْأَلِفِ ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَتْ إِحْدَى النُّقْطَتَيْنِ حَرَكَةَ الْحَرْفِ الْمُتَحَرِّكِ جَعَلَهَا عَلَيْهِ ، كَمَا تُجْعَلُ سَائِرُ الْحَرَكَاتِ عَلَى الْحُرُوفِ الْمُتَحَرِّكَةِ بِهِنَّ . ثُمَّ أَعَادَهَا مَعَ التَّنْوِينِ ؛ لِارْتِبَاطِهِ بِهَا وَمُلَازَمَتِهِ إِيَّاهَا ، وَامْتِنَاعِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الِانْفِصَالِ عَنْ صَاحِبِهِ ، أَعْنِي التَّنْوِينَ عَنِ الْحَرَكَةِ ، وَالْحَرَكَةَ عَنِ التَّنْوِينِ ؛ تَأْكِيدًا وَدَلَالَةً عَلَى هَذَا الْمَعْنَى . فَتَحَقَّقَ لَهُ بِذَلِكَ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا إِيفَاءُ الْمُتَحَرِّكِ حَقَّهُ مِنْ حَرَكَتِهِ . وَالثَّانِي تَأْدِيَةُ تَأْكِيدِ مَا بَيْنَ الْحَرَكَةِ وَالتَّنْوِينِ مِنَ الْمُصَاحَبَةِ وَالْمُلَازَمَةِ .
وَهَذِهِ الْمَذَاهِبُ الثَّلَاثَةُ فَاسِدَةٌ ، لَا تَصِحُّ عِنْدَ التَّحْقِيقِ . أَمَّا الْأَوَّلُ مِنْهَا الَّذِي يَنْفَرِدُ الْحَرْفَ الْمُتَحَرِّكَ فِيهِ بِالنُّقْطَتَيْنِ ، فَإِنَّ الْأَلِفَ الْمَرْسُومَةَ بَعْدَهُ بِتَعْرِيَتِهَا مِنْ ذَلِكَ تَخْلُو مِنَ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِ تَأْدِيَتِهِ رُسِمَتْ ، فَيَبْطُلُ مَعْنَى الرَّسْمِ بِذَلِكَ . وَأَمَّا الثَّانِي الَّذِي تُجْعَلُ فِيهِ إِحْدَى النُّقْطَتَيْنِ عَلَى الْحَرْفِ الْمُتَحَرِّكِ ، وَالثَّانِيَةُ عَلَى الْأَلِفِ ؛ فَإِنَّ مَا بَيْنَ التَّنْوِينِ وَالْحَرَكَةِ مِنَ الِارْتِبَاطِ وَالْمُلَازَمَةِ وَالِاتِّصَالِ وَالِاشْتِرَاكِ فِي الْإِثْبَاتِ وَالْحَذْفِ يَذْهَبُ وَيَبْطُلُ بِذَلِكَ . وَأَمَّا الثَّالِثُ الَّذِي تُجْعَلُ فِيهِ ثَلَاثُ نُقَطٍ ؛ نُقْطَةٌ عَلَى الْحَرْفِ الْمُتَحَرِّكِ ، وَنُقْطَتَانِ عَلَى الْأَلِفِ ، فَإِنَّ الْحَرْفَ الْمُتَحَرِّكَ تَجْتَمِعُ لَهُ حَرَكَتَانِ : حَرَكَةٌ عَلَيْهِ ، وَحَرَكَةٌ عَلَى الْأَلِفِ . وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُحَرَّكُ حَرْفٌ بِحَرَكَتَيْنِ ، وَأَنْ تُجْمَعَا لَهُ ، وَيُدَلَّ بِهِمَا عَلَيْهِ . هَذَا مَعَ الْخُرُوجِ بِذَلِكَ عَنْ فِعْلِ السَّلَفِ ، وَالْعُدُولِ بِهِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْخَلَفِ .
وَإِذَا فَسَدَتْ هَذِهِ الْمَذَاهِبُ الثَّلَاثَةُ بِالْوُجُوهِ الَّتِي بَيَّنَّاهَا ؛ صَحَّ الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ
[ ص: 64 ] الَّذِي اخْتَرْنَاهُ ، وَذَهَبْنَا إِلَيْهِ ، وَاخْتَارَهُ وَذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ التَّحْقِيقِ وَالضَّبْطِ ، وَاسْتَعْمَلَهُ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ النَّقْطِ .
قَالَ
أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْمُنَادِي : أَخْبَرَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْيَزِيدِيُّ ، عَنْ عَمِّهِ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14248الْخَلِيلِ قَالَ : قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11عَلِيمًا حَكِيمًا بِنُقْطَتَيْنِ فَوْقَ الْمِيمِ طُولًا ، وَاحِدَةٌ فَوْقَ الْأُخْرَى . قَالَ : وَلَا أَنْقُطُ عَلَى الْأَلِفِ ؛ لِأَنَّ التَّنْوِينَ يَقَعُ عَلَى الْمِيمِ نَفْسِهَا . قَالَ
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ - يَعْنِي أَبَاهُ الْيَزِيدِيَّ - : وَلَكِنَّنِي أَنْقُطُ عَلَى الْأَلِفِ ؛ لِأَنِّي إِذَا وَقَفْتُ قُلْتُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11عَلِيمًا ، فَصَارَ أَلِفًا عَلَى الْكِتَابِ . قَالَ : وَلَوْ كَانَ عَلَى مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14248الْخَلِيلُ ؛ لَكَانَ يَنْبَغِي إِذَا وَقَفَ أَنْ يَقُولَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=29عَلِيمٌ ، يَعْنِي بِغَيْرِ أَلِفٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12915ابْنُ الْمُنَادِي : وَالْعَمَلُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ أَكْثَرِ النُّقَّاطِ نَقْطُ الْأَلِفِ الْمَنْصُوبَةِ بِنُقْطَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا لِلنَّصْبِ ، وَالْأُخْرَى لِلتَّنْوِينِ . فَإِذَا صَارُوا إِلَى الْوَقْفِ صَارُوا إِلَى الْأَلِفِ .
قَالَ : وَذَكَرَ
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَهْلَ
الْكُوفَةِ وَبَعْضَ النُّقَّاطِ يَنْقُطُونَ الْمَنْصُوبَ إِذَا اسْتَقْبَلَتْهُ الْحُرُوفُ الْحَلْقِيَّةُ فَإِذَا اسْتَقْبَلَتْهُ غَيْرُهَا لَمْ يَنْقُطُوا لِدَلَالَةِ الْأَلِفِ عَلَى النَّصْبِ . قَالَ : وَكَانَ
الْيَزِيدِيُّ يَذْهَبُ إِلَى أَصْلِ هَذَا الْقَوْلِ ، وَخَالَفَهُ مَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ سَائِرِ النُّقَّاطِ ، فَنَقَطُوا الْمُنَوَّنَ فِي حَالَاتِهِ الثَّلَاثِ الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالْجَرِّ ، اسْتَقْبَلَتْهُ حُرُوفُ الْحَلْقِ أَوْ لَمْ تَسْتَقْبِلْهُ ، وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ حَتَّى الْآنَ عِنْدَ النُّقَّاطِ . وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْمَصَاحِفِ الْعُتْقِ ، وَهُوَ أَوْثَقُ وَأَحْسَنُ .
[ ص: 65 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أَبُو عَمْرٍو : وَلَمْ نَرَ شَيْئًا مِنَ الْمَصَاحِفِ يَخْتَلِفُ فِي نَقْطِهِ عَنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ الْوَجْهُ ، وَبِهِ الْعَمَلُ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
فَصْلٌ
وَاعْلَمْ أَنَّ الِاخْتِلَافَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بَيْنَ أَهْلِ النَّقْطِ ، فِي جَعْلِ النُّقْطَتَيْنِ ، إِنَّمَا هُوَ فِي الْكَلِمِ اللَّائِي رُسِمَتِ الْأَلِفُ الْمُبْدَلَةُ مِنَ التَّنْوِينِ فِيهِنَّ ، عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ . فَأَمَّا مَا لَمْ تُرْسَمْ فِيهِ تِلْكَ الْأَلِفُ لِعِلَّةٍ ، وَذَلِكَ إِذَا وَلِيَهَا هَمْزَةٌ قَبْلَهَا أَلِفٌ كَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=22مَاءً ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=41غُثَاءً ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=17جُفَاءً ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=171دُعَاءً وَنِدَاءً ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=138افْتِرَاءً ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=22مِرَاءً ، وَشِبْهُهُ ، وَذَلِكَ حِينَ كُرِهَ اجْتِمَاعُ أَلِفَيْنِ لِاتِّفَاقِ صُورَتَيْهِمَا ، كَكُرْهِ اجْتِمَاعِ يَاءَيْنِ وَوَاوَيْنِ لِذَلِكَ ، فَإِنَّ الِاخْتِيَارَ عِنْدِي فِي نَقْطِ ذَلِكَ أَنْ تُجْعَلَ النُّقْطَتَانِ مَعًا عَلَى الْهَمْزَةِ ، لِعَدَمِ صُورَةِ الْمُبْدَلِ مِنَ التَّنْوِينِ فِي هَذَا الضَّرْبِ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا عُدِلَ بِهِمَا عَنِ الْمُتَحَرِّكِ فِي الضَّرْبِ الْأَوَّلِ لَمَّا وُجِدَتْ تِلْكَ الصُّورَةُ قَائِمَةً ، فَإِذَا عُدِمَتْ وَجَبَ أَنْ تَلْزَمَا الْحَرْفَ الْمُتَحَرِّكَ لَا غَيْرُ .
وَقَدْ يَجُوزُ عِنْدِي فِي نَقْطِ هَذَا الضَّرْبِ وَجْهَانِ ، سِوَى هَذَا الْوَجْهِ :
أَحَدُهُمَا أَنْ تُرْسَمَ بِالْحُمْرَةِ أَلِفٌ قَبْلَ الْأَلِفِ السَّوْدَاءِ ، وَتُوقَعَ الْهَمْزَةُ نُقْطَةً بِالصَّفْرَاءِ بَيْنَهُمَا ، وَتُجْعَلَ حَرَكَتُهَا مَعَ التَّنْوِينِ نُقْطَتَيْنِ عَلَى الْأَلِفِ السَّوْدَاءِ ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُبْدَلَةُ مِنَ التَّنْوِينِ فِي ذَلِكَ ، وَهِيَ الْمَرْسُومَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ .
وَالثَّانِي أَنْ تُرْسَمَ أَلِفٌ بِالْحُمْرَةِ بَعْدَ الْأَلِفِ السَّوْدَاءِ ، وَتُوقَعَ الْهَمْزَةُ نُقْطَةً
[ ص: 66 ] بِالصَّفْرَاءِ بَيْنَهُمَا أَيْضًا ، وَتُجْعَلَ حَرَكَتُهَا مَعَ التَّنْوِينِ نُقْطَتَيْنِ عَلَى الْأَلِفِ الْحَمْرَاءِ ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُعَوَّضَةُ مِنَ التَّنْوِينِ ، وَهِيَ الْمَحْذُوفَةُ مِنَ الرَّسْمِ لِكَرَاهَةِ اجْتِمَاعِ الْأَلِفَيْنِ ، لِوُقُوعِهَا فِي مَوْضِعِ الْحَذْفِ وَالتَّغْيِيرِ ، وَهُوَ الطَّرَفُ ، فَكَانَتْ بِالْحَذْفِ أَوْلَى مِنَ الَّتِي هِيَ فِي وَسَطِ الْكَلِمَةِ ، وَلِأَنَّ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ لَا يُعَوِّضُ مِنْهُ فِي حَالِ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ ، حَكَى ذَلِكَ عَنْهَا
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءُ nindex.php?page=showalam&ids=13676وَالْأَخْفَشُ .
وَصُورَةُ نَقْطِ هَذَا الضَّرْبِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الَّذِي اخْتَرْنَاهُ وَقُلْنَا بِهِ ، كَمَا تَرَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=22مَاءً ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=41غُثَاءً ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=13&ayano=17جُفَاءً ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=171دُعَاءً وَنِدَاءً . وَعَلَى الثَّانِي : " مَئًا " ، وَ " غُثَئًا " ، وَ " جُفَئًا " ، وَ " دُعَئًا " ، وَ " نِدَءًا " . وَعَلَى الثَّالِثِ : " مَاءًا " ، وَ " غُثَاءًا " ، وَ " جُفَاءًا " ، وَ " دُعَاءًا وَنِدَاءًا " .
فَصْلٌ
وَإِذَا كَانَ آخِرُ الِاسْمِ الَّذِي يَلْحَقُهُ التَّنْوِينُ فِي حَالِ نَصْبِهِ هَاءَ تَأْنِيثٍ ، نَحْوُ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=28وَآتَانِي رَحْمَةً ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=12بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً ، وَ " دَانِيَةً عَلَيهِمْ " ، وَشِبْهِهِ ؛ فَإِنَّ النُّقْطَتَيْنِ مَعًا تَقَعَانِ فِي ذَلِكَ عَلَى الْهَاءِ الَّتِي هِيَ تَاءٌ فِي الْوَصْلِ لَا غَيْرُ ، لِامْتِنَاعِ إِبْدَالِ التَّنْوِينِ فِيهِ فِي حَالِ الْوَقْفِ بِامْتِنَاعِ وُجُودِ التَّاءِ الَّتِي يَلْحَقُهَا مَعَ حَرَكَةِ الْإِعْرَابِ هُنَاكَ ، وَلِذَلِكَ بَطَلَ تَصْوِيرُ مَا يُبْدَلُ مِنْهُ فِي حَالِ الْوَقْفِ فِي هَذَا النَّوْعِ .
فَصْلٌ
فَأَمَّا النُّونُ الْخَفِيفَةُ ؛ فَإِنَّهَا بِمَثَابَةِ التَّنْوِينِ فِي الزِّيَادَةِ وَالْبَدَلِ وَالرَّسْمِ ، وَلَمْ تَأْتِ
[ ص: 67 ] فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ : أَحَدُهُمَا فِي (يُوسُفَ ) قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=32وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ ، وَالثَّانِي فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=14اقْرَأْ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=15لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ، وَالْقُرَّاءُ مُجْمِعُونَ عَلَى إِبْدَالِ النُّونِ فِيهِمَا فِي الْوَقْفِ أَلِفًا ، كَالتَّنْوِينِ الَّذِي يَلْحَقُ الْأَسْمَاءَ الْمَنْصُوبَةَ ؛ لِأَنَّ قَبْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يُشْبِهُ الْأَلِفَ ، وَهِيَ الْفَتْحَةُ . وَلِتَأْدِيَةِ كَيْفِيَّةِ الْوَقْفِ رُسِمَا كَذَلِكَ . وَالنُّقَّاطُ مُتَّفِقُونَ أَيْضًا عَلَى جَعْلِ نُقْطَتَيْنِ بِالْحُمْرَةِ عَلَى تِلْكَ الْأَلِفِ ؛ لِاشْتِرَاكِ مَا أُبْدِلَتْ مِنْهُ مَعَ التَّنْوِينِ فِي الْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالْبَدَلِ وَالرَّسْمِ وَمُصَاحَبَةِ الْفَتْحَةِ .
وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى جَعْلِهِمَا عَلَى الْأَلِفِ فِي نَحْوِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=76وَإِذًا لا يَلْبَثُونَ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=53فَإِذًا لا يُؤْتُونَ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=140إِذًا مِثْلُهُمْ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=75إِذًا لأَذَقْنَاكَ ، وَمَا أَشْبَهَهُ . وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ أَشْبَهَ ذَلِكَ النُّونَ الْخَفِيفَةَ فِي اللَّفْظِ وَالرَّسْمِ وَالْوَقْفِ ، وَوَافَقَهَا فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، فَجَرَى بِذَلِكَ مَجْرَاهَا فِي اللَّفْظِ ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَالْإِعَانَةُ .


 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية موسوعة التربية
موسوعة التربية كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام




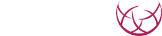








 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات