[ ص: 93 ] باب
ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=29577_28885أحكام الهمزتين اللتين في كلمة
اعلم أن الهمزتين تلتقيان في كلمة واحدة على ثلاثة أضرب : فالضرب الأول أن تتحركا معا بالفتح . وذلك نحو قوله : " ءأنذرتهم " ، و " ءأنتم أعلم " ، و " ءأسجد " ، و " ءألد " ، و " ءأتخذ " ، وشبهه . والضرب الثاني أن تتحرك الأولى بالفتح والثانية بالكسر ، وذلك نحو قوله : " أءذا " ، و " أءله " ، و " أءنك لأنت " ، و " أءنا لمردودون " ، وشبهه . والضرب الثالث أن تتحرك الأولى بالفتح والثانية بالضم ، وذلك نحو قوله : " أءنزل عليه " ، و " أءلقي الذكر " ، و " أءشهدوا خلقهم " ، على قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع .
* * *
فأما الهمزة الأولى في هذه الأضرب الثلاثة ؛ فلا خلاف بين أئمة القراءة في
[ ص: 94 ] تحقيقها ؛ لكونها مبتدأة ، والمبتدأة لا تلين ، من حيث كان التليين يقربها من الساكن ، والابتداء بالساكن ممتنع . فلذلك انعقد الإجماع على تحقيقها . فإن وصلت بساكن جامد قبلها فنافع من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورش يلقي حركتها على ذلك الساكن ، ويسقطها من اللفظ تخفيفا ، كقوله : " رحيم ءأشفقتم " ، و " قل ءأنتم " ، و " عجيب اءذا " ، و " إلا اختلاق ءأنزل " ، وشبهه .
وأما الهمزة الثانية فاختلفوا في تحقيقها على الأصل ، وفي تليينها ، وفي إدخال ألف فاصلة في حال التحقيق والتليين بين الهمزتين . وذلك بعد إجماع كتاب المصاحف على حذف صورة إحدى الهمزتين من الرسم ؛ كراهة للجمع بين صورتين متفقتين ، واكتفاء بالواحد منهما .
واختلف علماء العربية في أيهما المحذوفة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : المحذوفة من الهمزتين همزة الاستفهام ، من حيث كانت حرفا زائدا داخلا على الكلمة ، والثابتة همزة الأصل أو القطع ، من حيث كانت لازمة للكلمة . وعلى هذا القول عامة أصحاب المصاحف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء ،
وأحمد بن يحيى ، وأبو الحسن بن كيسان : المحذوفة منهما همزة الأصل أو القطع ، والمرسومة همزة الاستفهام . وذلك من جهتين : إحداهما أن همزة الاستفهام مبتدأة ، والمبتدأة لا تحذف صورتها في نحو :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=27أمر ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=71إمرا ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=4أنزل ، وشبهه بإجماع . وذلك من حيث لم يجز تخفيفها
[ ص: 95 ] في تلك الحال ، لا بحذف ولا بتسهيل ؛ لعدم ما ينوب عنها هناك . والثانية أنها داخلة لمعنى ، وهو الاستخبار ، فوجب رسمها وإثبات صورتها ، ليتأدى بذلك المعنى الذي دخلت له واجتلبت لأجله .
وكذا اختلافهم في همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل التي معها لام التعريف ، نحو قوله : " قل ءالذكرين " ، و " ءالله أذن لكم " ، و " ءالئن وقد عصيت " ، وشبهه .
والوجهان في ذلك صحيحان .
* * *
فأما نقط الضرب الأول ، على قراءة من سهل الهمزة الثانية ، ولم يفصل بينهما وبين الهمزة الأولى بألف ؛ فهو أن تجعل نقطة بالصفراء ، وحركتها عليها نقطة بالحمراء ، قبل الألف المصورة . وتجعل على الألف المصورة نقطة بالحمراء فقط . فيدل بذلك على تحقيق الهمزة الأولى ، وتسهيل الهمزة الثانية . هذا على قول من قال : إن الهمزة الأولى هي المحذوف صورتها . وصورة ذلك كما ترى : " ءانذرتهم " ، " ءانتم " ، " ءالد " ، " ءاشفقتم " ، وشبهه .
وعلى قول من قال : إن الهمزة الثانية هي المحذوفة صورتها تجعل النقطة الصفراء ، وحركتها نقطة بالحمراء ، في الألف المصورة . وترسم بعدها ألف بالحمراء ، وتجعل على رأسها نقطة بالحمراء ؛ علامة للتسهيل . وإن شاء الناقط لم يرسم ذلك ، وجعل
[ ص: 96 ] النقطة بالحمراء في موضعها . وصورة ذلك كما ترى : " أانذرتهم " ، " أانتم " ، " أالد " ، " أاشفقتم " ، وشبهه .
وأما نقط ذلك على قراءة من سهل وفصل بالألف ، على المذهبين جميعا ، فكما تقدم سواء . وتجعل الألف الفاصلة بالحمراء بين الهمزة المحققة التي علامتها نقطة بالصفراء ، وبين الهمزة المسهلة التي علامتها نقطة بالحمراء . وإن شاء الناقط لم يجعل ألفا ، وجعل في موضعها مطة ، إذ في ذلك إعلام بالفصل . وصورة ذلك على القول الأول كما ترى : " ءانذرتهم " ، " ءانتم " ، " ءالد " ، " ءاشفقتم " ، وعلى الثاني : " أانذرتهم " ، " أانتم " ، " أالد " ، " أاشفقتم " .
وأما نقط هذا الضرب على قراءة من حقق الهمزتين معا فهو أن تجعل الهمزة الأولى نقطة بالصفراء ، وحركتها عليها نقطة بالحمراء ، قبل الألف المصورة . وتجعل الهمزة الثانية نقطة بالصفراء ، وحركتها عليها ، في الألف المصورة . هذا على قول من قال : إن الهمزة الأولى هي المحذوف صورتها . وصورة ذلك كما ترى : " ءأنذرتهم " ، " ءأنتم " ، " ءألد " ، " ءأشفقتم " ، وشبهه .
وعلى قول من قال : إن الهمزة الثانية هي المحذوف صورتها تجعل الهمزة الأولى وحركتها في الألف المصورة . وتجعل الهمزة الثانية وحركتها بعد تلك الألف . وإن شاء الناقط جعل لها صورة بالحمراء . وإن شاء لم يجعل لها صورة ، واكتفى بالهمزة والحركة منها . وصورة ذلك كما ترى : " أءنذرتهم " ، " أءنتم " ، " أءلد " ، " أءشفقتم " ، وشبهه .
[ ص: 97 ] وتجعل بين الهمزتين ، في مذهب من فصل بينهما بألف ، ألف أو مطة بالحمراء على القولين جميعا . وصورة ذلك على الأول : " ءأنذرتهم " ، و " ءأنتم " ، " ءألد " ، " ءأشفقتم " . وعلى الثاني : " أءنذرتهم " ، " أءنتم " ، " أءلد " ، " أءشفقتم " .
فصل
فأما ما تدخل فيه همزة الاستفهام على همزة الوصل التي معها لام التعريف ؛ فليس أحد من القراء يحقق همزة الوصل ، ولا يفصل بينها وبين همزة الاستفهام بألف في ذلك . وهو إجماع من العرب أيضا . وذلك من حيث لم تقو همزة الوصل قوة غيرها من الهمزات . وإنما شبهت هاهنا بهن لما احتيج إلى إثباتها فيه ؛ ليتميز بإثباتها الاستفهام من الخبر لا غير . فلذلك لم تتحقق نبرتها ، ولم يفصل بألف بينها وبين همزة الاستفهام .
فإذا نقط ذلك على مذهب الجميع جعلت نقطة بالصفراء ، وحركتها عليها نقطة بالحمراء ، قبل الألف السوداء . وجعل في رأس الألف السوداء نقطة بالحمراء فقط . هذا على قول من قال : إن همزة الاستفهام هي المحذوف صورتها . وصورة ذلك كما ترى : " ءالذكرين " ، " ءالله " ، " ءالئن " ، وشبهه .
وعلى قول من قال : إن همزة الوصل هي المحذوف صورتها تجعل النقطة الصفراء وحركتها في الألف السوداء . وتجعل النقطة الحمراء التي هي علامة التسهيل بعد الألف السوداء . وإن شاء الناقط جعل لها صورة بالحمراء كما تقدم . وصورة ذلك كما ترى : " أالذكرين " ، " أالله " ، " أالئن " ، وشبهه .
[ ص: 98 ] وأكثر النحويين والقراء يزعمون أن همزة الوصل في هذا النوع تبدل إبدالا محضا ، ولا تجعل بين بين . فتصير في مذهبهم مدة مشبعة . فإذا نقط ذلك على هذا المذهب جعل مكان النقطة الحمراء التي هي علامة التسهيل مطة بالحمراء ؛ ليدل بذلك على البدل المحض . وصورة ذلك على القولين كما ترى : " ءالذكرين " ، " ءالله " ، " ءالئن " ؛ " أالذكرين " ، " أالله " ، " أالئن " .
فصل
وأما ما تدخل فيه همزة الاستفهام على همزتين ، الأولى همزة القطع ، والثانية همزة الأصل ، وهو متصل بالضرب الأول ، وجملة ما جاء في كتاب الله تعالى من ذلك أربعة مواضع في ( الأعراف ) ، و ( طه ) ، و ( الشعراء ) : " ءأمنتم " ، وفي ( الزخرف ) : " ءألهتنا " ، فإن القراء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أوجه . منهم من يقرأ هذه المواضع بالاستفهام ، وتحقيق الهمزتين - همزة الاستفهام ، وهمزة القطع بعدها - . ومنهم من يقرؤها بالاستفهام وتحقيق همزته ، وتسهيل همزة القطع بعدها . ومنهم من يقرؤها على لفظ الخبر . وكلهم أبدل همزة الأصل في ذلك ألفا ، من حيث كانت ساكنة . ولم يفصل بين همزة الاستفهام وبين همزة القطع بألف من حقق الهمزتين منهم ، ومن سهل إحداهما ، كراهة لتوالي أربع ألفات في ذلك .
[ ص: 99 ] واتفق كتاب المصاحف على رسم هذه المواضع بألف واحدة ؛ لما ذكرنا من كراهتهم لاجتماع صور متفقة ، واكتفائهم بواحدة منهن . وتحتمل تلك الألف المرسومة ثلاثة أوجه : أن تكون همزة الاستفهام ، من حيث كانت داخلة لمعنى لا بد من تأديته . وأن تكون همزة القطع ، من حيث كانت كاللازمة . وأن تكون همزة الأصل ، من حيث كانت من نفس الكلمة .
فإذا نقط ذلك على قراءة من حقق همزة الاستفهام ، وسهل همزة القطع بعدها ، وجعلت الألف المصورة همزة الاستفهام ، جعل على تلك الألف نقطة بالصفراء ، وحركتها عليها نقطة بالحمراء ، وجعل بعد الألف نقطة بالحمراء فقط ، ورسم بعدها ألف بالحمراء ؛ ليدل بذلك على أن بعد الهمزة المسهلة ألفا ساكنة ، هي بدل من همزة فاء الفعل الساكنة . ولا بد من رسم هذه الألف في هذا الوجه ، لما ذكرنا . وصورة ذلك كما ترى : " أامنتم " ، " أالهتنا " .
فإن جعلت الألف المصورة همزة القطع الزائدة على فاء الفعل جعلت النقطة بالصفراء ، وحركتها عليها ، قبل الألف السوداء ، وجعل على الألف نقطة بالحمراء ، ورسم بعدها ألف بالحمراء ، ليدل على فاء الفعل بذلك . وصورة ذلك كما ترى " ءامنتم " ، " ءالهتنا " .
[ ص: 100 ] وإن جعلت الألف المصورة همزة الأصل المبدلة ألفا جعلت النقطة بالصفراء ، وحركتها عليها ، قبل تلك الألف المصورة في السطر ، ورسم بعدها ألف بالحمراء ، وجعل عليها نقطة بالحمراء فقط . فتحصل هذه الألف بين الهمزة التي علامتها نقطة بالصفراء ، وبين الألف السوداء . وإن شاء الناقط لم يرسم تلك الألف ، وجعل النقطة بالحمراء في موضعها لا غير . وصورة ذلك كما ترى : " أءمنتم " ، " أءلهتنا " .
والوجه الثاني الذي تجعل فيه الألف المرسومة همزة القطع أوجه عندي ، من قبل أن الحرف لا يتوالى فيه كما يتوالى في الوجهين الآخرين . وعلى ذلك أصحاب المصاحف . وهو اختياري ، وإليه أذهب ، وبه أنقط .
وإذا نقط ذلك على قراءة من حقق الهمزتين - همزة الاستفهام ، وهمزة القطع - ؛ فعل فيه كما فعل في مذهب من سهل الهمزة الثانية ، إلا أنه تجعل مكان النقطة الحمراء الدالة على التسهيل نقطة بالصفراء ، وحركتها عليها نقطة بالحمراء . وصورة ذلك على الوجه الأول كما ترى : " أءمنتم " ، " أءلهتنا " . وعلى الثاني : " ءأمنتم " ، " ءألهتنا " . وعلى الثالث : " ءأمنتم " ، " ءألهتنا " .
وإن نقطت هذه المواضع على قراءة من قرأها على لفظ الخبر ؛ جعل قبل الألف المصورة نقطة بالصفراء ، وحركتها عليها نقطة بالحمراء لا غير ؛ لأن تلك الألف
[ ص: 101 ] المصورة على هذه القراءة ألف الأصل ، من حيث كانت مبدلة من همزة فاء الفعل لا غير ، كما هي في نظائر ذلك ، نحو قوله : " ءامن الرسول " ، و " ءالهتك " ، و " ءامنهم " ، و " ءاتى المال " ، وشبهه . وصورة نقط ذلك كما ترى : " ءامنتم " ، و " ءالهتنا " .
وقد روى
القواس أحمد بن محمد بن عون ، عن أصحابه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير أنه يسهل همزة الاستفهام وهمزة القطع في قوله في ( الأعراف ) : " قال فرعون ءأمنتم به " ، فيبدل همزة الاستفهام واوا مفتوحة لانضمام ما قبلها ، ويجعل همزة القطع بين الهمزة والألف ؛ طلبا للتخفيف وتسهيل اللفظ بذلك .
فإذا نقط ذلك على هذه القراءة ؛ جعل على الألف المصورة نقطة بالحمراء ، ورسم قبلها واو بالحمراء ، وجعل عليها نقطة ؛ لأنها مبدلة بدلا خالصا . ورسم أيضا بعد تلك الألف ألف بالحمراء ؛ ليؤذن بأنها بعدها في الأصل واللفظ . وصورة ذلك كما ترى : " فرعون وامنتم " .
وقد يجوز في نقط ذلك ما جاز في نقطه على قراءة من حقق همزة الاستفهام وسهل همزة القطع ، إلا أنه تجعل مكان النقطة الصفراء التي هي علامة همزة الاستفهام المحققة نقطة بالحمراء فقط .
فصل
وأما نقط الضرب الثاني من الثلاثة الأضرب ، على قراءة من سهل
[ ص: 102 ] الهمزة الثانية ، ولم يفصل بينها وبين الهمزة الأولى المحققة بألف ؛ فهو أن تجعل نقطة بالصفراء ، وحركتها عليها ، على الألف المصورة ، وتجعل بعدها في السطر نقطة بالحمراء لا غير . فيدل بذلك على تحقيق همزة الاستفهام ، وتسهيل همزة الأصل .
وإن شاء الناقط جعل في موضع النقطة الحمراء التي هي علامة التسهيل ياء بالحمراء ، وألحقها بالحرف ، من حيث قربت الهمزة المسهلة في هذا الضرب منها . إلا أنها إذا ألحقت أعريت من الحركة ؛ لأنها ليست بياء مكسورة خالصة ، وإنما هي بين الهمزة المحققة والياء الساكنة .
وإنما أطلقنا للناقط إلحاق ياء بعد همزة الاستفهام من حيث رسمها كتاب المصاحف بالسواد في مواضع كثيرة من هذا الضرب ؛ دلالة على التسهيل ؛ ليأتي الضرب كله على صورة واحدة . والذي أختاره ألا تلحق الياء في ذلك ، وأن تجعل النقطة في موضعها .
وهذا الذي حكيناه من جعل النقطة بالصفراء على الألف ، وجعل نقطة أو ياء بعدها بالحمراء ، هو قول من زعم أن همزة الاستفهام من إحدى الهمزتين هي المرسومة . وصورة ذلك كما ترى : " أءذا " ، " أءله " ، " أءنك " ، " أءنا " ، وشبهه .
فأما من زعم أن المرسومة همزة الأصل ؛ فإن النقطة الصفراء وحركتها تجعلان - على قوله - قبل الألف السوداء ، وتجعل تحت تلك الألف نقطة بالحمراء فقط . ولا يجوز أن تجعل في موضع النقطة ياء ، كما جاز ذلك في الوجه الأول ، من حيث كانت تلك الألف صورة للهمزة المحققة في الأصل ، قبل التسهيل . وصورة
[ ص: 103 ] ذلك كما ترى : " ءاذا " ، " ءاله " ، " ءانك " ، " ءانا " ، وشبهه .
وتلحق ألف بالحمراء بين الهمزة المحققة التي علامتها نقطة بالصفراء وبين الهمزة المسهلة التي علامتها نقطة بالحمراء ، أو ياء بالحمراء ، في مذهب من فصل بين المحققة والمسهلة بالألف . وإن شاء الناقط لم يلحق ألفا ، وجعل في موضعها مطة فقط . وصورة ذلك على قول من جعل الألف المصورة همزة الاستفهام كما ترى : " أءذا " ، " أءله " ، " أءنك " ، " أءنا " . وصورته على قول من جعل الألف المصورة همزة الأصل كما ترى : " ءاذا " ، " ءاله " ، " ءانك " ، " ءانا " .
ورأيت جماعة من علماء أهل النقط يجعلون الهمزة المحققة في هذا الضرب ، في مذهب من فصل ، قبل الألف السوداء ، ويجعلون الهمزة المسهلة نقطة بالحمراء بعدها ، ويجعلون على الألف السوداء مطة . فيحققون بذلك أن الفاصلة التي قد يحذف من الرسم ما هو أوكد منها وأولى هي المرسومة . وذلك خطأ لا شك فيه ؛ لأن من القراء من لا يفصل في حال تحقيق ولا تسهيل . ولأن همزة الاستفهام الداخلة لمعنى ، وهمزة الأصل التي هي لازمة للكلمة ، ومن نفسها ، أولى بالرسم من ألف تجتلب لتحقيق النطق لا غير . هذا ما لا تخفى صحته والخطأ في خلافه على من له أدنى فهم ، وأقل تمييز .
فأما نقط هذا الضرب على قراءة من حقق الهمزتين معا ، فكنقطه على قراءة من سهل الهمزة الثانية . إلا أنه تجعل في موضع الهمزة المسهلة التي علامتها نقطة بالحمراء فقط نقطة بالصفراء ، وحركتها تحتها نقطة بالحمراء ؛ ليؤذن بذلك بتحقيقها . وصورة ذلك على قول من زعم أن همزة الاستفهام هي المصورة كما
[ ص: 104 ] ترى : " أءذا " ، " أءله " ، " أءنك " ، " أءنا " . وصورته على قول من زعم أن همزة الأصل هي المصورة كما ترى : " ءاذا " ، " ءاله " ، " ءانك " ، " ءإنا " . وتجعل بين الهمزتين في مذهب من فصل بينهما بألف ، ألف أو مطة بالحمراء ، على القولين جميعا . وصورة ذلك على الأول : " أءذا " ، " أءله " ، " أءنك " ، " أءنا " . وعلى الثاني : " ءإذا " ، " ءإله " ، " ءإنك " ، " ءإنا " .
* * *
فأما ما جاءت الهمزة المسهلة فيه من هذا الضرب ، مرسومة ياء بالسواد ، كقوله : " أئنكم " في ( الأنعام ) وفي ( النمل ) وفي الثاني من ( العنكبوت ) وفي ( فصلت ) ، و " أئنا " في ( النمل ) و ( الصافات ) ، و " أئن لنا " في ( الشعراء ) ، و " أئذا " في ( الواقعة ) ، و " أئن ذكرتم " في ( يس ) ، و " أئفكا " في ( والصافات ) ؛ فإن الألف المصورة في ذلك هي همزة الاستفهام لا غير ؛ لأن الهمزة المسهلة قد صورت بعدها ، على نحو حركتها ، إعلاما بتسهيلها ، وإن لم تكن ياء خالصة في الحقيقة ، فإنها مقربة منها . والمقرب من الشيء قد يحكم له بحكم الشيء ، وإن لم يكن كهو في الحقيقة ، ألا ترى أن الهمزة المفتوحة لا تجعل بين بين قبل ضمة أو كسرة ، بل تبدل مع الضمة واوا ، ومع الكسرة ياء . وذلك أنها لو جعلت بين بين لصارت بين الهمزة والألف . والألف لا يكون ما قبلها مضموما ولا مكسورا . كذلك لا يكون قبل ما قرب بالتسهيل منها . فكما حكم هاهنا للمقرب
[ ص: 105 ] من الألف بحكم الألف ، فكذلك حكم هناك للهمزة المجعولة بين الهمزة والياء في الصورة حكم الياء الخالصة ، فصورت ياء .
فإذا نقط ذلك على قراءة من سهل جعلت الهمزة نقطة بالصفراء ، وحركتها عليها نقطة بالحمراء ، على الألف المصورة . وأعريت الياء السوداء بعدها من الحركة من حيث كانت خلفا من همزة مكسورة ، ولم تكن ياء مكسورة خالصة الكسر . ومن أهل النقط من يجعل تحتها كسرة ، ويجعل معها دارة صغرى ؛ علامة لتخفيفها ، وأنها ليست بمشبعة الكسرة ، وذلك على سبيل التقريب على القارئين . وهو عندي حسن . وصورة نقط ذلك على الوجه الأول كما ترى : " أينكم " ،
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=71أينا ، " أين لنا " ، " أيفكا " ، " أين ذكرتم " . وعلى الوجه الثاني : " أينكم " ،
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=71أينا ، " أين لنا " ، " أيفكا " ، " أين ذكرتم " .
وإن نقط على قراءة من حقق الهمزتين جعلت الهمزة الأولى وحركتها في الألف ، وجعلت الهمزة الثانية في الياء وحركتها تحتها . وصورة ذلك كما ترى : " أئنكم " ، " أئنا " ، " أئن " ، " أئفكا " ، " أئن ذكرتم " .
وتجعل الألف الفاصلة في حال التحقيق والتسهيل بين الألف والياء .
فصل
وأما نقط الضرب الثالث من الأضرب الثلاثة ، على قراءة من سهل
[ ص: 106 ] الهمزة الثانية ، ولم يفصل بينها وبين الهمزة الأولى المحققة بالألف ؛ فهو أن تجعل نقطة بالصفراء ، وحركتها عليها نقطة بالحمراء ، في الألف المصورة ، وتجعل بعدها في السطر نقطة بالحمراء لا غير . فيدل بذلك على تحقيق الهمزة الأولى ، وتسهيل الهمزة الثانية ، وأنه نحي بها نحو الواو . وهذا على قول من جعل الألف المصورة همزة الاستفهام . وصورة ذلك كما ترى : " أءنزل " ، " أءلقي " ، " أءشهدوا " .
وإن شاء الناقط جعل في موضع النقطة الحمراء التي هي علامة التسهيل واوا صغرى بالحمراء ، ويعريها من الحركة ، من حيث كانت خلفا من همزة ، ولم تكن واوا مشبعة الحركة ، كما جعل في موضع المكسورة المسهلة ياء . إذ قد رسم كتاب المصاحف الهمزة المسهلة واوا بالسواد في موضع واحد من هذا الضرب ، وهو قوله في ( آل عمران ) : " قل أؤنبئكم " ، ليأتي الباب كله على مذهب واحد من التسهيل .
والمذهب الأول أختار ؛ لما قدمته قبل .
فإن قيل : فما وجه رسمهم الهمزة الثانية في الضربين الأخيرين بالحرف الذي منه حركتها في بعض المواضع ، وترك رسمهم إياها أصلا في بعضها ؟ قيل : وجه ذلك إرادتهم التعريف بالوجهين من التحقيق والتسهيل في تلك الهمزة . فالموضع الذي جاءت الياء والواو فيه مرسومتين دليل على التسهيل . والموضع الذي جاءتا فيه غير مرسومتين دليل على التحقيق . وذلك من حيث كرهوا أن يجمعوا بين صورتين متفقتين ، فلذلك حذفوا إحدى الصورتين ، واكتفوا بالواحدة منهما إيجازا واختصارا .
[ ص: 107 ] ومن جعل الألف المصورة همزة القطع جعل النقطة بالصفراء ، وحركتها عليها ، قبل الألف . وجعل في الألف أو أمامها النقطة بالحمراء ، وصورة ذلك كما ترى : " ءانزل " ، " ءالقي " ، " ءاشهدوا " . وجعل بين الهمزة المحققة وبين الهمزة الملينة ، في مذهب من فصل بينهما بألف ، ألفا بالحمراء ، أو مطة في موضعها . وصورة ذلك على قول من جعل همزة الاستفهام هي المصورة كما ترى : " أءنزل " ، " أءلقي " ، " أءشهدوا " . وصورته على قول من جعل همزة القطع هي المصورة كما ترى : " ءانزل " ، " ءالقي " ، " ءاشهدوا " .
فأما نقط هذا الضرب على قراءة من حقق الهمزتين معا فكنقطه على قراءة من سهل الهمزة الثانية ، غير أنه يجعل في مكان الهمزة المسهلة التي علامتها نقطة بالحمراء فقط ، نقطة بالصفراء ، وحركتها نقطة بالحمراء أمامها . وصورة ذلك على القول الذي تجعل فيه همزة الاستفهام هي المصورة كما ترى : " أءنزل " ، " أءلقي " . وعلى القول الذي تجعل فيه همزة القطع هي المصورة كما ترى : " ءأنزل " ، " ءالقي " . وتجعل بين الهمزتين في مذهب من فصل بينهما بألف ، ألف أو مطة بالحمراء . وصورة ذلك على القول الأول : " أءنزل " ، " أءلقي " . وعلى الثاني : " ءأنزل " ، " ءألقي " .
* * *
فأما الموضع الذي رسمت فيه الهمزة الثانية واوا ، على مراد التسهيل ، وهو قوله في ( آل عمران ) : " قل أؤنبئكم " فإن الألف المصورة قبلها هي همزة الاستفهام لا غير . وذلك من حيث صوروا الهمزة الثانية بالحرف الذي منه حركتها .
فإذا نقط ذلك على قراءة من سهل ؛ جعلت الهمزة نقطة بالصفراء ، وحركتها
[ ص: 108 ] عليها نقطة بالحمراء في الألف ، وأعريت الواو بعدها من الحركة ؛ لأنها ليست بواو مشبعة الحركة ، وإنما هي خلف من همزة مضمومة . وصورة ذلك كما ترى : " أؤنبئكم " . ومن أهل النقط من يجعل أمام الواو نقطة ، وعلى الواو دارة ؛ علامة لتخفيفها . وهو وجه . والأول أحسن . وصورة ذلك كما ترى : " أونبئكم " .
وإن نقط ذلك على قراءة من حقق الهمزتين جعلت الهمزة الأولى وحركتها على الألف ، وجعلت الهمزة الثانية في الواو وحركتها أمامها . وصورة ذلك كما ترى : " أؤنبئكم " .
وتجعل الألف الفاصلة - في مذهب من سهل ، أو حقق - بين الألف والواو . وصورة ذلك في التسهيل : " أونبئكم " ، وفي التحقيق : " أؤنبئكم " .
* * *
ما ورد من هذا الضرب والذي قبله مرسوما بالواو والياء ، بعد الألف المصورة ، فهو على مراد التسهيل ، وتقدير الاتصال . وما ورد فيهما مرسوما بغيرهما فهو على مراد التحقيق ، وتقدير الانفصال . إلا أن إحدى الألفين حذفت اختصارا لما قدمناه .
وقد اختلف أهل النقط في جعل الهمزة المحققة في الألف والياء والواو ، إذا كن صورا لها . فمنهم من يجعلها في أنفس هذه الحروف ، ويجعل حركة المفتوحة فوق الألف إن صورت ألفا ، وحركة المكسورة تحت الياء إن صورت ياء ، وحركة المضمومة أمام الواو إن صورت واوا . ومنهم من يخالف بها ، فيجعل المفتوحة وحركتها على الألف ، والمكسورة وحركتها تحت الياء ، والمضمومة
[ ص: 109 ] وحركتها في الواو ؛ ويجمع بين الهمزة وبين حركتها ، ولا يفرق بينهما ، كما لا يفرق بين سائر الحروف وبين حركاتهن .
والقول الأول أوجه . وذلك من حيث كانت الهمزة حرفا من حروف المعجم . فكما تلزم الحروف غيرها موضعا واحدا من السطر ؛ كذلك ينبغي أن تلزم الهمزة أيضا موضعا واحدا ، وأن تجعل لها في الكتابة صورة . وتكون الحركات دالة على ما تستحقه منهن ، كما تدل على سائر الحروف .
وإن اكتفى الناقط في الهمزات المبتدءات والمتوسطات بجعل الهمزة وحدها دون حركتها ، من حيث كانت حركة بناء لازمة ؛ فحسن . وأما الهمزات المتطرفات فلا بد من جعل الحركة معهن ، من حيث كانت حركة إعراب تتغير وتنتقل . فاعلم ذلك . وبالله التوفيق .
[ ص: 93 ] بَابٌ
ذِكْرُ
nindex.php?page=treesubj&link=29577_28885أَحْكَامِ الْهَمْزَتَيْنِ اللَّتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ
اعْلَمْ أَنَّ الْهَمْزَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : فَالضَّرْبُ الْأَوَّلُ أَنْ تَتَحَرَّكَا مَعًا بِالْفَتْحِ . وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِهِ : " ءَأَنْذَرْتَهُم " ، وَ " ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ " ، وَ " ءَأَسْجُدُ " ، وَ " ءَأَلِدُ " ، وَ " ءَأَتَّخِذُ " ، وَشِبْهِهِ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي أَنْ تَتَحَرَّكَ الْأُولَى بِالْفَتْحِ وَالثَّانِيَةُ بِالْكَسْرِ ، وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِهِ : " أَءِذَا " ، وَ " أَءِلَهٌ " ، وَ " أَءِنَّكَ لَأَنْتَ " ، وَ " أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ " ، وَشِبْهِهِ . وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ أَنْ تَتَحَرَّكَ الْأُولَى بِالْفَتْحِ وَالثَّانِيَةُ بِالضَّمِّ ، وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِهِ : " أَءُنْزِلَ عَلَيْهِ " ، وَ " أَءُلْقِيَ الذِّكْرُ " ، وَ " أَءَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ " ، عَلَى قِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٍ .
* * *
فَأَمَّا الْهَمْزَةُ الْأُولَى فِي هَذِهِ الْأَضْرُبِ الثَّلَاثَةِ ؛ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ فِي
[ ص: 94 ] تَحْقِيقِهَا ؛ لِكَوْنِهَا مُبْتَدَأَةً ، وَالْمُبْتَدَأَةُ لَا تُلَيَّنُ ، مِنْ حَيْثُ كَانَ التَّلْيِينُ يُقَرِّبُهَا مِنَ السَّاكِنِ ، وَالِابْتِدَاءُ بِالسَّاكِنِ مُمْتَنِعٌ . فَلِذَلِكَ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَحْقِيقِهَا . فَإِنْ وُصِلَتْ بِسَاكِنٍ جَامِدٍ قَبْلَهَا فَنَافِعٌ مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشٍ يُلْقِي حَرَكَتَهَا عَلَى ذَلِكَ السَّاكِنِ ، وَيُسْقِطُهَا مِنَ اللَّفْظِ تَخْفِيفًا ، كَقَوْلِهِ : " رَحِيمٌ ءَأَشْفَقْتُمْ " ، وَ " قُلْ ءَأَنْتُم " ، وَ " عَجِيبٌ اءِذَا " ، وَ " إِلَّا اخْتِلَاقٌ ءَأُنْزِلَ " ، وَشِبْهِهِ .
وَأَمَّا الْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ فَاخْتَلَفُوا فِي تَحْقِيقِهَا عَلَى الْأَصْلِ ، وَفِي تَلْيِينِهَا ، وَفِي إِدْخَالِ أَلِفٍ فَاصِلَةٍ فِي حَالِ التَّحْقِيقِ وَالتَّلْيِينِ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ . وَذَلِكَ بَعْدَ إِجْمَاعِ كُتَّابِ الْمَصَاحِفِ عَلَى حَذْفِ صُورَةِ إِحْدَى الْهَمْزَتَيْنِ مِنَ الرَّسْمِ ؛ كَرَاهَةً لِلْجَمْعِ بَيْنَ صُورَتَيْنِ مُتَّفِقَتَيْنِ ، وَاكْتِفَاءً بِالْوَاحِدِ مِنْهُمَا .
وَاخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الْعَرَبِيَّةِ فِي أَيِّهِمَا الْمَحْذُوفَةُ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيُّ : الْمَحْذُوفَةُ مِنَ الْهَمْزَتَيْنِ هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ ، مِنْ حَيْثُ كَانَتْ حَرْفًا زَائِدًا دَاخِلًا عَلَى الْكَلِمَةِ ، وَالثَّابِتَةُ هَمْزَةُ الْأَصْلِ أَوِ الْقَطْعِ ، مِنْ حَيْثُ كَانَتْ لَازِمَةً لِلْكَلِمَةِ . وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ عَامَّةُ أَصْحَابِ الْمَصَاحِفِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءُ ،
وَأَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ كَيْسَانَ : الْمَحْذُوفَةُ مِنْهُمَا هَمْزَةُ الْأَصْلِ أَوِ الْقَطْعِ ، وَالْمَرْسُومَةُ هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ . وَذَلِكَ مِنْ جِهَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا أَنَّ هَمْزَةَ الِاسْتِفْهَامِ مُبْتَدَأَةٌ ، وَالْمُبْتَدَأَةُ لَا تُحْذَفُ صُورَتُهَا فِي نَحْوِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=27أَمَرَ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=71إِمْرًا ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=4أَنْزَلَ ، وَشِبْهِهِ بِإِجْمَاعٍ . وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَجُزْ تَخْفِيفُهَا
[ ص: 95 ] فِي تِلْكَ الْحَالِ ، لَا بِحَذْفٍ وَلَا بِتَسْهِيلٍ ؛ لِعَدَمِ مَا يَنُوبُ عَنْهَا هُنَاكَ . وَالثَّانِيَةُ أَنَّهَا دَاخِلَةٌ لِمَعْنًى ، وَهُوَ الِاسْتِخْبَارُ ، فَوَجَبَ رَسْمُهَا وَإِثْبَاتُ صُورَتِهَا ، لِيَتَأَدَّى بِذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي دَخَلَتْ لَهُ وَاجْتُلِبَتْ لِأَجْلِهِ .
وَكَذَا اخْتِلَافُهُمْ فِي هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى هَمْزَةِ الْوَصْلِ الَّتِي مَعَهَا لَامُ التَّعْرِيفِ ، نَحْوُ قَوْلِهِ : " قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ " ، وَ " ءَاللهُ أَذِنَ لَكُم " ، وَ " ءَالْئنَ وَقَدْ عَصَيْتَ " ، وَشِبْهِهِ .
وَالْوَجْهَانِ فِي ذَلِكَ صَحِيحَانِ .
* * *
فَأَمَّا نَقْطُ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ ، عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ سَهَّلَ الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ ، وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْهَمْزَةِ الْأُولَى بِأَلِفٍ ؛ فَهُوَ أَنْ تُجْعَلَ نُقْطَةٌ بِالصَّفْرَاءِ ، وَحَرَكَتُهَا عَلَيْهَا نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ ، قَبْلَ الْأَلِفِ الْمُصَوَّرَةِ . وَتُجْعَلَ عَلَى الْأَلِفِ الْمُصَوَّرَةِ نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ فَقَطْ . فَيُدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى تَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ الْأُولَى ، وَتَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ . هَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْهَمْزَةَ الْأُولَى هِيَ الْمَحْذُوفُ صُورَتُهَا . وَصُورَةُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى : " ءَانْذَرْتَهُم " ، " ءَانْتُمْ " ، " ءَاَلِدُ " ، " ءَاَشْفَقْتُم " ، وَشِبْهِهِ .
وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ هِيَ الْمَحْذُوفَةُ صُورَتُهَا تُجْعَلُ النُّقْطَةُ الصَّفْرَاءُ ، وَحَرَكَتُهَا نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ ، فِي الْأَلِفِ الْمُصَوَّرَةِ . وَتُرْسَمُ بَعْدَهَا أَلِفٌ بِالْحَمْرَاءِ ، وَتُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهَا نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ ؛ عَلَامَةً لِلتَّسْهِيلِ . وَإِنْ شَاءَ النَّاقِطُ لَمْ يَرْسِمْ ذَلِكَ ، وَجَعَلَ
[ ص: 96 ] النُّقْطَةَ بِالْحَمْرَاءِ فِي مَوْضِعِهَا . وَصُورَةُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى : " أَاَنْذَرْتَهُمْ " ، " أَاَنْتُمْ " ، " أَاَلِدُ " ، " أَاَشْفَقْتُمْ " ، وَشِبْهِهِ .
وَأَمَّا نَقْطُ ذَلِكَ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ سَهَّلَ وَفَصَلَ بِالْأَلِفِ ، عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ جَمِيعًا ، فَكَمَا تَقَدَّمَ سَوَاءً . وَتُجْعَلُ الْأَلِفُ الْفَاصِلَةُ بِالْحَمْرَاءِ بَيْنَ الْهَمْزَةِ الْمُحَقَّقَةِ الَّتِي عَلَامَتُهَا نُقْطَةٌ بِالصَّفْرَاءِ ، وَبَيْنَ الْهَمْزَةِ الْمُسَهَّلَةِ الَّتِي عَلَامَتُهَا نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ . وَإِنْ شَاءَ النَّاقِطُ لَمْ يَجْعَلْ أَلِفًا ، وَجَعَلَ فِي مَوْضِعِهَا مَطَّةً ، إِذْ فِي ذَلِكَ إِعْلَامٌ بِالْفَصْلِ . وَصُورَةُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ كَمَا تَرَى : " ءَاَنْذَرْتَهُمْ " ، " ءَاَنْتُمْ " ، " ءَاَلِدُ " ، " ءَاَشْفَقْتُمْ " ، وَعَلَى الثَّانِي : " أَاَنْذَرْتَهُمُ " ، " أَاَنْتُم " ، " أَاَلِدُ " ، " أَاَشْفَقْتُمْ " .
وَأَمَّا نَقْطُ هَذَا الضَّرْبِ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ حَقَّقَ الْهَمْزَتَيْنِ مَعًا فَهُوَ أَنْ تُجْعَلَ الْهَمْزَةُ الْأُولَى نُقْطَةً بِالصَّفْرَاءِ ، وَحَرَكَتُهَا عَلَيْهَا نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ ، قَبْلَ الْأَلِفِ الْمُصَوَّرَةِ . وَتُجْعَلَ الْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ نُقْطَةً بِالصَّفْرَاءِ ، وَحَرَكَتُهَا عَلَيْهَا ، فِي الْأَلِفِ الْمُصَوَّرَةِ . هَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْهَمْزَةَ الْأُولَى هِيَ الْمَحْذُوفُ صُورَتُهَا . وَصُورَةُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى : " ءَأَنْذَرْتَهُم " ، " ءَأَنْتُم " ، " ءَأَلِدُ " ، " ءَأَشْفَقْتُم " ، وَشِبْهِهِ .
وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ هِيَ الْمَحْذُوفُ صُورَتُهَا تُجْعَلُ الْهَمْزَةُ الْأُولَى وَحَرَكَتُهَا فِي الْأَلِفِ الْمُصَوَّرَةِ . وَتُجْعَلُ الْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ وَحَرَكَتُهَا بَعْدَ تِلْكَ الْأَلِفِ . وَإِنْ شَاءَ النَّاقِطُ جَعَلَ لَهَا صُورَةً بِالْحَمْرَاءِ . وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا صُورَةً ، وَاكْتَفَى بِالْهَمْزَةِ وَالْحَرَكَةِ مِنْهَا . وَصُورَةُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى : " أَءَنْذَرْتَهُمْ " ، " أَءَنْتُم " ، " أَءَلِدُ " ، " أَءَشْفَقْتُم " ، وَشِبْهُهُ .
[ ص: 97 ] وَتُجْعَلُ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ ، فِي مَذْهَبِ مَنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِأَلِفٍ ، أَلِفٌ أَوْ مَطَّةٌ بِالْحَمْرَاءِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا . وَصُورَةُ ذَلِكَ عَلَى الْأَوَّلِ : " ءَأَنْذَرْتَهُم " ، وَ " ءَأَنْتُم " ، " ءَأَلِدُ " ، " ءَأَشْفَقْتُمُ " . وَعَلَى الثَّانِي : " أَءَنْذَرْتَهُم " ، " أَءَنْتُم " ، " أَءَلِدُ " ، " أَءَشْفَقْتُم " .
فَصْلٌ
فَأَمَّا مَا تَدْخُلُ فِيهِ هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ عَلَى هَمْزَةِ الْوَصْلِ الَّتِي مَعَهَا لَامُ التَّعْرِيفِ ؛ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْقُرَّاءِ يُحَقِّقُ هَمْزَةَ الْوَصْلِ ، وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ بِأَلِفٍ فِي ذَلِكَ . وَهُوَ إِجْمَاعٌ مِنَ الْعَرَبِ أَيْضًا . وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ لَمْ تَقْوَ هَمْزَةُ الْوَصْلِ قُوَّةَ غَيْرِهَا مِنَ الْهَمَزَاتِ . وَإِنَّمَا شُبِّهَتْ هَاهُنَا بِهِنَّ لَمَّا احْتِيجَ إِلَى إِثْبَاتِهَا فِيهِ ؛ لِيَتَمَيَّزَ بِإِثْبَاتِهَا الِاسْتِفْهَامُ مِنَ الْخَبَرِ لَا غَيْرُ . فَلِذَلِكَ لَمْ تَتَحَقَّقْ نَبْرَتُهَا ، وَلَمْ يُفْصَلْ بِأَلِفٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ .
فَإِذَا نُقِطَ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ الْجَمِيعِ جُعِلَتْ نُقْطَةٌ بِالصَّفْرَاءِ ، وَحَرَكَتُهَا عَلَيْهَا نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ ، قَبْلَ الْأَلِفِ السَّوْدَاءِ . وَجُعِلَ فِي رَأْسِ الْأَلِفِ السَّوْدَاءِ نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ فَقَطْ . هَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ هَمْزَةَ الِاسْتِفْهَامِ هِيَ الْمَحْذُوفُ صُورَتُهَا . وَصُورَةُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى : " ءَالذَّكَرَيْنِ " ، " ءَاللهُ " ، " ءَالْئَنَ " ، وَشِبْهُهُ .
وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ هَمْزَةَ الْوَصْلِ هِيَ الْمَحْذُوفُ صُورَتُهَا تُجْعَلُ النُّقْطَةُ الصَّفْرَاءُ وَحَرَكَتُهَا فِي الْأَلِفِ السَّوْدَاءِ . وَتُجْعَلُ النُّقْطَةُ الْحَمْرَاءُ الَّتِي هِيَ عَلَامَةُ التَّسْهِيلِ بَعْدَ الْأَلِفِ السَّوْدَاءِ . وَإِنْ شَاءَ النَّاقِطُ جَعَلَ لَهَا صُورَةً بِالْحَمْرَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ . وَصُورَةُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى : " أَاَلذَّكَرَيْنِ " ، " أَاَللهُ " ، " أَاَلْئَنَ " ، وَشِبْهُهُ .
[ ص: 98 ] وَأَكْثَرُ النَّحْوِيِّينَ وَالْقُرَّاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَمْزَةَ الْوَصْلِ فِي هَذَا النَّوْعِ تُبْدَلُ إِبْدَالًا مَحْضًا ، وَلَا تُجْعَلُ بَيْنَ بَيْنَ . فَتَصِيرُ فِي مَذْهَبِهِمْ مَدَّةً مُشْبَعَةً . فَإِذَا نُقِطَ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ جُعِلَ مَكَانَ النُّقْطَةِ الْحَمْرَاءِ الَّتِي هِيَ عَلَامَةُ التَّسْهِيلِ مَطَّةٌ بِالْحَمْرَاءِ ؛ لِيُدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى الْبَدَلِ الْمَحْضِ . وَصُورَةُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ كَمَا تَرَى : " ءَاَلذَّكَرَيْنِ " ، " ءَاللهُ " ، " ءَاَلْئَنَ " ؛ " أَالذَّكَرَيْنِ " ، " أَاللهُ " ، " أَالْئَنَ " .
فَصْلٌ
وَأَمَّا مَا تَدْخُلُ فِيهِ هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ عَلَى هَمْزَتَيْنِ ، الْأُولَى هَمْزَةُ الْقَطْعِ ، وَالثَّانِيَةُ هَمْزَةُ الْأَصْلِ ، وَهُوَ مُتَّصِلٌ بِالضَّرْبِ الْأَوَّلِ ، وَجُمْلَةُ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ فِي ( الْأَعْرَافِ ) ، وَ ( طه ) ، وَ ( الشُّعَرَاءِ ) : " ءَأَمَنْتُمْ " ، وَفِي ( الزُّخْرُفِ ) : " ءَأَلِهَتُنَا " ، فَإِنَّ الْقُرَّاءَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ . مِنْهُمْ مَنْ يَقْرَأُ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ بِالِاسْتِفْهَامِ ، وَتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ - هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ ، وَهَمْزَةِ الْقَطْعِ بَعْدَهَا - . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْرَؤُهَا بِالِاسْتِفْهَامِ وَتَحْقِيقِ هَمْزَتِهِ ، وَتَسْهِيلِ هَمْزَةِ الْقَطْعِ بَعْدَهَا . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْرَؤُهَا عَلَى لَفْظِ الْخَبَرِ . وَكُلُّهُمْ أَبْدَلَ هَمْزَةَ الْأَصْلِ فِي ذَلِكَ أَلِفًا ، مِنْ حَيْثُ كَانَتْ سَاكِنَةً . وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ وَبَيْنَ هَمْزَةِ الْقَطْعِ بِأَلِفٍ مَنْ حَقَّقَ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْهُمْ ، وَمَنْ سَهَّلَ إِحْدَاهُمَا ، كَرَاهَةً لِتَوَالِي أَرْبَعِ أَلِفَاتٍ فِي ذَلِكَ .
[ ص: 99 ] وَاتَّفَقَ كُتَّابُ الْمَصَاحِفِ عَلَى رَسْمِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ بِأَلِفٍ وَاحِدَةٍ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ كَرَاهَتِهِمْ لِاجْتِمَاعِ صُوَرٍ مُتَّفِقَةٍ ، وَاكْتِفَائِهِمْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ . وَتَحْتَمِلُ تِلْكَ الْأَلِفُ الْمَرْسُومَةُ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ : أَنْ تَكُونَ هَمْزَةَ الِاسْتِفْهَامِ ، مِنْ حَيْثُ كَانَتْ دَاخِلَةً لِمَعْنًى لَا بُدَّ مِنْ تَأْدِيَتِهِ . وَأَنْ تَكُونَ هَمْزَةَ الْقَطْعِ ، مِنْ حَيْثُ كَانَتْ كَاللَّازِمَةِ . وَأَنْ تَكُونَ هَمْزَةَ الْأَصْلِ ، مِنْ حَيْثُ كَانَتْ مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ .
فَإِذَا نُقِطَ ذَلِكَ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ حَقَّقَ هَمْزَةَ الِاسْتِفْهَامِ ، وَسَهَّلَ هَمْزَةَ الْقَطْعِ بَعْدَهَا ، وَجُعِلَتِ الْأَلِفُ الْمُصَوَّرَةُ هَمْزَةَ الِاسْتِفْهَامِ ، جُعِلَ عَلَى تِلْكَ الْأَلِفِ نُقْطَةٌ بِالصَّفْرَاءِ ، وَحَرَكَتُهَا عَلَيْهَا نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ ، وَجُعِلَ بَعْدَ الْأَلِفِ نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ فَقَطْ ، وَرُسِمَ بَعْدَهَا أَلِفٌ بِالْحَمْرَاءِ ؛ لِيُدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ بَعْدَ الْهَمْزَةِ الْمُسَهَّلَةِ أَلِفًا سَاكِنَةً ، هِيَ بَدَلٌ مِنْ هَمْزَةِ فَاءِ الْفِعْلِ السَّاكِنَةِ . وَلَا بُدَّ مِنْ رَسْمِ هَذِهِ الْأَلِفِ فِي هَذَا الْوَجْهِ ، لِمَا ذَكَرْنَا . وَصُورَةُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى : " أَامَنْتُمْ " ، " أَالِهَتُنَا " .
فَإِنْ جُعِلَتِ الْأَلِفُ الْمُصَوَّرَةُ هَمْزَةَ الْقَطْعِ الزَّائِدَةَ عَلَى فَاءِ الْفِعْلِ جُعِلَتِ النُّقْطَةُ بِالصَّفْرَاءِ ، وَحَرَكَتُهَا عَلَيْهَا ، قَبْلَ الْأَلِفِ السَّوْدَاءِ ، وَجُعِلَ عَلَى الْأَلِفِ نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ ، وَرُسِمَ بَعْدَهَا أَلِفٌ بِالْحَمْرَاءِ ، لِيُدَلَّ عَلَى فَاءِ الْفِعْلِ بِذَلِكَ . وَصُورَةُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى " ءَامَنْتُمْ " ، " ءَالِهَتُنَا " .
[ ص: 100 ] وَإِنْ جُعِلَتِ الْأَلِفُ الْمُصَوَّرَةُ هَمْزَةَ الْأَصْلِ الْمُبْدَلَةَ أَلِفًا جُعِلَتِ النُّقْطَةُ بِالصَّفْرَاءِ ، وَحَرَكَتُهَا عَلَيْهَا ، قَبْلَ تِلْكَ الْأَلِفِ الْمُصَوَّرَةِ فِي السَّطْرِ ، وَرُسِمَ بَعْدَهَا أَلِفٌ بِالْحَمْرَاءِ ، وَجُعِلَ عَلَيْهَا نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ فَقَطْ . فَتَحْصُلُ هَذِهِ الْأَلِفُ بَيْنَ الْهَمْزَةِ الَّتِي عَلَامَتُهَا نُقْطَةٌ بِالصَّفْرَاءِ ، وَبَيْنَ الْأَلِفِ السَّوْدَاءِ . وَإِنْ شَاءَ النَّاقِطُ لَمْ يَرْسِمْ تِلْكَ الْأَلِفَ ، وَجَعَلَ النُّقْطَةَ بِالْحَمْرَاءِ فِي مَوْضِعِهَا لَا غَيْرُ . وَصُورَةُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى : " أَءَمَنْتُمْ " ، " أَءَلِهَتُنَا " .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي الَّذِي تُجْعَلُ فِيهِ الْأَلِفُ الْمَرْسُومَةُ هَمْزَةَ الْقَطْعِ أَوْجَهُ عِنْدِي ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْحَرْفَ لَا يَتَوَالَى فِيهِ كَمَا يَتَوَالَى فِي الْوَجْهَيْنِ الْآخَرَيْنِ . وَعَلَى ذَلِكَ أَصْحَابُ الْمَصَاحِفِ . وَهُوَ اخْتِيَارِي ، وَإِلَيْهِ أَذْهَبُ ، وَبِهِ أَنْقُطُ .
وَإِذَا نُقِطَ ذَلِكَ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ حَقَّقَ الْهَمْزَتَيْنِ - هَمْزَةَ الِاسْتِفْهَامِ ، وَهَمْزَةَ الْقَطْعِ - ؛ فُعِلَ فِيهِ كَمَا فُعِلَ فِي مَذْهَبِ مَنْ سَهَّلَ الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ ، إِلَّا أَنَّهُ تُجْعَلُ مَكَانَ النُّقْطَةِ الْحَمْرَاءِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّسْهِيلِ نُقْطَةٌ بِالصَّفْرَاءِ ، وَحَرَكَتُهَا عَلَيْهَا نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ . وَصُورَةُ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ كَمَا تَرَى : " أَءَمَنْتُمْ " ، " أَءَلِهَتُنَا " . وَعَلَى الثَّانِي : " ءَأَمَنْتُمْ " ، " ءَأَلِهَتُنَا " . وَعَلَى الثَّالِثِ : " ءَأَمَنْتُمْ " ، " ءَأَلِهَتُنَا " .
وَإِنْ نُقِطَتْ هَذِهِ الْمَوَاضِعُ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَهَا عَلَى لَفْظِ الْخَبَرِ ؛ جُعِلَ قَبْلَ الْأَلِفِ الْمُصَوَّرَةِ نُقْطَةٌ بِالصَّفْرَاءِ ، وَحَرَكَتُهَا عَلَيْهَا نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ لَا غَيْرُ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَلِفَ
[ ص: 101 ] الْمُصَوَّرَةَ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ أَلِفُ الْأَصْلِ ، مِنْ حَيْثُ كَانَتْ مُبْدَلَةً مِنْ هَمْزَةِ فَاءِ الْفِعْلِ لَا غَيْرُ ، كَمَا هِيَ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ ، نَحْوُ قَوْلِهِ : " ءَامَنَ الرَّسُولُ " ، وَ " ءَالِهَتُكَ " ، وَ " ءَامَنَهُمْ " ، وَ " ءَاتَى اَلْمَالَ " ، وَشِبْهِهِ . وَصُورَةُ نَقْطِ ذَلِكَ كَمَا تَرَى : " ءَامَنْتُمْ " ، وَ " ءَالِهَتُنَا " .
وَقَدْ رَوَى
الْقَوَّاسُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنِ كَثِيرٍ أَنَّهُ يُسَهِّلُ هَمْزَةَ الِاسْتِفْهَامِ وَهَمْزَةَ الْقَطْعِ فِي قَوْلِهِ فِي ( الْأَعْرَافِ ) : " قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَمَنْتُمْ بِهِ " ، فَيُبْدِلُ هَمْزَةَ الِاسْتِفْهَامِ وَاوًا مَفْتُوحَةً لِانْضِمَامِ مَا قَبْلَهَا ، وَيَجْعَلُ هَمْزَةَ الْقَطْعِ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْأَلِفِ ؛ طَلَبًا لِلتَّخْفِيفِ وَتَسْهِيلِ اللَّفْظِ بِذَلِكَ .
فَإِذَا نُقِطَ ذَلِكَ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ ؛ جُعِلَ عَلَى الْأَلِفِ الْمُصَوَّرَةِ نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ ، وَرُسِمَ قَبْلَهَا وَاوٌ بِالْحَمْرَاءِ ، وَجُعِلَ عَلَيْهَا نُقْطَةٌ ؛ لِأَنَّهَا مُبْدَلَةٌ بَدَلًا خَالِصًا . وَرُسِمَ أَيْضًا بَعْدَ تِلْكَ الْأَلِفِ أَلِفٌ بِالْحَمْرَاءِ ؛ لِيُؤْذَنَ بِأَنَّهَا بَعْدَهَا فِي الْأَصْلِ وَاللَّفْظِ . وَصُورَةُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى : " فِرْعَوْنُ وَامَنْتُمْ " .
وَقَدْ يَجُوزُ فِي نَقْطِ ذَلِكَ مَا جَازَ فِي نَقْطِهِ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ حَقَّقَ هَمْزَةَ الِاسْتِفْهَامِ وَسَهَّلَ هَمْزَةَ الْقَطْعِ ، إِلَّا أَنَّهُ تُجْعَلُ مَكَانَ النُّقْطَةِ الصَّفْرَاءِ الَّتِي هِيَ عَلَامَةُ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ الْمُحَقَّقَةِ نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ فَقَطْ .
فَصْلٌ
وَأَمَّا نَقْطُ الضَّرْبِ الثَّانِي مِنَ الثَّلَاثَةِ الْأَضْرُبِ ، عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ سَهَّلَ
[ ص: 102 ] الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ ، وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْهَمْزَةِ الْأُولَى الْمُحَقَّقَةِ بِأَلِفٍ ؛ فَهُوَ أَنْ تُجْعَلَ نُقْطَةٌ بِالصَّفْرَاءِ ، وَحَرَكَتُهَا عَلَيْهَا ، عَلَى الْأَلِفِ الْمُصَوَّرَةِ ، وَتُجْعَلَ بَعْدَهَا فِي السَّطْرِ نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ لَا غَيْرُ . فَيُدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى تَحْقِيقِ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ ، وَتَسْهِيلِ هَمْزَةِ الْأَصْلِ .
وَإِنْ شَاءَ النَّاقِطُ جَعَلَ فِي مَوْضِعِ النُّقْطَةِ الْحَمْرَاءِ الَّتِي هِيَ عَلَامَةُ التَّسْهِيلِ يَاءً بِالْحَمْرَاءِ ، وَأَلْحَقَهَا بِالْحَرْفِ ، مِنْ حَيْثُ قَرُبَتِ الْهَمْزَةُ الْمُسَهَّلَةُ فِي هَذَا الضَّرْبِ مِنْهَا . إِلَّا أَنَّهَا إِذَا أُلْحِقَتْ أُعْرِيَتْ مِنَ الْحَرَكَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِيَاءٍ مَكْسُورَةٍ خَالِصَةٍ ، وَإِنَّمَا هِيَ بَيْنَ الْهَمْزَةِ الْمُحَقَّقَةِ وَالْيَاءِ السَّاكِنَةِ .
وَإِنَّمَا أَطْلَقْنَا لِلنَّاقِطِ إِلْحَاقَ يَاءٍ بَعْدَ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ مِنْ حَيْثُ رَسَمَهَا كُتَّابُ الْمَصَاحِفِ بِالسَّوَادِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ ؛ دَلَالَةً عَلَى التَّسْهِيلِ ؛ لِيَأْتِيَ الضَّرْبُ كُلُّهُ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ . وَالَّذِي أَخْتَارُهُ أَلَّا تُلْحَقَ الْيَاءُ فِي ذَلِكَ ، وَأَنْ تُجْعَلَ النُّقْطَةُ فِي مَوْضِعِهَا .
وَهَذَا الَّذِي حَكَيْنَاهُ مِنْ جَعْلِ النُّقْطَةِ بِالصَّفْرَاءِ عَلَى الْأَلِفِ ، وَجَعْلِ نُقْطَةٍ أَوْ يَاءٍ بَعْدَهَا بِالْحَمْرَاءِ ، هُوَ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَمْزَةَ الِاسْتِفْهَامِ مِنْ إِحْدَى الْهَمْزَتَيْنِ هِيَ الْمَرْسُومَةُ . وَصُورَةُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى : " أَءِذَا " ، " أَءِلَهٌ " ، " أَءِنَّكَ " ، " أَءِنَّا " ، وَشِبْهُهُ .
فَأَمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَرْسُومَةَ هَمْزَةُ الْأَصْلِ ؛ فَإِنَّ النُّقْطَةَ الصَّفْرَاءَ وَحَرَكَتَهَا تُجْعَلَانِ - عَلَى قَوْلِهِ - قَبْلَ الْأَلِفِ السَّوْدَاءِ ، وَتُجْعَلُ تَحْتَ تِلْكَ الْأَلِفِ نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ فَقَطْ . وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ فِي مَوْضِعِ النُّقْطَةِ يَاءٌ ، كَمَا جَازَ ذَلِكَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، مِنْ حَيْثُ كَانَتْ تِلْكَ الْأَلِفُ صُورَةً لِلْهَمْزَةِ الْمُحَقَّقَةِ فِي الْأَصْلِ ، قَبْلَ التَّسْهِيلِ . وَصُورَةُ
[ ص: 103 ] ذَلِكَ كَمَا تَرَى : " ءَاِذَا " ، " ءَاِلَهٌ " ، " ءَاِنَّكَ " ، " ءَاِنَّا " ، وَشِبْهُهُ .
وَتُلْحَقُ أَلِفٌ بِالْحَمْرَاءِ بَيْنَ الْهَمْزَةِ الْمُحَقَّقَةِ الَّتِي عَلَامَتُهَا نُقْطَةٌ بِالصَّفْرَاءِ وَبَيْنَ الْهَمْزَةِ الْمُسَهَّلَةِ الَّتِي عَلَامَتُهَا نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ ، أَوْ يَاءٌ بِالْحَمْرَاءِ ، فِي مَذْهَبِ مَنْ فَصَلَ بَيْنَ الْمُحَقَّقَةِ وَالْمُسَهَّلَةِ بِالْأَلِفِ . وَإِنْ شَاءَ النَّاقِطُ لَمْ يُلْحِقْ أَلِفًا ، وَجَعَلَ فِي مَوْضِعِهَا مَطَّةً فَقَطْ . وَصُورَةُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ الْأَلِفَ الْمُصَوَّرَةَ هَمْزَةَ الِاسْتِفْهَامِ كَمَا تَرَى : " أَءِذَا " ، " أَءِلَهٌ " ، " أَءِنَّكَ " ، " أَءِنَّا " . وَصُورَتُهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ الْأَلِفَ الْمُصَوَّرَةَ هَمْزَةَ الْأَصْلِ كَمَا تَرَى : " ءَاِذَا " ، " ءَاِلَهٌ " ، " ءَاِنَّكَ " ، " ءِاِنَّا " .
وَرَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ النَّقْطِ يَجْعَلُونَ الْهَمْزَةَ الْمُحَقَّقَةَ فِي هَذَا الضَّرْبِ ، فِي مَذْهَبِ مَنْ فَصَلَ ، قَبْلَ الْأَلِفِ السَّوْدَاءِ ، وَيَجْعَلُونَ الْهَمْزَةَ الْمُسَهَّلَةَ نُقْطَةً بِالْحَمْرَاءِ بَعْدَهَا ، وَيَجْعَلُونَ عَلَى الْأَلِفِ السَّوْدَاءِ مَطَّةً . فَيُحَقِّقُونَ بِذَلِكَ أَنَّ الْفَاصِلَةَ الَّتِي قَدْ يُحْذَفُ مِنَ الرَّسْمِ مَا هُوَ أَوْكَدُ مِنْهَا وَأَوْلَى هِيَ الْمَرْسُومَةُ . وَذَلِكَ خَطَأٌ لَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّ مِنَ الْقُرَّاءِ مَنْ لَا يَفْصِلُ فِي حَالِ تَحْقِيقٍ وَلَا تَسْهِيلٍ . وَلِأَنَّ هَمْزَةَ الِاسْتِفْهَامِ الدَّاخِلَةَ لِمَعْنًى ، وَهَمْزَةَ الْأَصْلِ الَّتِي هِيَ لَازِمَةٌ لِلْكَلِمَةِ ، وَمِنْ نَفْسِهَا ، أَوْلَى بِالرَّسْمِ مِنْ أَلِفٍ تُجْتَلَبُ لِتَحْقِيقِ النُّطْقِ لَا غَيْرُ . هَذَا مَا لَا تَخْفَى صِحَّتُهُ وَالْخَطَأُ فِي خِلَافِهِ عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى فَهْمٍ ، وَأَقَلُّ تَمْيِيزٍ .
فَأَمَّا نَقْطُ هَذَا الضَّرْبِ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ حَقَّقَ الْهَمْزَتَيْنِ مَعًا ، فَكَنَقْطِهِ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ سَهَّلَ الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ . إِلَّا أَنَّهُ تُجْعَلُ فِي مَوْضِعِ الْهَمْزَةِ الْمُسَهَّلَةِ الَّتِي عَلَامَتُهَا نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ فَقَطْ نُقْطَةٌ بِالصَّفْرَاءِ ، وَحَرَكَتُهَا تَحْتَهَا نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ ؛ لِيُؤْذَنَ بِذَلِكَ بِتَحْقِيقِهَا . وَصُورَةُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَمْزَةَ الِاسْتِفْهَامِ هِيَ الْمُصَوَّرَةُ كَمَا
[ ص: 104 ] تَرَى : " أَءِذَا " ، " أَءِلَهٌ " ، " أَءِنَّكَ " ، " أَءِنَّا " . وَصُورَتُهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَمْزَةَ الْأَصْلِ هِيَ الْمُصَوَّرَةُ كَمَا تَرَى : " ءَاِذَا " ، " ءَاِلَهٌ " ، " ءَاِنَّكَ " ، " ءَإِنَّا " . وَتُجْعَلُ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِأَلِفٍ ، أَلِفٌ أَوْ مَطَّةٌ بِالْحَمْرَاءِ ، عَلَى الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا . وَصُورَةُ ذَلِكَ عَلَى الْأَوَّلِ : " أَءِذَا " ، " أَءِلَهٌ " ، " أَءِنَّكَ " ، " أَءِنَّا " . وَعَلَى الثَّانِي : " ءَإِذَا " ، " ءَإِلَهٌ " ، " ءَإِنَّكَ " ، " ءَإِنَّا " .
* * *
فَأَمَّا مَا جَاءَتِ الْهَمْزَةُ الْمُسَهَّلَةُ فِيهِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ ، مَرْسُومَةً يَاءً بِالسَّوَادِ ، كَقَوْلِهِ : " أَئِنَّكُمْ " فِي ( الْأَنْعَامِ ) وَفِي ( النَّمْلِ ) وَفِي الثَّانِي مِنَ ( الْعَنْكَبُوتِ ) وَفِي ( فُصِّلَتْ ) ، وَ " أَئِنَّا " فِي ( النَّمْلِ ) وَ ( الصَّافَّاتِ ) ، وَ " أَئِنَّ لَنَا " فِي ( الشُّعَرَاءِ ) ، وَ " أَئِذَا " فِي ( الْوَاقِعَةِ ) ، وَ " أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ " فِي ( يس ) ، وَ " أَئِفْكًا " فِي ( وَالصَّافَّاتِ ) ؛ فَإِنَّ الْأَلِفَ الْمُصَوَّرَةَ فِي ذَلِكَ هِيَ هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ لَا غَيْرُ ؛ لِأَنَّ الْهَمْزَةَ الْمُسَهَّلَةَ قَدْ صُوِّرَتْ بَعْدَهَا ، عَلَى نَحْوِ حَرَكَتِهَا ، إِعْلَامًا بِتَسْهِيلِهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ يَاءً خَالِصَةً فِي الْحَقِيقَةِ ، فَإِنَّهَا مُقَرَّبَةٌ مِنْهَا . وَالْمُقَرَّبُ مِنَ الشَّيْءِ قَدْ يُحْكَمُ لَهُ بِحُكْمِ الشَّيْءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْهَمْزَةَ الْمَفْتُوحَةَ لَا تُجْعَلُ بَيْنَ بَيْنَ قَبْلَ ضَمَّةٍ أَوْ كَسْرَةٍ ، بَلْ تُبْدَلُ مَعَ الضَّمَّةِ وَاوًا ، وَمَعَ الْكَسْرَةِ يَاءً . وَذَلِكَ أَنَّهَا لَوْ جُعِلَتْ بَيْنَ بَيْنَ لَصَارَتْ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْأَلِفِ . وَالْأَلِفُ لَا يَكُونُ مَا قَبْلَهَا مَضْمُومًا وَلَا مَكْسُورًا . كَذَلِكَ لَا يَكُونُ قَبْلَ مَا قُرِّبَ بِالتَّسْهِيلِ مِنْهَا . فَكَمَا حُكِمَ هَاهُنَا لِلْمُقَرَّبِ
[ ص: 105 ] مِنَ الْأَلِفِ بِحُكْمِ الْأَلِفِ ، فَكَذَلِكَ حُكِمَ هُنَاكَ لِلْهَمْزَةِ الْمَجْعُولَةِ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ فِي الصُّورَةِ حُكْمُ الْيَاءِ الْخَالِصَةِ ، فَصُوِّرَتْ يَاءً .
فَإِذَا نُقِطَ ذَلِكَ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ سَهَّلَ جُعِلَتِ الْهَمْزَةُ نُقْطَةً بِالصَّفْرَاءِ ، وَحَرَكَتُهَا عَلَيْهَا نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ ، عَلَى الْأَلِفِ الْمُصَوَّرَةِ . وَأُعْرِيَتِ الْيَاءُ السَّوْدَاءُ بَعْدَهَا مِنَ الْحَرَكَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَتْ خَلَفًا مِنْ هَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ ، وَلَمْ تَكُنْ يَاءً مَكْسُورَةً خَالِصَةَ الْكَسْرِ . وَمِنْ أَهْلِ النَّقْطِ مَنْ يَجْعَلُ تَحْتَهَا كَسْرَةً ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا دَارَةً صُغْرَى ؛ عَلَامَةً لِتَخْفِيفِهَا ، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُشْبَعَةِ الْكَسْرَةِ ، وَذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيبِ عَلَى الْقَارِئِينَ . وَهُوَ عِنْدِي حَسَنٌ . وَصُورَةُ نَقْطِ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ كَمَا تَرَى : " أَيِنَّكُمْ " ،
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=71أَينَّا ، " أَيِنَّ لَنَا " ، " أَيِفْكًا " ، " أَيِنْ ذُكِّرْتُمْ " . وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي : " أَيِنَّكُمْ " ،
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=71أَيِنَّا ، " أَيِنَّ لَنَا " ، " أَيِفْكًا " ، " أَيِنْ ذُكِّرْتُمْ " .
وَإِنْ نُقِطَ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ حَقَّقَ الْهَمْزَتَيْنِ جُعِلَتِ الْهَمْزَةُ الْأُولَى وَحَرَكَتُهَا فِي الْأَلِفِ ، وَجُعِلَتِ الْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْيَاءِ وَحَرَكَتُهَا تَحْتَهَا . وَصُورَةُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى : " أَئِنَّكُمْ " ، " أَئِنَّا " ، " أَئِنَّ " ، " أَئِفْكًا " ، " أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ " .
وَتُجْعَلُ الْأَلِفُ الْفَاصِلَةُ فِي حَالِ التَّحْقِيقِ وَالتَّسْهِيلِ بَيْنَ الْأَلِفِ وَالْيَاءِ .
فَصْلٌ
وَأَمَّا نَقْطُ الضَّرْبِ الثَّالِثِ مِنَ الْأَضْرُبِ الثَّلَاثَةِ ، عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ سَهَّلَ
[ ص: 106 ] الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ ، وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْهَمْزَةِ الْأُولَى الْمُحَقَّقَةِ بِالْأَلِفِ ؛ فَهُوَ أَنْ تُجْعَلَ نُقْطَةٌ بِالصَّفْرَاءِ ، وَحَرَكَتُهَا عَلَيْهَا نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ ، فِي الْأَلِفِ الْمُصَوَّرَةِ ، وَتُجْعَلَ بَعْدَهَا فِي السَّطْرِ نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ لَا غَيْرُ . فَيُدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى تَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ الْأُولَى ، وَتَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ ، وَأَنَّهُ نُحِيَ بِهَا نَحْوَ الْوَاوِ . وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ الْأَلِفَ الْمُصَوَّرَةَ هَمْزَةَ الِاسْتِفْهَامِ . وَصُورَةُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى : " أَءُنْزِلَ " ، " أَءُلْقِيَ " ، " أَءُشْهِدُوا " .
وَإِنْ شَاءَ النَّاقِطُ جَعَلَ فِي مَوْضِعِ النُّقْطَةِ الْحَمْرَاءِ الَّتِي هِيَ عَلَامَةُ التَّسْهِيلِ وَاوًا صُغْرَى بِالْحَمْرَاءِ ، وَيُعْرِيهَا مِنَ الْحَرَكَةِ ، مِنْ حَيْثُ كَانَتْ خَلَفًا مِنْ هَمْزَةٍ ، وَلَمْ تَكُنْ وَاوًا مُشْبَعَةَ الْحَرَكَةِ ، كَمَا جُعِلَ فِي مَوْضِعِ الْمَكْسُورَةِ الْمُسَهَّلَةِ يَاءٌ . إِذْ قَدْ رَسَمَ كُتَّابِ الْمَصَاحِفِ الْهَمْزَةَ الْمُسَهَّلَةَ وَاوًا بِالسَّوَادِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي ( آلِ عِمْرَانَ ) : " قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم " ، لِيَأْتِيَ الْبَابُ كُلُّهُ عَلَى مَذْهَبٍ وَاحِدٍ مِنَ التَّسْهِيلِ .
وَالْمَذْهَبَ الْأَوَّلَ أَخْتَارُ ؛ لِمَّا قَدَّمْتُهُ قَبْلُ .
فَإِنْ قِيلَ : فَمَا وَجْهُ رَسْمِهِمُ الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ فِي الضَّرْبَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ بِالْحَرْفِ الَّذِي مِنْهُ حَرَكَتُهَا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ ، وَتَرْكِ رَسْمِهِمْ إِيَّاهَا أَصْلًا فِي بَعْضِهَا ؟ قِيلَ : وَجْهُ ذَلِكَ إِرَادَتُهُمُ التَّعْرِيفَ بِالْوَجْهَيْنِ مِنَ التَّحْقِيقِ وَالتَّسْهِيلِ فِي تِلْكَ الْهَمْزَةِ . فَالْمَوْضِعُ الَّذِي جَاءَتِ الْيَاءُ وَالْوَاوُ فِيهِ مَرْسُومَتَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى التَّسْهِيلِ . وَالْمَوْضِعُ الَّذِي جَاءَتَا فِيهِ غَيْرَ مَرْسُومَتَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْقِيقِ . وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ كَرِهُوا أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ صُورَتَيْنِ مُتَّفِقَتَيْنِ ، فَلِذَلِكَ حَذَفُوا إِحْدَى الصُّورَتَيْنِ ، وَاكْتَفَوْا بِالْوَاحِدَةِ مِنْهُمَا إِيجَازًا وَاخْتِصَارًا .
[ ص: 107 ] وَمَنْ جَعَلَ الْأَلِفَ الْمُصَوَّرَةَ هَمْزَةَ الْقَطْعِ جَعَلَ النُّقْطَةَ بِالصَّفْرَاءِ ، وَحَرَكَتُهَا عَلَيْهَا ، قَبْلَ الْأَلِفِ . وَجَعَلَ فِي الْأَلِفِ أَوْ أَمَامَهَا النُّقْطَةَ بِالْحَمْرَاءِ ، وَصُورَةُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى : " ءَاُنْزِلَ " ، " ءَاُلْقِيَ " ، " ءَاُشْهِدُوا " . وَجَعَلَ بَيْنَ الْهَمْزَةِ الْمُحَقَّقَةِ وَبَيْنَ الْهَمْزَةِ الْمُلَيَّنَةِ ، فِي مَذْهَبِ مَنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِأَلِفٍ ، أَلِفًا بِالْحَمْرَاءِ ، أَوْ مَطَّةً فِي مَوْضِعِهَا . وَصُورَةُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ هَمْزَةَ الِاسْتِفْهَامِ هِيَ الْمُصَوَّرَةَ كَمَا تَرَى : " أَءُنْزِلَ " ، " أَءُلْقِيَ " ، " أَءُشْهِدُوا " . وَصُورَتُهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ هَمْزَةَ الْقَطْعِ هِيَ الْمُصَوَّرَةَ كَمَا تَرَى : " ءَاُنْزِلَ " ، " ءَاُلْقِيَ " ، " ءَاُشْهِدُوا " .
فَأَمَّا نَقْطُ هَذَا الضَّرْبِ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ حَقَّقَ الْهَمْزَتَيْنِ مَعًا فَكَنَقْطِهِ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ سَهَّلَ الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ ، غَيْرَ أَنَّهُ يَجْعَلُ فِي مَكَانِ الْهَمْزَةِ الْمُسَهَّلَةِ الَّتِي عَلَامَتُهَا نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ فَقَطْ ، نُقْطَةٌ بِالصَّفْرَاءِ ، وَحَرَكَتُهَا نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ أَمَامَهَا . وَصُورَةُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي تُجْعَلُ فِيهِ هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ هِيَ الْمُصَوَّرَةَ كَمَا تَرَى : " أَءُنْزِلَ " ، " أَءُلْقِيَ " . وَعَلَى الْقَوْلِ الَّذِي تُجْعَلُ فِيهِ هَمْزَةُ الْقَطْعِ هِيَ الْمُصَوَّرَةُ كَمَا تَرَى : " ءَأُنْزِلَ " ، " ءَاُلْقِيَ " . وَتُجْعَلُ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِأَلِفٍ ، أَلِفٌ أَوْ مَطَّةٌ بِالْحَمْرَاءِ . وَصُورَةُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ : " أَءُنْزِلَ " ، " أَءُلْقِيَ " . وَعَلَى الثَّانِي : " ءَأُنْزِلَ " ، " ءَأُلْقِيَ " .
* * *
فَأَمَّا الْمَوْضِعُ الَّذِي رُسِمَتْ فِيهِ الْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ وَاوًا ، عَلَى مُرَادِ التَّسْهِيلِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي ( آلِ عِمْرَانَ ) : " قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ " فَإِنَّ الْأَلِفَ الْمُصَوَّرَةَ قَبْلَهَا هِيَ هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ لَا غَيْرُ . وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ صَوَّرُوا الْهَمْزَةَ الثَّانِيَةَ بِالْحَرْفِ الَّذِي مِنْهُ حَرَكَتُهَا .
فَإِذَا نُقِطَ ذَلِكَ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ سَهَّلَ ؛ جُعِلَتِ الْهَمْزَةُ نُقْطَةً بِالصَّفْرَاءِ ، وَحَرَكَتُهَا
[ ص: 108 ] عَلَيْهَا نُقْطَةٌ بِالْحَمْرَاءِ فِي الْأَلِفِ ، وَأُعْرِيَتِ الْوَاوُ بَعْدَهَا مِنَ الْحَرَكَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاوٍ مُشْبَعَةِ الْحَرَكَةِ ، وَإِنَّمَا هِيَ خَلَفٌ مِنْ هَمْزَةٍ مَضْمُومَةٍ . وَصُورَةُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى : " أَؤُنَبِّئُكُمْ " . وَمِنْ أَهْلِ النَّقْطِ مَنْ يَجْعَلُ أَمَامَ الْوَاوِ نُقْطَةً ، وَعَلَى الْوَاوِ دَارَةً ؛ عَلَامَةً لِتَخْفِيفِهَا . وَهُوَ وَجْهٌ . وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ . وَصُورَةُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى : " أَوُنَبِّئُكُمْ " .
وَإِنْ نُقِطَ ذَلِكَ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ حَقَّقَ الْهَمْزَتَيْنِ جُعِلَتِ الْهَمْزَةُ الْأُولَى وَحَرَكَتُهَا عَلَى الْأَلِفِ ، وَجُعِلَتِ الْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْوَاوِ وَحَرَكَتُهَا أَمَامَهَا . وَصُورَةُ ذَلِكَ كَمَا تَرَى : " أَؤُنَبِّئُكُمْ " .
وَتُجْعَلُ الْأَلِفُ الْفَاصِلَةُ - فِي مَذْهَبِ مَنْ سَهَّلَ ، أَوْ حَقَّقَ - بَيْنَ الْأَلِفِ وَالْوَاوِ . وَصُورَةُ ذَلِكَ فِي التَّسْهِيلِ : " أَوُنَبِّئُكُمْ " ، وَفِي التَّحْقِيقِ : " أَؤُنَبِّئُكُمْ " .
* * *
مَا وَرَدَ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ وَالَّذِي قَبْلَهُ مَرْسُومًا بِالْوَاوِ وَالْيَاءِ ، بَعْدَ الْأَلِفِ الْمُصَوَّرَةِ ، فَهُوَ عَلَى مُرَادِ التَّسْهِيلِ ، وَتَقْدِيرِ الِاتِّصَالِ . وَمَا وَرَدَ فِيهِمَا مَرْسُومًا بِغَيْرِهِمَا فَهُوَ عَلَى مُرَادِ التَّحْقِيقِ ، وَتَقْدِيرِ الِانْفِصَالِ . إِلَّا أَنَّ إِحْدَى الْأَلِفَيْنِ حُذِفَتِ اخْتِصَارًا لِمَا قَدَّمْنَاهُ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ النَّقْطِ فِي جَعْلِ الْهَمْزَةِ الْمُحَقَّقَةِ فِي الْأَلِفِ وَالْيَاءِ وَالْوَاوِ ، إِذَا كُنَّ صُوَرًا لَهَا . فَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهَا فِي أَنْفُسِ هَذِهِ الْحُرُوفِ ، وَيَجْعَلُ حَرَكَةَ الْمَفْتُوحَةِ فَوْقَ الْأَلِفِ إِنْ صُوِّرَتْ أَلِفًا ، وَحَرَكَةَ الْمَكْسُورَةِ تَحْتَ الْيَاءِ إِنْ صُوِّرَتْ يَاءً ، وَحَرَكَةَ الْمَضْمُومَةِ أَمَامَ الْوَاوِ إِنْ صُوِّرَتْ وَاوًا . وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَالِفُ بِهَا ، فَيَجْعَلُ الْمَفْتُوحَةَ وَحَرَكَتَهَا عَلَى الْأَلِفِ ، وَالْمَكْسُورَةَ وَحَرَكَتَهَا تَحْتَ الْيَاءِ ، وَالْمَضْمُومَةَ
[ ص: 109 ] وَحَرَكَتَهَا فِي الْوَاوِ ؛ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَبَيْنَ حَرَكَتِهَا ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ، كَمَا لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ سَائِرِ الْحُرُوفِ وَبَيْنَ حَرَكَاتِهِنَّ .
وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَوْجَهُ . وَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ كَانَتِ الْهَمْزَةُ حَرْفًا مِنْ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ . فَكَمَا تَلْزَمُ الْحُرُوفُ غَيْرُهَا مَوْضِعًا وَاحِدًا مِنَ السَّطْرِ ؛ كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَ الْهَمْزَةُ أَيْضًا مَوْضِعًا وَاحِدًا ، وَأَنْ تُجْعَلَ لَهَا فِي الْكِتَابَةِ صُورَةٌ . وَتَكُونُ الْحَرَكَاتُ دَالَّةً عَلَى مَا تَسْتَحِقُّهُ مِنْهُنَّ ، كَمَا تَدُلُّ عَلَى سَائِرِ الْحُرُوفِ .
وَإِنِ اكْتَفَى النَّاقِطُ فِي الْهَمَزَاتِ الْمُبْتَدَءَاتِ وَالْمُتَوَسِّطَاتِ بِجَعْلِ الْهَمْزَةِ وَحْدَهَا دُونَ حَرَكَتِهَا ، مِنْ حَيْثُ كَانَتْ حَرَكَةَ بِنَاءٍ لَازِمَةً ؛ فَحَسَنٌ . وَأَمَّا الْهَمَزَاتُ الْمُتَطَرِّفَاتُ فَلَا بُدَّ مِنْ جَعْلِ الْحَرَكَةِ مَعَهُنَّ ، مِنْ حَيْثُ كَانَتْ حَرَكَةَ إِعْرَابٍ تَتَغَيَّرُ وَتَنْتَقِلُ . فَاعْلَمْ ذَلِكَ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .


 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية موسوعة التربية
موسوعة التربية كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام






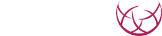








 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات