nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=7إن ربك هو أعلم وعيد للضال ، وهم المجانين على الحقيقة ، حيث كانت لهم عقول لم ينتفعوا بها ، ولا استعملوها فيما جاءت به الرسل ، أو يكون ( أعلم ) كناية عن جزاء الفريقين . فلا تطع المكذبين أي : الذين كذبوا بما أنزل الله عليك من الوحي ، وهذا نهي عن طواعيتهم في شيء مما دعوه إليه من تعظيم آلهتهم . ودوا لو تدهن " لو " هنا على رأي البصريين مصدرية بمعنى ( أن ) أي ودوا ادهانكم ، وتقدم الكلام في ذلك في قوله - تعالى - : يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ومذهب الجمهور أن معمول " ود " محذوف ، أي ودوا ادهانكم ، وحذف لدلالة ما بعده عليه ، و ( لو ) باقية على بابها من كونها حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره ، وجوابها محذوف تقديره لسروا بذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والضحاك وعطية والسدي : " لو تدهن " لو تكفر ، فيتمادون على كفرهم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا : لو ترخص لهم فيرخصون لك . وقال
قتادة : لو تذهب عن هذا الأمر فيذهبون معك . وقال
الحسن : لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم : لو تنافق وترائي فينافقونك ويراؤونك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس : لو تكذب فيكذبون . وقال
أبو جعفر : لو تضعف فيضعفون . وقال
الكلبي nindex.php?page=showalam&ids=14888والفراء : لو تلين فيلينون . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن ثعلب : لو تحابي فيحابون ، وقالوا غير هذه الأقوال . وقال
الفراء : " الدهان " التليين . وقال المفضل : النفاق وترك المناصحة ، وهذا نقل أهل اللغة ، وما قالوه لا يخرج عن ذلك ; لأن ما خالف ذلك هو تفسير باللازم ، و " فيدهنون " عطف على " تدهن " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : عدل به إلى طريق آخر ، وهو أن جعل خبر مبتدأ محذوف ، أي فهم يدهنون كقوله : فمن يؤمن بربه فلا يخاف بمعنى ودوا لو تدهن فهم يدهنون حينئذ ، أو ودوا ادهانك فهم الآن يدهنون لطمعهم في ادهانك . انتهى . وجمهور المصاحف على إثبات النون . وقال
هارون : إنه في بعض المصاحف فيدهنوا ، ولنصبه وجهان : أحدهما أنه جواب " ودوا " لتضمنه معنى ليت ، والثاني أنه على توهم أنه نطق بأن ، أي ودوا أن تدهن فيدهنوا ، فيكون عطفا على التوهم ، ولا يجيء هذا الوجه إلا على قول من جعل لو مصدرية بمعنى أن .
nindex.php?page=treesubj&link=29039ولا تطع كل حلاف مهين . تقدم تفسير مهين وما بعده في المفردات ، وجاءت هذه الصفات صفات مبالغة ، ونوسب فيها فجاء ( حلاف ) وبعده ( مهين ) لأن النون فيها مع الميم تواخ ، ثم جاء : هماز مشاء بنميم بصفتي
[ ص: 310 ] المبالغة ، ثم جاء : مناع للخير معتد أثيم فمناع وأثيم صفتا مبالغة ، والظاهر أن الخير هنا يراد به العموم فيما يطلق عليه خير . وقيل : الخير هنا المال ، يريد ( مناع ) للمال عبر به عن الشح ، معناه : متجاوز الحد في الظلم . وفي حديث شداد بن أوس قلت : يعني لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم .
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374962وما العتل الزنيم ؟ قال : الرحيب الجوف ، الوتير الخلق ، الأكول الشروب ، الغشوم الظلوم . وقرأ
الحسن : عتل برفع اللام ، والجمهور بجرها بعد ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : جعل جفاءه ودعوته أشد معايبه ; لأنه إذا جفا وغلظ طبعه قسا قلبه ، واجترأ على كل معصية ; ولأن الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الناشئ منها ، ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374963لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده . وبعد ذلك نظير ثم في قوله : ثم كان من الذين آمنوا . وقرأ
الحسن : " عتل " رفعا على الذم ، وهذه القراءة تقوية لما يدل عليه بعد ذلك . انتهى . وقال
ابن عطية : بعد ذلك أي : بعد أن وصفناه به ، فهذا الترتيب إنما هو في قول الواصف لا في حصول تلك الصفات في الموصوف ، وإلا فكونه عتلا هو قبل كونه صاحب خير يمنعه . انتهى . و " الزنيم " : الملصق في القوم وليس منهم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره . وقيل : الزنيم ، المريب القبيح الأفعال ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا : الزنيم الذي له زنمة في عنقه كزنمة الشاة ، وما كنا نعرف المشار إليه حتى نزلت فعرفناه بزنمته . انتهى . وروي أن
الأخفش بن شريف كان بهذه الصفة ، كان له زنمة . وروى
ابن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الزنيم هو الذي يعرف بالشر ، كما تعرف الشاة بالزنمة . وعنه أيضا : أنه المعروف بالأبنة . وعنه أيضا : أنه الظلوم . وعن
عكرمة : هو اللئيم . وعن
مجاهد وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب : أنه ولد الزنا الملحق في النسب بالقوم ، وكان الوليد دعيا في
قريش ليس من منحهم ، ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة من مولده . وقال
مجاهد : كانت له ستة أصابع في يده ، في كل إبهام أصبع زائدة ، والذي يظهر أن هذه الأوصاف ليست لمعين . ألا ترى إلى قوله : كل حلاف وقوله : إنا بلوناهم ؟ فإنما وقع النهي عن طواعية من هو بهذه الصفات .
قال
ابن عطية ما ملخصه ، قرأ النحويان والحرميان و حفص و أهل المدينة : أن كان على الخبر ; وباقي السبعة
والحسن وابن أبي إسحاق وأبو جعفر : على الاستفهام . وحقق الهمزتين
حمزة ، وسهل الثانية باقيهم . فأما على الخبر ، فقال
أبو علي الفارسي : يجوز أن يعمل فيها " عتل " وإن كان قد وصف . انتهى ، وهذا قول كوفي ، ولا يجوز ذلك عند البصريين . وقيل : ( زنيم ) لا سيما على قول من فسره بالقبيح الأفعال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : متعلق بقوله : ولا تطع يعني ولا تطعه مع هذه المثالب ، لـ أن كان ذا مال أي : ليساره وحظه من الدنيا ، ويجوز أن يتعلق بما بعده على معنى لكونه متمولا مستظهرا بالبنين ، كذب آياتنا ولا يعمل فيه ، قال الذي هو جواب إذا ; لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله ، ولكن ما دلت عليه الجملة من معنى التكذيب . انتهى . وأما على الاستفهام ، فيحتمل أن يفسر عامل يدل عليه ما قبله ، أي : أيكون طواعية لأن كان ؟ وقدره
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : أتطيعه لأن كان ؟ أو عامل يدل عليه ما قبله ، أي : أكذب أو جحد لأن كان ؟ وقرأ
نافع في رواية اليزيدي عنه : إن كان بكسر الهمزة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : والشرط للمخاطب ، أي : لا تطع كل حلاف شارطا يساره ; لأنه إذا أطاع الكافر لغناه ، فكأنه اشترط في الطاعة الغنى ، ونحو صرف الشرط إلى المخاطب صرف الرجاء إليه في قوله : لعله يذكر . انتهى . وأقوال : أن كان شرط ، و إذا تتلى شرط ، فهو مما اجتمع فيه شرطان ، وليسا من الشروط المترتبة الوقوع ، فالمتأخر لفظا هو المتقدم ، والمتقدم لفظا هو شرط في الثاني ، كقوله :
فإن عثرت بعدها إن وألت نفسي من هاتا فقولا لا لا
لأن الحامل على ترك تدبر آيات الله كونه ذا مال وبنين ، فهو مشغول القلب ، فذلك غافل عن النظر
[ ص: 311 ] والفكر ، قد استولت عليه الدنيا وأبطرته . وقرأ
الحسن : أئذا على الاستفهام ، وهو استفهام تقريع وتوبيخ على قوله : القرآن أساطير الأولين ، لما تليت عليه آيات الله . ولما ذكر قبائح أفعاله وأقواله ، ذكر ما يفعل به على سبيل التوعد ، فقال : سنسمه على الخرطوم والسمة : العلامة . ولما كان الوجه أشرف ما في الإنسان ، والأنف أكرم ما في الوجه لتقدمه ، ولذلك جعلوه مكان العز والحمية ، واشتقوا منه الأنفة ، وقالوا : حمي الأنف شامخ العرنين . وقالوا في الذليل : جدع أنفه ، ورغم أنفه . وكان أيضا مما تظهر السمات فيه لعلو ، قال : سنسمه على الخرطوم وهو غاية الإذلال والإهانة والاستبلاد ، إذ صار كالبهيمة لا يملك الدفع عن وسمه في الأنف ، وإذا كان الوسم في الوجه شينا ، فكيف به على أكرم عضو فيه ؟ وقد قيل : الجمال في الأنف ، وقال بعض الأدباء :
وحسن الفتى في الأنف والأنف عاطل فكيف إذا ما الخال كان له حليا
وسنسمه فعل مستقبل لم يتعين زمانه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هو الضرب بالسيف ، أي : يضرب به وجهه وعلى أنفه ، فيجيء ذلك كالوسم على الأنف ، وحل به ذلك يوم بدر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد : ذلك في عذاب الآخرة في جهنم ، وهو تعذيب بنار على أنوفهم . وقال آخرون : ذلك يوم القيامة ، أي : نوسم على أنفه بسمة يعرف بها كفره وانحطاط قدره . وقال
قتادة وغيره : معناه سنفعل به في الدنيا من الذم والمقت والاشتهار بالشر ما يبقى فيه ولا يخفى به ، فيكون ذلك كالوسم على الأنف ثابتا بينا ، كما تقول : سأطوقك طوق الحمامة ، أي : أثبت لك الأمر بينا فيك ، ونحو هذا أراد
جرير بقوله :
لما وضعت على الفرزدق ميسمي
وفي الوسم على الأنف تشويه ، فجاءت استعارته في المذمات بليغة جدا . قال
ابن عطية : وإذا تأملت حال
أبي جهل ونظرائه ، وما ثبت لهم في الدنيا من سوء الأخروية ، رأيت أنهم قد وسموا على الخراطيم . انتهى . وقال
أبو العالية ومقاتل ، واختاره
الفراء : يسود وجهه قبل دخول النار ، وذكر الخرطوم ، والمراد الوجه ; لأن بعض الوجه يؤدي عن بعض . وقال
أبو عبد الله الرازي : إنما بالغ الكافر في عداوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بسبب الأنفة والحمية ، فلما كان شاهد الإنكار هو الأنفة والحمية ، عبر عن هذا الاختصاص بقوله : سنسمه على الخرطوم . انتهى كلامه . وفي استعارة الخرطوم مكان الأنف استهانة واستخفاف ; لأن حقيقة الخرطوم هو للسباع . وتلخص من هذا أن قوله : سنسمه على الخرطوم أهو حقيقة أم مجاز ؟ وإذا كان حقيقة ، فهل ذلك في الدنيا أو في الآخرة ؟ وأبعد النضر بن شميل في تفسيره الخرطوم بالخمر ، وأن معناه سنحده على شربها .
ولما ذكر المتصف بتلك الأوصاف الذميمة ، وهم كفار
قريش ، أخبر - تعالى - بما حل بهم من الابتلاء بالقحط والجوع بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374730اللهم اشدد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف الحديث . كما بلونا أصحاب الجنة المعروف خبرها عندهم . كانت بأرض
اليمن صنعاء لرجل كان يؤدي حق الله منها ، فمات فصارت إلى ولده ، فمنعوا الناس خيرها وبخلوا بحق الله تعالى ، فأهلكها الله - تعالى - من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بهم . وقيل : كانت بصوران على فراسخ من صنعاء لناس بعد رفع
عيسى - عليه السلام ، وكان صاحبها ينزل للمساكين ما أخطأه المنجل ، وما في أسفل الأكراس ، وما أخطاه القطاف من العنب ، وما بقي على السباط تحت النخلة إذا صرمت ، فكان يجتمع لهم شيء كثير ، فلما مات قال بنوه : إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر ونحن أولو عيال ، فحلفوا ليصرمنها مصبحين في السدف خفية من المساكين ، ولم يستثنوا في يمينهم . و " الكاف " في كما بلونا في موضع نصب ، و " ما " مصدرية . وقيل : بمعنى
[ ص: 312 ] الذي ، وإذ معمول لبلوناهم " ليصرمنها " جواب القسم لا على منطوقهم ، إذ لو كان على منطوقهم لكان لنصرمنها بنون المتكلمين ، والمعنى : ليجدن ثمرها إذا دخلوا في الصباح قبل خروج المساكين إلى عادتهم مع أبيهم . ولا يستثنون أي : ولا ينثنون عن ما عزموا عليه من منع المساكين . وقال
مجاهد : معناه : لا يقولون إن شاء الله ، بل عزموا على ذلك عزم من يملك أمره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ، متبعا قول
مجاهد : ولا يقولون إن شاء الله . ( فإن قلت ) لم سمي استثناء ، وإنما هو شرط ؟ ( قلت ) : لأنه يؤدي مؤدى الاستثناء من حيث أن معنى قولك : لأخرجن إن شاء الله ، ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد . انتهى .
فطاف عليها طائف قرأ النخعي : طيف . قال
الفراء : والطائف الأمر الذي يأتي بالليل ، ورد عليه بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=201إذا مسهم طائف من الشيطان فلم يتخصص بالليل ، وطائف مبهم . فقيل : هو
جبريل - عليه السلام - اقتلعها وطاف بها حول البيت ، ثم وضعها حيث مدينة الطائف اليوم ، ولذلك سميت بالطائف ، وليس في أرض
الحجاز بلدة فيها الماء والشجر والأعناب غيرها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : طائف من أمر ربك . وقال
قتادة : عذاب من ربك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : عنق خرج من وادي جهنم . فأصبحت كالصريم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كالرماد الأسود ، والصريم : الرماد الأسود بلغة خزيمة ، وعنه أيضا : الصريم رملة باليمن معروفة لا تنبت ، فشبه جنتهم بها . وقال
الحسن : صرم عنها الخير ، أي قطع . فالصريم بمعنى مصروم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : كالصبح من حيث ابيضت كالزرع المحصود . وقال
مؤرج : كالرملة انصرمت من معظم الرمل ، والرملة لا تنبت شيئا ينفع . وقال
الأخفش : كالصبح انصرم من الليل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد : كالنهار فلا شيء فيها . وقال
شمر : الصريم : الليل ، والصريم : النهار ، أي : ينصرم هذا عن ذاك ، وذاك عن هذا . وقال
الفراء والقاضي
nindex.php?page=showalam&ids=17150منذر بن سعيد وجماعة : الصريم الليل من حيث اسودت جنتهم . ( فتنادوا ) دعا بعضهم بعضا إلى المضي إلى ميعادهم أن اغدوا على حرثكم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : ( فإن قلت ) هلا قيل اغدوا إلى حرثكم وما معنى على ؟ ( قلت ) : لما كان الغدو إليه ليصرموه ويقطعوه كان غدوا عليه ، كما تقول : غدا عليهم العدو . ويجوز أن يضمن الغد ومعنى الإقبال ، كقولهم : يغدى عليه بالجفنة ويراح ، أي : فأقبلوا على حرثكم باكرين . انتهى . واستسلف
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري أن غدا يتعدى بإلى ، ويحتاج ذلك إلى نقل بحيث يكثر ذلك ، فيصير أصلا فيه ويتأول ما خالفه ، والذي في حفظي أنه معدى بعلى ، كقول الشاعر :
بكرت عليه غدوة فرأيته قعودا عليه بالصريم عوادله
إن كنتم صارمين الظاهر أنه من صرام النخل . قيل : ويحتمل أن يريد : إن كنتم أهل عزم وإقدام على رأيكم ، من قولك سيف صارم . ( يتخافتون ) يخفون كلامهم خوفا من أن يشعر بهم المساكين . أن لا يدخلنها أي : يتخافتون بهذا الكلام وهو لا يدخلنها ، و " أن " مصدرية ، ويجوز أن تكون تفسيرية . وقرأ
عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=12356وابن أبي عبلة : لا يدخلنها ، بإسقاط أن على إضمار يقولون ، أو على إجراء " يتخافتون " مجرى القول ، إذ معناه : يسارون القول ، والنهي عن الدخول نهي عن التمكين منه ، أي لا تمكنوهم من الدخول فيدخلوا . وغدوا على حرد قادرين أي : على قصد وقدرة في أنفسهم ، يظنون أنهم تمكنوا من مرادهم . قال معناه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أي : قاصدين إلى جنتهم بسرعة ، قادرين عند أنفسهم على صرامها . قال
أبو عبيدة والقتبي : على حرد على منع ، أي : قادرين في أنفسهم على منع المساكين من خيرها ، فجزاهم الله بأن منعهم خيرا . وقال
الحسن : على حرد أي : حاجة وفاقة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي وسفيان : على حرد على غضب ، أي : لم يقدروا إلا على حنق وغضب بعضهم على بعض . وقيل : على حرد : على انفراد
[ ص: 313 ] أي : انفردوا دون المساكين . وقال
الأزهري : " حرد " اسم قريتهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : اسم جنتهم ، أي : غدوا على تلك الجنة قادرين على صرامها عند أنفسهم ، أو مقدرين أن يتم لهم مرادهم من الصرام . قيل : ويحتمل أن يكون من التقدير بمعنى التضييق ; لقوله تعالى : ومن قدر عليه رزقه أي : مضيقين على المساكين ، إذ حرموهم ما كان أبوهم ينيلهم منها . فلما رأوها أي : على الحالة التي كانوا غدوها عليها ، من هلاكها وذهاب ما فيها من الخير قالوا إنا لضالون أي : عن الطريق إليها ، قاله قتادة . وذلك في أول وصولهم أنكروا أنها هي ، واعتقدوا أنهم أخطأوا الطريق إليها ، ثم وضح لهم أنها هي ، وأنه أصابها من عذاب الله ما أذهب خيرها . وقيل : لضالون عن الصواب في غدونا على نية منع المساكين ، فقالوا : بل نحن محرومون خيرها بخيانتنا على أنفسنا .
قال أوسطهم أي : أفضلهم وأرجحهم عقلا ألم أقل لكم لولا تسبحون أنبهم ووبخهم على تركهم ما حضهم عليه من تسبيح الله ، أي ذكره وتنزيهه عن السوء ، ولو ذكروا الله وإحسانه إليهم لامتثلوا ما أمر به من مواساة المساكين ، واقتفوا سنة أبيهم في ذلك . فلما غفلوا عن ذكر الله - تعالى - وعزموا على منع المساكين ، ابتلاهم الله ، وهذا يدل على أن أوسطهم كان قد تقدم إليهم وحرضهم على ذكر الله تعالى . وقال
مجاهد وأبو صالح : كان استثناؤهم سبحان الله . قال
النحاس : جعل
مجاهد التسبيح موضع إن شاء الله ; لأن المعنى تنزيه الله أن يكون شيء إلا بمشيئته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : لالتقائهما في معنى التعظيم لله ; لأن الاستثناء تفويض إليه ، والتسبيح تنزيه له ، وكل واحد من التفويض والتنزيه تعظيم له . وقيل : لولا تسبحون : تستغفرون . ولما أنبهم ، رجعوا إلى ذكر الله تعالى ، واعترفوا على أنفسهم بالظلم ، وبادروا إلى تسبيح الله تعالى ، فقالوا : سبحان ربنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أي : نستغفر الله من ذنبنا . ولما أقروا بظلمهم ، لام بعضهم بعضا ، وجعل اللوم في حيز غيره ، إذ كان منهم من زين ، ومنهم من قبل ، ومنهم من أمر بالكف ، ومنهم من عصى الأمر ، ومنهم من سكت على رضا منه . ثم اعترفوا بأنهم طغوا ، وترجوا انتظار الفرج في أن يبدلهم خيرا من تلك الجنة عسى ربنا أن يبدلنا أي : بهذه الجنة خيرا منها . وتقدم الكلام في الكهف ، والخلاف في تخفيف يبدلنا ، وتثقيلها منسوبا إلى القراء .
إنا إلى ربنا راغبون أي : طالبون إيصال الخير إلينا منه . والظاهر أن أصحاب هذه الجنة كانوا مؤمنين أصابوا معصية وتابوا . وقيل : كانوا من أهل الكتاب . وقال عبد الله بن مسعود : بلغني أن القوم دعوا الله وأخلصوا ، وعلم الله منهم الصدق فأبدلهم بها جنة ، وكل عنقود منها كالرجل الأسود القائم . وعن
مجاهد : تابوا فأبدلوا خيرا منها . وقال
القشيري : المعظم يقولون أنهم تابوا وأخلصوا . انتهى . وتوقف
الحسن في كونهم مؤمنين وقال : أكان قولهم : إنا إلى ربنا راغبون إيمانا ، أو على حد ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة ؟ .
كذلك العذاب . هذا خطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - في أمر
قريش . قال
ابن عطية : والإشارة بذلك إلى العذاب الذي نزل بالجنة ، أي كذلك العذاب أي : الذي نزل
بقريش بغتة ، ثم عذاب الآخرة بعد ذلك أشد عليهم من عذاب الدنيا . وقال كثير من المفسرين : العذاب النازل بقريش المماثل لأمر الجنة ، هو الجدب الذي أصابهم سبع سنين حتى رأوا الدخان وأكلوا الجلود . انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل مكة وأصحاب الجنة عذاب الدنيا . ولعذاب الآخرة أشد وأعظم منه . انتهى . وتشبيه بلاء
قريش ببلاء أصحاب الجنة ، هو أن أصحاب الجنة عزموا على الانتفاع بثمرها وحرمان المساكين ، فقلب الله - تعالى - عليهم وحرمهم . وأن
قريشا حين خرجوا إلى بدر حلفوا على قتل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، فإذا فعلوا
[ ص: 314 ] ذلك رجعوا إلى مكة وطافوا بالكعبة وشربوا الخمور ، فقلب الله عليهم بأن قتلوا وأسروا . ولما عذبهم بذلك في الدنيا قال : ولعذاب الآخرة أكبر .
nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=7إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ وَعِيدٌ لِلضَّالِّ ، وَهُمُ الْمَجَانِينُ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، حَيْثُ كَانَتْ لَهُمْ عُقُولٌ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِهَا ، وَلَا اسْتَعْمَلُوهَا فِيمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ ، أَوْ يَكُونُ ( أَعْلَمُ ) كِنَايَةً عَنْ جَزَاءِ الْفَرِيقَيْنِ . فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ أَيِ : الَّذِينَ كَذَّبُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الْوَحْيِ ، وَهَذَا نَهْيٌ عَنْ طَوَاعِيَتِهِمْ فِي شَيْءٍ مِمَّا دَعَوْهُ إِلَيْهِ مِنْ تَعْظِيمِ آلِهَتِهِمْ . وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ " لَوْ " هُنَا عَلَى رَأْيِ الْبَصْرِيِّينَ مَصْدَرِيَّةٌ بِمَعْنَى ( أَنْ ) أَيْ وَدُّوا ادِّهَانَكُمْ ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - : يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ مَعْمُولَ " وَدَّ " مَحْذُوفٌ ، أَيْ وَدُّوا ادِّهَانَكُمْ ، وَحُذِفَ لِدَلَالَةِ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ ، وَ ( لَوْ ) بَاقِيَةٌ عَلَى بَابِهَا مِنْ كَوْنِهَا حَرْفًا لَمَا كَانَ سَيَقَعُ لِوُقُوعِ غَيْرِهِ ، وَجَوَابُهَا مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ لَسُرُّوا بِذَلِكَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكُ وَعَطِيَّةُ وَالسُّدِّيُّ : " لَوْ تُدْهِنُ " لَوْ تَكْفُرُ ، فَيَتَمَادَوْنَ عَلَى كُفْرِهِمْ . وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا : لَوْ تُرَخِّصُ لَهُمْ فَيُرَخِّصُونَ لَكَ . وَقَالَ
قَتَادَةُ : لَوْ تَذْهَبُ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ فَيَذْهَبُونَ مَعَكَ . وَقَالَ
الْحَسَنُ : لَوْ تُصَانِعُهُمْ فِي دِينِكَ فَيُصَانِعُونَكَ فِي دِينِهِمْ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ : لَوْ تُنَافِقُ وَتُرَائِي فَيُنَافِقُونَكَ وَيُرَاؤُونَكَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14354الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ : لَوْ تَكْذِبُ فَيَكْذِبُونَ . وَقَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : لَوْ تَضْعُفُ فَيَضْعُفُونَ . وَقَالَ
الْكَلْبِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14888وَالْفَرَّاءُ : لَوْ تَلِينُ فَيَلِينُونَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11793أَبَانُ بْنُ ثَعْلَبٍ : لَوْ تُحَابِي فَيُحَابُونَ ، وَقَالُوا غَيْرَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ . وَقَالَ
الْفَرَّاءُ : " الدِّهَانُ " التَّلْيِينُ . وَقَالَ الْمُفَضَّلُ : النِّفَاقُ وَتَرْكُ الْمُنَاصَحَةِ ، وَهَذَا نَقْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ ، وَمَا قَالُوهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّ مَا خَالَفَ ذَلِكَ هُوَ تَفْسِيرٌ بِاللَّازِمِ ، وَ " فَيُدْهِنُونَ " عَطْفٌ عَلَى " تُدْهِنُ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : عَدَلَ بِهِ إِلَى طَرِيقٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنْ جُعِلَ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ، أَيْ فَهُمْ يُدْهِنُونَ كَقَوْلِهِ : فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بِمَعْنَى وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَهُمْ يُدْهِنُونَ حِينَئِذٍ ، أَوْ وَدُّوا ادِّهَانَكَ فَهُمُ الْآنَ يُدْهِنُونَ لِطَمَعِهِمْ فِي ادِّهَانِكَ . انْتَهَى . وَجُمْهُورُ الْمَصَاحِفِ عَلَى إِثْبَاتِ النُّونِ . وَقَالَ
هَارُونُ : إِنَّهُ فِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ فَيُدْهِنُوا ، وَلْنَصْبِهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ جَوَابُ " وَدُّوا " لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى لَيْتَ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّهُ نَطَقَ بِأَنْ ، أَيْ وَدُّوا أَنْ تُدْهِنَ فَيُدْهِنُوا ، فَيَكُونُ عَطْفًا عَلَى التَّوَهُّمِ ، وَلَا يَجِيءُ هَذَا الْوَجْهُ إِلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ لَوْ مَصْدَرِيَّةً بِمَعْنَى أَنْ .
nindex.php?page=treesubj&link=29039وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ . تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ مَهِينٍ وَمَا بَعْدَهُ فِي الْمُفْرَدَاتِ ، وَجَاءَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ صِفَاتَ مُبَالَغَةٍ ، وَنُوسِبَ فِيهَا فَجَاءَ ( حَلَّافٍ ) وَبَعْدَهُ ( مَهِينٍ ) لِأَنَّ النُّونَ فِيهَا مَعَ الْمِيمِ تَوَاخٍ ، ثُمَّ جَاءَ : هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ بِصِفَتَيِ
[ ص: 310 ] الْمُبَالَغَةِ ، ثُمَّ جَاءَ : مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ فَمَنَّاعٌ وَأَثِيمٌ صِفَتَا مُبَالَغَةٍ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخَيْرَ هُنَا يُرَادُ بِهِ الْعُمُومُ فِيمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ خَيْرٌ . وَقِيلَ : الْخَيْرُ هُنَا الْمَالُ ، يُرِيدُ ( مَنَّاعٍ ) لِلْمَالِ عَبَّرَ بِهِ عَنِ الشُّحِّ ، مَعْنَاهُ : مُتَجَاوِزُ الْحَدِّ فِي الظُّلْمِ . وَفِي حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قُلْتُ : يَعْنِي لِرَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374962وَمَا الْعُتُلُّ الزَّنِيمُ ؟ قَالَ : الرَّحِيبُ الْجَوْفُ ، الْوَتِيرُ الْخَلْقِ ، الْأَكُولُ الشَّرُوبُ ، الْغَشُومُ الظَّلُومُ . وَقَرَأَ
الْحَسَنُ : عُتُلٌّ بِرَفْعِ اللَّامِ ، وَالْجُمْهُورُ بِجَرِّهَا بَعْدَ ذَلِكَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : جَعَلَ جَفَاءَهُ وَدَعْوَتَهُ أَشَدَّ مَعَايِبِهِ ; لِأَنَّهُ إِذَا جَفَا وَغَلُظَ طَبْعُهُ قَسَا قَلْبُهُ ، وَاجْتَرَأَ عَلَى كُلِّ مَعْصِيَةٍ ; وَلِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ النُّطْفَةَ إِذَا خَبُثَتْ خَبُثَ النَّاشِئُ مِنْهَا ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374963لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ الزِّنَا وَلَا وَلَدُهُ وَلَا وَلَدُ وَلَدِهِ . وَبَعْدَ ذَلِكَ نَظِيرُ ثُمَّ فِي قَوْلِهِ : ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا . وَقَرَأَ
الْحَسَنُ : " عُتُلٌّ " رَفْعًا عَلَى الذَّمِّ ، وَهَذِهِ الْقِرَاءَةُ تَقْوِيَةٌ لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ . انْتَهَى . وَقَالَ
ابْنُ عَطِيَّةَ : بَعْدِ ذَلِكَ أَيْ : بَعْدَ أَنْ وَصَفْنَاهُ بِهِ ، فَهَذَا التَّرْتِيبُ إِنَّمَا هُوَ فِي قَوْلِ الْوَاصِفِ لَا فِي حُصُولِ تِلْكَ الصِّفَاتِ فِي الْمَوْصُوفِ ، وَإِلَّا فَكَوْنُهُ عُتُلًّا هُوَ قَبْلَ كَوْنِهِ صَاحِبَ خَيْرٍ يَمْنَعُهُ . انْتَهَى . وَ " الزَّنِيمُ " : الْمُلْصَقُ فِي الْقَوْمِ وَلَيْسَ مِنْهُمْ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ . وَقِيلَ : الزَّنِيمُ ، الْمُرِيبُ الْقَبِيحُ الْأَفْعَالِ ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا : الزَّنِيمُ الَّذِي لَهُ زَنَمَةٌ فِي عُنُقِهِ كَزَنَمَةِ الشَّاةِ ، وَمَا كُنَّا نَعْرِفُ الْمُشَارَ إِلَيْهِ حَتَّى نَزَلَتْ فَعَرَفْنَاهُ بِزَنَمَتِهِ . انْتَهَى . وَرُوِيَ أَنَّ
الْأَخْفَشَ بْنَ شَرِيفٍ كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ ، كَانَ لَهُ زَنَمَةٌ . وَرَوَى
ابْنُ جُبَيْرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الزَّنِيمَ هُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِالشَّرِّ ، كَمَا تُعْرَفُ الشَّاةُ بِالزَّنَمَةِ . وَعَنْهُ أَيْضًا : أَنَّهُ الْمَعْرُوفُ بِالْأُبْنَةِ . وَعَنْهُ أَيْضًا : أَنَّهُ الظَّلُومُ . وَعَنْ
عِكْرِمَةَ : هُوَ اللَّئِيمُ . وَعَنْ
مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=15990وَابْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ وَلَدُ الزِّنَا الْمُلْحَقُ فِي النَّسَبِ بِالْقَوْمِ ، وَكَانَ الْوَلِيدُ دَعِيًّا فِي
قُرَيْشٍ لَيْسَ مِنْ مَنْحِهِمْ ، ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَ ثَمَانِ عَشَرَةَ مِنْ مَوْلِدِهِ . وَقَالَ
مُجَاهِدٌ : كَانَتْ لَهُ سِتَّةُ أَصَابِعَ فِي يَدِهِ ، فِي كُلِّ إِبْهَامٍ أُصْبُعٌ زَائِدَةٌ ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ الْأَوْصَافَ لَيْسَتْ لِمُعَيَّنٍ . أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ : كُلَّ حَلَّافٍ وَقَوْلِهِ : إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ ؟ فَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنْ طَوَاعِيَةِ مَنْ هُوَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ .
قَالَ
ابْنُ عَطِيَّةَ مَا مُلَخَّصُهُ ، قَرَأَ النَّحْوِيَّانِ وَالْحَرَمِيَّانِ وَ حَفْصٌ وَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ : أَنْ كَانَ عَلَى الْخَبَرِ ; وَبَاقِي السَّبْعَةِ
وَالْحَسَنُ وَابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو جَعْفَرٍ : عَلَى الِاسْتِفْهَامِ . وَحَقَّقَ الْهَمْزَتَيْنِ
حَمْزَةُ ، وَسَهَّلَ الثَّانِيَةَ بَاقِيهِمْ . فَأَمَّا عَلَى الْخَبَرِ ، فَقَالَ
أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ : يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا " عُتُلٍّ " وَإِنْ كَانَ قَدْ وُصِفَ . انْتَهَى ، وَهَذَا قَوْلُ كُوفِيٍّ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ . وَقِيلَ : ( زَنِيمٍ ) لَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِ مَنْ فَسَّرَهُ بِالْقَبِيحِ الْأَفْعَالِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ : وَلَا تُطِعْ يَعْنِي وَلَا تُطِعْهُ مَعَ هَذِهِ الْمَثَالِبِ ، لِـ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ أَيْ : لِيَسَارِهِ وَحَظِّهِ مِنَ الدُّنْيَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَا بَعْدَهُ عَلَى مَعْنَى لِكَوْنِهِ مُتَمَوِّلًا مُسْتَظْهِرًا بِالْبَنِينَ ، كَذَّبَ آيَاتِنَا وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ ، قَالَ الَّذِي هُوَ جَوَابٌ إِذَا ; لِأَنَّ مَا بَعْدَ الشَّرْطِ لَا يَعْمَلُ فِيمَا قَبْلَهُ ، وَلَكِنْ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ مِنْ مَعْنَى التَّكْذِيبِ . انْتَهَى . وَأَمَّا عَلَى الِاسْتِفْهَامِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَسِّرَ عَامِلٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ ، أَيْ : أَيَكُونُ طَوَاعِيَةً لِأَنْ كَانَ ؟ وَقَدَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : أَتُطِيعُهُ لِأَنْ كَانَ ؟ أَوْ عَامِلٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ ، أَيْ : أَكْذَبَ أَوْ جَحَدَ لِأَنْ كَانَ ؟ وَقَرَأَ
نَافِعٌ فِي رِوَايَةِ الْيَزِيدِيِّ عَنْهُ : إِنْ كَانَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : وَالشَّرْطُ لِلْمُخَاطَبِ ، أَيْ : لَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ شَارِطًا يَسَارَهُ ; لِأَنَّهُ إِذَا أَطَاعَ الْكَافِرَ لِغِنَاهُ ، فَكَأَنَّهُ اشْتَرَطَ فِي الطَّاعَةِ الْغِنَى ، وَنَحْوُ صَرْفِ الشَّرْطِ إِلَى الْمُخَاطَبِ صَرْفُ الرَّجَاءِ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ : لَعَلَّهُ يَذَّكَّرُ . انْتَهَى . وَأَقْوَالُ : أَنْ كَانَ شَرْطٌ ، وَ إِذَا تُتْلَى شَرْطٌ ، فَهُوَ مِمَّا اجْتَمَعَ فِيهِ شَرْطَانِ ، وَلَيْسَا مِنَ الشُّرُوطِ الْمُتَرَتِّبَةِ الْوُقُوعِ ، فَالْمُتَأَخِّرُ لَفْظًا هُوَ الْمُتَقَدِّمُ ، وَالْمُتَقَدِّمُ لَفُظًا هُوَ شَرْطٌ فِي الثَّانِي ، كَقَوْلِهِ :
فَإِنْ عَثَرْتُ بَعْدَهَا إِنْ وَأَلَتْ نَفْسِي مِنْ هَاتَا فَقُولَا لَا لَا
لِأَنَّ الْحَامِلَ عَلَى تَرْكِ تَدَبُّرِ آيَاتِ اللَّهِ كَوْنُهُ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ، فَهُوَ مَشْغُولُ الْقَلْبِ ، فَذَلِكَ غَافِلٌ عَنِ النَّظَرِ
[ ص: 311 ] وَالْفِكْرِ ، قَدِ اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَأَبْطَرَتْهُ . وَقَرَأَ
الْحَسَنُ : أَئِذَا عَلَى الِاسْتِفْهَامِ ، وَهُوَ اسْتِفْهَامُ تَقْرِيعٍ وَتَوْبِيخٍ عَلَى قَوْلِهِ : الْقُرْآنُ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ، لَمَّا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُ اللَّهِ . وَلَمَّا ذَكَرَ قَبَائِحَ أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ ، ذَكَرَ مَا يُفْعَلُ بِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّوَعُّدِ ، فَقَالَ : سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ وَالسِّمَةُ : الْعَلَامَةُ . وَلَمَّا كَانَ الْوَجْهُ أَشْرَفَ مَا فِي الْإِنْسَانِ ، وَالْأَنْفُ أَكْرَمَ مَا فِي الْوَجْهِ لِتَقَدُّمِهِ ، وَلِذَلِكَ جَعَلُوهُ مَكَانَ الْعِزِّ وَالْحَمِيَّةِ ، وَاشْتَقُّوا مِنْهُ الْأَنَفَةَ ، وَقَالُوا : حَمِيُّ الْأَنْفِ شَامِخُ الْعِرْنِينِ . وَقَالُوا فِي الذَّلِيلِ : جُدِعَ أَنْفُهُ ، وَرَغِمَ أَنْفُهُ . وَكَانَ أَيْضًا مِمَّا تَظْهَرُ السِّمَاتُ فِيهِ لِعُلُوٍّ ، قَالَ : سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ وَهُوَ غَايَةُ الْإِذْلَالِ وَالْإِهَانَةِ وَالِاسْتِبْلَادِ ، إِذْ صَارَ كَالْبَهِيمَةِ لَا يَمْلِكُ الدَّفْعَ عَنْ وَسْمِهِ فِي الْأَنْفِ ، وَإِذَا كَانَ الْوَسْمُ فِي الْوَجْهِ شَيْنًا ، فَكَيْفَ بِهِ عَلَى أَكْرَمِ عُضْوٍ فِيهِ ؟ وَقَدْ قِيلَ : الْجَمَالُ فِي الْأَنْفِ ، وَقَالَ بَعْضُ الْأُدَبَاءِ :
وَحُسْنُ الْفَتَى فِي الْأَنْفِ وَالْأَنْفُ عَاطِلٌ فَكَيْفَ إِذَا مَا الْخَالُ كَانَ لَهُ حُلِيًّا
وَسَنَسِمُهُ فِعْلٌ مُسْتَقْبَلٌ لَمْ يَتَعَيَّنْ زَمَانُهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ الضَّرْبُ بِالسَّيْفِ ، أَيْ : يُضْرَبُ بِهِ وَجْهِهِ وَعَلَى أَنْفِهِ ، فَيَجِيءُ ذَلِكَ كَالْوَسْمِ عَلَى الْأَنْفِ ، وَحَلَّ بِهِ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15153الْمُبَرِّدُ : ذَلِكَ فِي عَذَابِ الْآخِرَةِ فِي جَهَنَّمَ ، وَهُوَ تَعْذِيبٌ بِنَارٍ عَلَى أُنُوفِهِمْ . وَقَالَ آخَرُونَ : ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَيْ : نُوسِمُ عَلَى أَنْفِهِ بَسِمَةٍ يُعْرَفُ بِهَا كُفْرُهُ وَانْحِطَاطُ قَدْرِهِ . وَقَالَ
قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ : مَعْنَاهُ سَنَفْعَلُ بِهِ فِي الدُّنْيَا مِنَ الذَّمِّ وَالْمَقْتِ وَالِاشْتِهَارِ بِالشَّرِّ مَا يَبْقَى فِيهِ وَلَا يَخْفَى بِهِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ كَالْوَسْمِ عَلَى الْأَنْفِ ثَابِتًا بَيِّنًا ، كَمَا تَقُولُ : سَأُطَوِّقُكَ طَوْقَ الْحَمَامَةِ ، أَيْ : أُثْبِتُ لَكَ الْأَمْرَ بَيِّنًا فِيكَ ، وَنَحْوَ هَذَا أَرَادَ
جَرِيرٌ بِقَوْلِهِ :
لَمَّا وَضَعْتُ عَلَى الْفَرَزْدَقِ مَيْسَمِي
وَفِي الْوَسْمِ عَلَى الْأَنْفِ تَشْوِيهٌ ، فَجَاءَتِ اسْتِعَارَتُهُ فِي الْمَذَمَّاتِ بَلِيغَةً جِدًّا . قَالَ
ابْنُ عَطِيَّةَ : وَإِذَا تَأَمَّلْتَ حَالَ
أَبِي جَهْلٍ وَنُظَرَائِهِ ، وَمَا ثَبَتَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا مِنْ سُوءِ الْأُخْرَوِيَّةِ ، رَأَيْتَ أَنَّهُمْ قَدْ وُسِمُوا عَلَى الْخَرَاطِيمِ . انْتَهَى . وَقَالَ
أَبُو الْعَالِيَةِ وَمُقَاتِلٌ ، وَاخْتَارَهُ
الْفَرَّاءُ : يَسْوَدُّ وَجْهُهُ قَبْلَ دُخُولِ النَّارِ ، وَذَكَرَ الْخُرْطُومَ ، وَالْمُرَادُ الْوَجْهُ ; لِأَنَّ بَعْضَ الْوَجْهِ يُؤَدِّي عَنْ بَعْضٍ . وَقَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ : إِنَّمَا بَالَغَ الْكَافِرُ فِي عَدَاوَةِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبَبِ الْأَنَفَةِ وَالْحَمِيَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ شَاهِدُ الْإِنْكَارِ هُوَ الْأَنَفَةُ وَالْحَمِيَّةُ ، عَبَّرَ عَنْ هَذَا الِاخْتِصَاصِ بِقَوْلِهِ : سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ . انْتَهَى كَلَامُهُ . وَفِي اسْتِعَارَةِ الْخُرْطُومِ مَكَانَ الْأَنْفِ اسْتِهَانَةٌ وَاسْتِخْفَافٌ ; لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْخُرْطُومِ هُوَ لِلسِّبَاعِ . وَتَلَخَّصَ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْلَهُ : سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ أَهُوَ حَقِيقَةٌ أَمْ مَجَازٌ ؟ وَإِذَا كَانَ حَقِيقَةً ، فَهَلْ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْآخِرَةِ ؟ وَأَبْعَدَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فِي تَفْسِيرِهِ الْخُرْطُومَ بِالْخَمْرِ ، وَأَنَّ مَعْنَاهُ سَنَحُدُّهُ عَلَى شُرْبِهَا .
وَلَمَّا ذَكَرَ الْمُتَّصِفَ بِتِلْكَ الْأَوْصَافِ الذَّمِيمَةِ ، وَهُمْ كُفَّارُ
قُرَيْشٍ ، أَخْبَرَ - تَعَالَى - بِمَا حَلَّ بِهِمْ مِنَ الِابْتِلَاءِ بِالْقَحْطِ وَالْجُوعِ بِدَعْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374730اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ الْحَدِيثَ . كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْمَعْرُوفِ خَبَرُهَا عِنْدَهُمْ . كَانَتْ بِأَرْضِ
الْيَمَنِ صَنْعَاءَ لِرَجُلٍ كَانَ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ مِنْهَا ، فَمَاتَ فَصَارَتْ إِلَى وَلَدِهِ ، فَمَنَعُوا النَّاسَ خَيْرَهَا وَبَخِلُوا بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، فَأَهْلَكَهَا اللَّهُ - تَعَالَى - مِنْ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْهُمْ دَفْعُ مَا حَلَّ بِهِمْ . وَقِيلَ : كَانَتْ بِصُورَانَ عَلَى فَرَاسِخَ مِنْ صَنْعَاءَ لِنَاسٍ بَعْدَ رَفْعِ
عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَكَانَ صَاحِبُهَا يُنْزِلُ لِلْمَسَاكِينِ مَا أَخْطَأَهُ الْمِنْجَلُ ، وَمَا فِي أَسْفَلِ الْأَكْرَاسِ ، وَمَا أَخْطَاهُ الْقِطَافُ مِنَ الْعِنَبِ ، وَمَا بَقِيَ عَلَى السَّبَاطِ تَحْتَ النَّخْلَةِ إِذَا صُرِمَتْ ، فَكَانَ يَجْتَمِعُ لَهُمْ شَيْءٌ كَثِيرٌ ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَ بَنُوهُ : إِنْ فَعَلْنَا مَا كَانَ يَفْعَلُ أَبُونَا ضَاقَ عَلَيْنَا الْأَمْرُ وَنَحْنُ أُولُو عِيَالٍ ، فَحَلَفُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ فِي السَّدَفِ خُفْيَةً مِنَ الْمَسَاكِينِ ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا فِي يَمِينِهِمْ . وَ " الْكَافُ " فِي كَمَا بَلَوْنَا فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ ، وَ " مَا " مَصْدَرِيَّةٌ . وَقِيلَ : بِمَعْنَى
[ ص: 312 ] الَّذِي ، وَإِذْ مَعْمُولٌ لَبَلَوْنَاهُمْ " لَيَصْرِمُنَّهَا " جَوَابُ الْقَسَمِ لَا عَلَى مَنْطُوقِهِمْ ، إِذْ لَوْ كَانَ عَلَى مَنْطُوقِهِمْ لَكَانَ لَنَصْرِمُنَّهَا بِنُونِ الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَالْمَعْنَى : لَيَجُدُنَّ ثَمَرَهَا إِذَا دَخَلُوا فِي الصَّبَاحِ قَبْلَ خُرُوجِ الْمَسَاكِينِ إِلَى عَادَتِهِمْ مَعَ أَبِيهِمْ . وَلَا يَسْتَثْنُونَ أَيْ : وَلَا يَنْثَنُونَ عَنْ مَا عَزَمُوا عَلَيْهِ مِنْ مَنْعِ الْمَسَاكِينِ . وَقَالَ
مُجَاهِدٌ : مَعْنَاهُ : لَا يَقُولُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، بَلْ عَزَمُوا عَلَى ذَلِكَ عَزْمَ مَنْ يَمْلِكُ أَمْرَهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ ، مُتَّبِعًا قَوْلَ
مُجَاهِدٍ : وَلَا يَقُولُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . ( فَإِنْ قُلْتَ ) لِمَ سُمِّيَ اسْتِثْنَاءٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ ؟ ( قُلْتُ ) : لِأَنَّهُ يُؤَدِّي مُؤَدَّى الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِكَ : لَأَخْرُجَنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَلَا أَخْرُجُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاحِدٌ . انْتَهَى .
فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ قَرَأَ النَّخَعِيُّ : طِيفَ . قَالَ
الْفَرَّاءُ : وَالطَّائِفُ الْأَمْرُ الَّذِي يَأْتِي بِاللَّيْلِ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=201إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلَمْ يَتَخَصَّصْ بِاللَّيْلِ ، وَطَائِفٌ مُبْهَمٌ . فَقِيلَ : هُوَ
جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - اقْتَلَعَهَا وَطَافَ بِهَا حَوْلَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ وَضَعَهَا حَيْثُ مَدِينَةُ الطَّائِفِ الْيَوْمَ ، وَلِذَلِكَ سُمِّيتْ بِالطَّائِفِ ، وَلَيْسَ فِي أَرْضِ
الْحِجَازِ بَلْدَةٌ فِيهَا الْمَاءُ وَالشَّجَرُ وَالْأَعْنَابُ غَيْرَهَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : طَائِفٌ مِنْ أَمْرِ رَبِّكَ . وَقَالَ
قَتَادَةُ : عَذَابٌ مِنْ رَبِّكَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ : عُنُقٌ خَرَجَ مِنْ وَادِي جَهَنَّمَ . فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : كَالرَّمَادِ الْأَسْوَدِ ، وَالصَّرِيمُ : الرَّمَادُ الْأَسْوَدُ بِلُغَةِ خُزَيْمَةَ ، وَعَنْهُ أَيْضًا : الصَّرِيمُ رَمْلَةٌ بِالْيَمَنِ مَعْرُوفَةٌ لَا تُنْبِتُ ، فَشَبَّهَ جَنَّتَهُمْ بِهَا . وَقَالَ
الْحَسَنُ : صَرَمَ عَنْهَا الْخَيْرَ ، أَيْ قَطَعَ . فَالصَّرِيمُ بِمَعْنَى مَصْرُومٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ : كَالصُّبْحِ مِنْ حَيْثُ ابْيَضَّتْ كَالزَّرْعِ الْمَحْصُودِ . وَقَالَ
مُؤَرِّجٌ : كَالرَّمْلَةِ انْصَرَمَتْ مِنْ مُعْظَمِ الرَّمْلِ ، وَالرَّمْلَةُ لَا تُنْبِتُ شَيْئًا يَنْفَعُ . وَقَالَ
الْأَخْفَشُ : كَالصُّبْحِ انْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15153الْمُبَرِّدُ : كَالنَّهَارِ فَلَا شَيْءَ فِيهَا . وَقَالَ
شِمْرٌ : الصَّرِيمُ : اللَّيْلُ ، وَالصَّرِيمُ : النَّهَارُ ، أَيْ : يَنْصَرِمُ هَذَا عَنْ ذَاكَ ، وَذَاكَ عَنْ هَذَا . وَقَالَ
الْفَرَّاءُ وَالْقَاضِيَ
nindex.php?page=showalam&ids=17150مُنْذِرُ بْنُ سَعِيدٍ وَجَمَاعَةٌ : الصَّرِيمُ اللَّيْلُ مِنْ حَيْثُ اسْوَدَّتْ جَنَّتُهُمْ . ( فَتَنَادَوْا ) دَعَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَى الْمُضِيِّ إِلَى مِيعَادِهِمْ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : ( فَإِنْ قُلْتَ ) هَلَّا قِيلَ اغْدُوا إِلَى حَرْثِكُمْ وَمَا مَعْنَى عَلَى ؟ ( قُلْتُ ) : لَمَّا كَانَ الْغُدُوُّ إِلَيْهِ لِيَصْرِمْوهُ وَيَقْطَعُوهُ كَانَ غُدُوًّا عَلَيْهِ ، كَمَا تَقُولُ : غَدَا عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ . وَيَجُوزُ أَنْ يُضَمَّنَ الْغَدَ وَمَعْنَى الْإِقْبَالِ ، كَقَوْلِهِمْ : يُغْدَى عَلَيْهِ بِالْجَفْنَةِ وَيُرَاحُ ، أَيْ : فَأَقْبِلُوا عَلَى حَرْثِكُمْ بَاكِرِينَ . انْتَهَى . وَاسْتَسْلَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ أَنَّ غَدَا يَتَعَدَّى بِإِلَى ، وَيَحْتَاجُ ذَلِكَ إِلَى نَقْلٍ بِحَيْثُ يَكْثُرُ ذَلِكَ ، فَيَصِيرُ أَصْلًا فِيهِ وَيُتَأَوَّلُ مَا خَالَفَهُ ، وَالَّذِي فِي حِفْظِي أَنَّهُ مُعَدًّى بِعَلَى ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ :
بَكَرْتُ عَلَيْهِ غُدْوَةً فَرَأَيْتُهُ قَعُودًا عَلَيْهِ بِالصَّرِيمِ عَوَادِلُهُ
إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ صِرَامِ النَّخْلِ . قِيلَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ : إِنْ كُنْتُمْ أَهْلَ عَزْمٍ وَإِقْدَامٍ عَلَى رَأْيِكُمْ ، مِنْ قَوْلِكَ سَيْفٌ صَارِمٌ . ( يَتَخَافَتُونَ ) يُخْفُونَ كَلَامَهُمْ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَشْعُرَ بِهِمُ الْمَسَاكِينُ . أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا أَيْ : يَتَخَافَتُونَ بِهَذَا الْكَلَامِ وَهُوَ لَا يَدْخُلُنَّهَا ، وَ " أَنْ " مَصْدَرِيَّةٌ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ تَفْسِيرِيَّةً . وَقَرَأَ
عَبْدُ اللَّهِ nindex.php?page=showalam&ids=12356وَابْنُ أَبِي عَبْلَةَ : لَا يَدْخُلَنَّهَا ، بِإِسْقَاطِ أَنْ عَلَى إِضْمَارٍ يَقُولُونَ ، أَوْ عَلَى إِجْرَاءِ " يَتَخَافَتُونَ " مَجْرَى الْقَوْلِ ، إِذْ مَعْنَاهُ : يُسَارُّونَ الْقَوْلَ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الدُّخُولِ نَهْيٌ عَنِ التَّمْكِينِ مِنْهُ ، أَيْ لَا تُمَكِّنُوهُمْ مِنَ الدُّخُولِ فَيَدْخُلُوا . وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ أَيْ : عَلَى قَصْدٍ وَقُدْرَةٍ فِي أَنْفُسِهِمْ ، يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ تَمَكَّنُوا مِنْ مُرَادِهِمْ . قَالَ مَعْنَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَيْ : قَاصِدِينَ إِلَى جَنَّتِهِمْ بِسُرْعَةٍ ، قَادِرِينَ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى صِرَامِهَا . قَالَ
أَبُو عُبَيْدَةَ وَالْقُتَبِيُّ : عَلَى حَرْدٍ عَلَى مَنْعٍ ، أَيْ : قَادِرِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ عَلَى مَنْعِ الْمَسَاكِينِ مِنْ خَيْرِهَا ، فَجَزَاهُمُ اللَّهُ بِأَنْ مَنَعَهُمْ خَيْرًا . وَقَالَ
الْحَسَنُ : عَلَى حَرْدٍ أَيْ : حَاجَةٍ وَفَاقَةٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ وَسُفْيَانُ : عَلَى حَرْدٍ عَلَى غَضَبٍ ، أَيْ : لَمْ يَقْدِرُوا إِلَّا عَلَى حَنَقٍ وَغَضَبٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . وَقِيلَ : عَلَى حَرْدٍ : عَلَى انْفِرَادٍ
[ ص: 313 ] أَيِ : انْفَرَدُوا دُونَ الْمَسَاكِينِ . وَقَالَ
الْأَزْهَرِيُّ : " حَرْدٍ " اسْمُ قَرْيَتِهِمْ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ : اسْمُ جَنَّتِهِمْ ، أَيْ : غَدَوْا عَلَى تِلْكَ الْجَنَّةِ قَادِرِينَ عَلَى صِرَامِهَا عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ ، أَوْ مُقَدِّرِينَ أَنْ يَتِمَّ لَهُمْ مُرَادُهُمْ مِنَ الصِّرَامِ . قِيلَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ التَّقْدِيرِ بِمَعْنَى التَّضْيِيقِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أَيْ : مُضَيِّقِينَ عَلَى الْمَسَاكِينِ ، إِذْ حَرَمُوهُمْ مَا كَانَ أَبُوهُمْ يُنِيلُهُمْ مِنْهَا . فَلَمَّا رَأَوْهَا أَيْ : عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي كَانُوا غُدُوُّهَا عَلَيْهَا ، مِنْ هَلَاكِهَا وَذَهَابِ مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ أَيْ : عَنِ الطَّرِيقِ إِلَيْهَا ، قَالَهُ قَتَادَةُ . وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ وُصُولِهِمْ أَنْكَرُوا أَنَّهَا هِيَ ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ أَخْطَأُوا الطَّرِيقَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ وَضَحَ لَهُمْ أَنَّهَا هِيَ ، وَأَنَّهُ أَصَابَهَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مَا أَذْهَبَ خَيْرَهَا . وَقِيلَ : لَضَالُّونَ عَنِ الصَّوَابِ فِي غُدُوِّنَا عَلَى نِيَّةِ مَنْعِ الْمَسَاكِينِ ، فَقَالُوا : بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ خَيْرَهَا بِخِيَانَتِنَا عَلَى أَنْفُسِنَا .
قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَيْ : أَفْضَلُهُمْ وَأَرْجَحُهُمْ عَقْلًا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ أَنَّبَهُمْ وَوَبَّخَهُمْ عَلَى تَرْكِهِمْ مَا حَضَّهُمْ عَلَيْهِ مِنْ تَسْبِيحِ اللَّهِ ، أَيْ ذِكْرُهُ وَتَنْزِيهُهُ عَنِ السُّوءِ ، وَلَوْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَإِحْسَانَهُ إِلَيْهِمْ لَامْتَثَلُوا مَا أَمَرَ بِهِ مِنْ مُوَاسَاةِ الْمَسَاكِينِ ، وَاقْتَفَوْا سُنَّةَ أَبِيهِمْ فِي ذَلِكَ . فَلَمَّا غَفَلُوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَعَزَمُوا عَلَى مَنْعِ الْمَسَاكِينِ ، ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَوْسَطَهُمْ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ وَحَرَّضَهُمْ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَالَ
مُجَاهِدٌ وَأَبُو صَالِحٍ : كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ . قَالَ
النَّحَّاسُ : جَعَلَ
مُجَاهِدٌ التَّسْبِيحَ مَوْضِعَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ; لِأَنَّ الْمَعْنَى تَنْزِيهُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : لِالْتِقَائِهِمَا فِي مَعْنَى التَّعْظِيمِ لِلَّهِ ; لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ تَفْوِيضٌ إِلَيْهِ ، وَالتَّسْبِيحُ تَنْزِيهٌ لَهُ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ التَّفْوِيضِ وَالتَّنْزِيهِ تَعْظِيمٌ لَهُ . وَقِيلَ : لَوْلَا تُسَبِّحُونَ : تَسْتَغْفِرُونَ . وَلَمَّا أَنَّبَهُمْ ، رَجَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَاعْتَرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالظُّلْمِ ، وَبَادَرُوا إِلَى تَسْبِيحِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَقَالُوا : سُبْحَانَ رَبِّنَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْ : نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِنَا . وَلَمَّا أَقَرُّوا بِظُلْمِهِمْ ، لَامَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَجَعَلَ اللَّوْمَ فِي حَيِّزِ غَيْرِهِ ، إِذْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ زَيَّنَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَمَرَ بِالْكَفِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَصَى الْأَمْرَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَكَتَ عَلَى رِضًا مِنْهُ . ثُمَّ اعْتَرَفُوا بِأَنَّهُمْ طَغَوْا ، وَتَرَجُّوا انْتِظَارَ الْفَرَجِ فِي أَنْ يُبْدِلَهُمْ خَيْرًا مِنْ تِلْكَ الْجَنَّةِ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا أَيْ : بِهَذِهِ الْجَنَّةِ خَيْرًا مِنْهَا . وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي الْكَهْفِ ، وَالْخِلَافُ فِي تَخْفِيفِ يُبَدِّلُنَا ، وَتَثْقِيلِهَا مَنْسُوبًا إِلَى الْقُرَّاءِ .
إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ أَيْ : طَالِبُونَ إِيصَالَ الْخَيْرِ إِلَيْنَا مِنْهُ . وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الْجَنَّةِ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَصَابُوا مَعْصِيَةً وَتَابُوا . وَقِيلَ : كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : بَلَغَنِي أَنَّ الْقَوْمَ دَعَوُا اللَّهَ وَأَخْلَصُوا ، وَعَلِمَ اللَّهُ مِنْهُمُ الصِّدْقَ فَأَبْدَلَهُمْ بِهَا جَنَّةً ، وَكُلُّ عُنْقُودٍ مِنْهَا كَالرَّجُلِ الْأَسْوَدِ الْقَائِمِ . وَعَنْ
مُجَاهِدٍ : تَابُوا فَأُبْدِلُوا خَيْرًا مِنْهَا . وَقَالَ
الْقُشَيْرِيُّ : الْمُعْظَمُ يَقُولُونَ أَنَّهُمْ تَابُوا وَأَخْلَصُوا . انْتَهَى . وَتَوَقَّفَ
الْحَسَنُ فِي كَوْنِهِمْ مُؤْمِنِينَ وَقَالَ : أَكَانَ قَوْلُهُمْ : إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ إِيمَانًا ، أَوْ عَلَى حَدِّ مَا يَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الشِّدَّةُ ؟ .
كَذَلِكَ الْعَذَابُ . هَذَا خِطَابٌ لِلرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَمْرِ
قُرَيْشٍ . قَالَ
ابْنُ عَطِيَّةَ : وَالْإِشَارَةُ بِذَلِكَ إِلَى الْعَذَابِ الَّذِي نَزَلَ بِالْجَنَّةِ ، أَيْ كَذَلِكَ الْعَذَابُ أَيِ : الَّذِي نَزَلَ
بِقُرَيْشٍ بَغْتَةً ، ثُمَّ عَذَابُ الْآخِرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ أَشُدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا . وَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ : الْعَذَابُ النَّازِلُ بِقُرَيْشٍ الْمُمَاثِلُ لِأَمْرِ الْجَنَّةِ ، هُوَ الْجَدْبُ الَّذِي أَصَابَهُمْ سَبْعَ سِنِينَ حَتَّى رَأَوُا الدُّخَانَ وَأَكَلُوا الْجُلُودَ . انْتَهَى . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : مِثْلُ ذَلِكَ الْعَذَابِ الَّذِي بَلَوْنَا بِهِ أَهْلَ مَكَّةَ وَأَصْحَابَ الْجَنَّةِ عَذَابُ الدُّنْيَا . وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ مِنْهُ . انْتَهَى . وَتَشْبِيهُ بَلَاءِ
قُرَيْشٍ بِبَلَاءِ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ، هُوَ أَنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ عَزَمُوا عَلَى الِانْتِفَاعِ بِثَمَرِهَا وَحِرْمَانِ الْمَسَاكِينِ ، فَقَلَبَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَلَيْهِمْ وَحَرَمَهُمْ . وَأَنَّ
قُرَيْشًا حِينَ خَرَجُوا إِلَى بَدْرٍ حَلَفُوا عَلَى قَتْلِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ ، فَإِذَا فَعَلُوا
[ ص: 314 ] ذَلِكَ رَجَعُوا إِلَى مَكَّةَ وَطَافُوا بِالْكَعْبَةِ وَشَرِبُوا الْخُمُورَ ، فَقَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِأَنْ قُتِلُوا وَأُسِرُوا . وَلَمَّا عَذَّبَهُمْ بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا قَالَ : وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ .

 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام





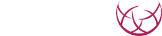








 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات