السؤال
أنا أعلم أن الإنسان مسير في أشياء ومخير في أشياء, وأعلم أن الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان لطريقي الإيمان والكفر لقوله تعالى: "وهديناه النجدين" وفي آية أخرى "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" وأن الله قد أعطى للإنسان حرية الاختيار المطلقة، وهذا من تكريم الله له، وأعطى له من الآيات والدلائل على قدرته في الكون وفي نفسه ما لا حصر لها، وأرسل الرسل والأنبياء بالرسالات والكتب السماوية "لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل" كل ما سبق أنا أعيه وأفهمه جيدا.
ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم وهو يخلق هذه النفس وقبل حتى أن يضع فيها الروح أنها ستدخل الجنة أو النار, نعم لقد أعطاها حرية الاختيار والعقيدة، ولكنه سبحانه يعلم أن هذه النفس ستؤمن في نهاية الأمر أم لا، وستدخل الجنة أم لا من قبل أن يخلقها, فهنا حكمة خلق النفس التي ستدخل الجنة مفهومة مصداقا لقول الله تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" إذن فالله خلق هذه النفس المؤمنة حتى تعبده ويكون مصيرها في النهاية الجنة, وخلق الله لهذه النفس من عدم فهو تكريم لها في حد ذاته مصداقا لقوله تعالى "هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا" , لكن لماذا خلق الله نفسا وهو سبحانه يعلم أنها في نهاية الأمر ستدخل النار ولن تؤمن ولن تهتدي -"وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا"- ؟؟!! هل يخلق الله نفسا ليعذبها وهو أرحم من الوالدة بولدها ؟؟ قال الله تعالى : ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين" إذن فالله عالم أن هناك أنفسا لن تهتدي والله لن يؤتيها هداها. فلماذا خلقها من الأصل وهو يعلم أنها سينتهي بها الحال كافرة ؟؟؟؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم وفقك الله أن الله سبحانه له الحمد على جميع ما قدره وقضاه، وقد خلق عباده فمنهم كافر ومنهم مؤمن، وقد أدخل أهل النار النار وإن حمده لفي قلوبهم لا يستطيعون غير ذلك كما قال الحسن رحمه الله، واعلم كذلك أنه سبحانه حكيم، فهو يضع الأشياء في مواضعها فيضع الهدى في موضعه والضلال في موضعه، وأما حكمة خلقه للكفار وإيجاده لهم مع علمه بأنهم يكفرون، وأنه سبحانه هو الذي قضى عليهم بذلك.. فلأن كثيرا من أنواع العبودية التي يحبها الله تعالى لم تكن لتحصل لولا وجود الكفر والكفار، كعبودية الموالاة في الله والمعاداة فيه، وعبودية الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، أفترى لو لم يكن ثم كفار فكيف كانت تظهر فضيلة الرسل وأتباعهم، ومن كان يتخذ الله شهداء، وكيف كان يتحقق الصبر والمصابرة والمرابطة ونحوها من أنواع العبودية التي يحبها الله تعالى، وأيضا فإنه تعالى ذو الأسماء الحسنى، ولم تكن آثار أسمائه وصفاته لتظهر لولا خلق الكفار، فينتصر لأوليائه منهم ويخزيهم ويعاقبهم ويجعلهم عبرة لعباده ونحو ذلك من آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلا، وأيضا فإنه سبحانه يحب أن يحمده عباده على نعمه وأعظمها نعمة الإيمان، وإنما تظهر هذه النعمة وينجلي حسنها بوجود ضدها وهو الكفر، وثم حكم كثيرة لخلق الكفار وإيجادهم تضيق عن بسطها هذه الفتوى المختصرة، لكننا ننقل هنا للفائدة طرفا صالحا من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله ينجلي به المقام وإن طال بعض الطول لكن لعل فيه ما يكفيك في الجواب عن هذا الإشكال، قال عليه الرحمة: الله سبحانه يحب أن يشكر، وشكره سبحانه واجب عقلا وشرعا وفطرة، بل وجوب شكره أظهر من وجوب كل واجب، وكيف لا يجب على العباد حمده وتوحيده ومحبته وذكر آلائه وإحسانه وتعظيمه وتكبيره والخضوع له والتحدث بنعمته والإقرار بها بجميع طرق الوجوب، فالشكر أحب شيء إليه وأعظم ثوابا. وقد خلق الخلق وأنزل الكتب وشرع الشرائع وذلك يستلزم خلق الأسباب التي يكون الشكر بها أكمل ومن جملتها أن فاوت بين عباده في صفاتهم الظاهرة والباطنة، في خلقهم وأخلاقهم وأديانهم وأرزاقهم ومعايشهم وآجالهم، فإذا رأى المعافى المبتلى، والغني الفقير، والمؤمن الكافر عظم شكره لله وعرف قدر نعمته عليه وما خصه به وفضله به على غيره فازداد شكرا وخضوعا واعترافا بالنعمة، وفي أثر ذكره الإمام أحمد في الزهد: "أن موسى قال يا رب هلا سويت بين عبادك؟ قال إني أحببت أن أشكر". فإن قيل فقد كان من الممكن أن يسوي بينهم في النعم ويسوي بينهم في الشكر كما فعل بالملائكة؟ قيل لو فعل ذلك لكان الحاصل من الشكر نوع آخر غير النوع الحاصل منه على هذا الوجه، والشكر الواقع على التفضيل والتخصيص أعلى وأفضل من غيره، ولهذا كان شكر الملائكة وخضوعهم وذلهم لعظمته وجلاله بعد أن شاهدوا من إبليس ما جرى له ومن هاروت وماروت ما شاهدوه أعلى وأكمل مما كان قبله، وهذه حكمة الرب، ولهذا كان شكر الأنبياء وأتباعهم بعد أن عاينوا هلاك أعدائهم وانتقام الرب منهم وما أنزل بهم من بأسه أعلى وأكمل، وكذلك شكر أهل الجنة في الجنة وهم يشاهدون أعداءه المكذبين لرسله المشركين به في ذلك العذاب فلا ريب أن شكرهم حينئذ ورضاهم ومحبتهم لربهم أكمل وأعظم مما لو قدر اشتراك جميع الخلق في النعيم. فالمحبة الحاصلة من أوليائه له والرضا والشكر وهم يشاهدون بني جنسهم في ضد ذلك من كل وجه أكمل وأتم، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، ولولا خلق القبيح لما عرفت فضيلة الجمال والحسن، ولولا خلق الظلام لما عرفت فضيلة النور... وكذلك لو كان العباد كلهم مؤمنين لما عرف قدر الإيمان والنعمة به فتبارك من له في خلقه وأمره الحكم البوالغ والنعم السوابغ. وأيضا فإنه سبحانه يحب أن يعبد بأنواع العبودية ومن أعلاها وأجلها عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه، والجهاد في سبيله وبذل مهج النفوس في مرضاته ومعارضة أعدائه، وهذا النوع هو ذروة سنام العبودية وأعلى مراتبها وهو أحب أنواعها إليه وهو موقوف على ما لا يحصل بدونه من خلق الأرواح التي تواليه وتشكره وتؤمن به، والأرواح التي تعاديه وتكفر به ويسلط بعضها على بعض لتحصل بذلك محابه على أتم الوجوه. وتقرب أوليائه إليه لجهاد أعدائه ومعارضتهم فيه وإذلالهم وكبتهم ومخالفة سبيلهم، فتعلو كلمته ودعوته على كلمة الباطل ودعوته، ويتبين بذلك شرف علوها وظهورها ولو لم يكن للباطل والكفر والشرك وجود فعلي أي شيء كانت كلمته ودعوته تعلو؟ فإن العلو أمر لشيء يستلزم غالبا ما يعلى عليه وعلو الشيء على نفسه محال. وأيضا فلولا الإساءة والعدوان لم تحصل عبودية الصبر والمغفرة وكظم الغيظ. ولولا الفقر والحاجة لم تحصل عبودية الصدقة والإيثار والمواساة، فلو سوى بين خلقه جميعهم لتعطلت هذه العبوديات التي هي أحب شيء إليه، ولأجلها خلق الجن والإنس، ولأجلها شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الدنيا والآخرة. وكما أن ذلك من صفات كماله فلو لم يقدر الأسباب التي يحصل بها ذلك لغاب هذا الكمال وتعطلت أحكام تلك الصفات. وهو سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم فرح يقدر أو يخطر ببال أو يدور في خلد، وحصول هذا الفرح موقوف على التوبة الموقوفة على وجود ما يتاب منه. انتهى بتصرف يسير، وله تتمة سابغة تنظرها إن شئت في شفاء العليل.
وقبل هذا وبعده فإننا نتلو قول الله سبحانه: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء:23}.
والله أعلم.

 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

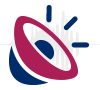

 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات