الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الإيمان المذكور في حقيقته إيمان بالعقل، وقدرته على تقرير الأحكام، والتمييز بين ما يُقبل منها وما يُردّ!! وأما الإيمان بالله تعالى، فشيء آخر، قائم على التسليم لحكمه، والإذعان لرسله، والرضا بربوبيته وألوهيته؛ وبذلك يذوق العبد طعم الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا. رواه مسلم.
وصحة نسبة الحكم لدِين الله تعالى، كافٍ لقبوله عند المؤمن، حتى ولو تحير فيه العقل، ولم يعرف علته أو حكمته، وحتى لو كان حكم العقل على خلافه، وإلا فعقل مَنْ هو الذي ستُحاكم عليه الأمور الدينية؟؟ فإن العقول تتفاوت، وتختلف اختلافًا بيّنًا حتى بين أبناء المدرسة الفكرية الواحدة.
ثم إنه من المعروف أن فكر الإنسان، وطريقة حكمه على الأشياء، تتأثر بنشأته، وبيئته، وتكوينه العقلي، ومستواه العلمي، ومحيطه الاجتماعي، بل وحتى حالته النفسية، والمزاجية، فكيف يجعل العقل بعد ذلك حكمًا على أحكام الشرع التي أنزلت لتحكم على الناس كافة، في كل عصر ومصر، في كل زمان ومكان؟! ولا سيما والعقلاء متفقون على أن للعقل حدًّا، لا يستطيع تجاوزه، ومدىً لا يمكنه الخوض بعده، ولا يقدر على تخطيه، فكيف يحيط علمًا بحكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟!
وقد ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام أسباب الإحداث في الشريعة، فعدَّ منها: تحكيم العقل، وتحسين الظن به، وقال: اعلم أن الله جعل للعقول في إدراكها حدًّا تنتهي إليه، لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلًا إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان، وما يكون، وما لا يكون، إذ لو كان كيف كان يكون!! فمعلومات الله لا تتناهى، ومعلومات العبد متناهية، والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى.
وقد دخل في هذه الكلية ذوات الأشياء جملة وتفصيلًا، وصفاتها وأحوالها، وأفعالها وأحكامها جملة وتفصيلًا، وأيضًا فالشيء الواحد من جملة الأشياء يعلمه الباري تعالى على التمام والكمال، بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أحواله، ولا في أحكامه، بخلاف العبد، فإن علمه بذلك الشيء قاصر ناقص، تعلق بذاته، أو صفاته، أو أفعاله، أو أحواله، أو أحكامه، وهو في الإنسان أمر مشاهد محسوس، لا يرتاب فيه عاقل، تخرجه التجربة إذا اعتبرها الإنسان في نفسه. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: عدَّ العلماء من دواعي البدعة تحسين الظن بالعقل، ويتأتى هذا من جهة أن المبتدع يعتمد على عقله، ولا يعتمد على الوحي، وإخبار المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيجره عقله القاصر إلى أشياء بعيدة عن الطريق المستقيم، فيقع بذلك في الخطأ، والابتداع، ويظن أن عقله موصله، فإذا هو مهلكه؛ وهذا لأن الله جعل للعقول في إدراكها حدًّا تنتهي إليه، لا تتعداه، من ناحية الكم، ومن ناحية الكيف.
أما علم الله سبحانه فلا يتناهى، والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى، ويتخلص من ذلك:
(1) أن العقل ما دام على هذه الصورة لا يجعل حاكمًا بإطلاق، وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق، وهو الشرع، والواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم، ويؤخر ما حقه التأخير.
(2) إذا وجد الإنسان في الشرع أخبارًا يقتضي ظاهرها خرق العادة المألوفة -التي لم يسبق له أن رآها، أو علم بها علمًا صحيحًا- لا يجوز له أن يقدم بين يديه لأول وهلة الإنكار بإطلاق، بل أمامه أحد أمرين:
الأول: إما أن يصدق به، ويكل العلم فيه للراسخين في العلم، والمتخصصين فيه، متمثلًا بقوله تعالى: {والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا}.
الثاني: يتأول على ما يمكن حمله عليه من الآراء بمقتضى الظاهر، ويحكم هذا كله قوله تعالى: {ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون}، وقوله: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلًا}. اهـ.
ولهذا لم يكن مستغربًا أن يأتي في الأحكام الشرعية ما يعزب عن بعض العقول معرفته، ولا تدرك حكمته، وإلا فقد أمر الله الخليل إبراهيم -عليه السلام- بقتل ابنه، وحيده، وهو الولد الصالح البار، دون أن يتقدم لذلك ما يوجبه في حكم العقل، وحدود معرفة البشر، وقد قدَّر الله تعالى على مريم العذراء البتول أن تحمل بابنها عيسى عليه السلام دون أن يمسها بشر، وفي هذا من أسباب التهمة لها ما لا يخفى، وهي من هي! وحرَّم الله تعالى على بني إسرائيل الصيد يوم السبت، وقدَّر سبحانه أن تأتيهم الأسماك في هذا اليوم متكاثرة، ظاهرة على سطح الماء، وفي غيره من الأيام لا يأتيهم منها شيء! والأسماك في ذاتها لا تتفاوت نفعًا وضرًّا في سائر الأيام، فلماذا حرمت يوم السبت، وأبيحت في غيره؟ وأمور كثيرة غير هذا، مما قد تستغربه بعض العقول، وهو ثابت نصًّا في القرآن الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ولذلك نص أهل العلم على أن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، ولكنه لا يمكن أن يأتي بما تستحيله العقول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح: الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- .. يخبرون بما يعجز عقول الناس عن معرفته، لا بما يعرف في عقولهم أنه باطل، فيخبرون بمحارات العقول، لا بمحالات العقول. اهـ.
وقال أيضًا: يجب الفرق بين ما يعلم العقل بطلانه وامتناعه، وبين ما يعجز العقل عن تصوره ومعرفته، فالأول من محالات العقول، والثاني من محارات العقول، والرسل يخبرون بالثاني، وأما الأول: فلا يقوله إلا كاذب، ولو جاز أن يقول هذا، لجاز أن يقال: إن الجسم الواحد يكون أبيض أسود في حال واحدة، وإنه بعينه يكون في مكانين، وإن الشيء الواحد يكون موجودًا معدومًا في حال واحدة، وأمثال ذلك مما يعلم العقل امتناعه. اهـ.
وقال في (درء تعارض العقل والنقل): لا ريب أن الرسل- صلوات الله عليهم- يخبرون الخلق بما تعجز عقولهم عن معرفته، ولا يخبرونهم بما يعلمون امتناعه، فهم يخبرونهم بمحارات العقول، لا بمحالاتها، فمن أراد أن يعرف ما أخبرت به الرسل بعقله، كان شبيهًا بمن قال الله تعالى فيه: {وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته}، وقال: {بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة}. اهـ.
وعلى أية حال؛ فإننا لا نستطيع أن نوفي هذا المقام حقه في التوضيح والبيان؛ ولذلك نحيل الأخ السائل على رسالة الدكتوراه للدكتور عبد الله بن صالح العجيري، وهي بعنوان: (ينبوع الغواية الفكرية) ففيه بحث نفيس عن مزالق هدْر نصوص الشريعة، وكان المزلَق الخامس منها: مشكلة العقل، وقد عالج الباحث ذلك من خلال النقاط التالية:
أولًا: مقدمات حول العقل.
ثانيًا: منزلة العقل في الخطاب الشرعي.
ثالثًا: مجالات العمل العقلي.
رابعًا: العقل بين الوحدة والاختلاف.
خامسًا: سؤال التعارض بين العقل والنقل.
سادسًا: شيء من مآلات المعارضة العقلية. اهـ.
وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 39932.
وأخيرًا: ننبه على أن ما ثبت عن الله ورسوله، من كبير الأمور وصغيرها، لا يسع المؤمن أن يردَّه، أو يرفضه، لا بدعوى مخالفة العقل، ولا بغيره من الدعاوى، قال تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء: 65]، وقال عز وجل: وَيَقُولُونَ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يأتوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (52) [النور].
والله أعلم.

 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 
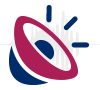

 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات