السؤال
هل يجوز لي أن أعتبر السنة مبينة للقرآن، وموضحة له، ومكملة، وشارحة، ومفصلة. ولكن لا أعتبرها مناقضة، ولا معارضة له، ولا آتية بتشريع جديد، وعليه فيكون مبدئي هو الحكم على الحديث بالوضع، بمجرد أن يكون مناقضا للقرآن، ومتعارضا معه، أو فيه تشريع جديد، ولا أتعب نفسي بأقوال البشر من العلماء الذين ملؤوا الدنيا بــ: قيل، وقال، واختلف، واستحسن، ورجحوا، وذهب قوم...إلخ.
في الوقت يعلمون أن تدوين أي شيء من الدين غير القرآن والسنة، لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم، بل منع من تدوين السنة في فترة من الفترات، واستمر على ذلك خلفاؤه الراشدون، وهم أدرى بقصده، وأعلم بمصالح الأمة.
من الأمثلة على مناقضة بعض السنة للقرآن -لكونها غير صحيحة- كونه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وأنه حكم على بعض الجاهلية بالنار؛ بينما القرآن يصرح بأنه وجده ضالا فهدى، ووجده عائلا فأغنى.فكما أننا لا نتصور بقاء أي جزء من الضلال معه، فكذلك لا نتصور بقاء أي جزء من العيلة والفقر معه. فكيف بفقر يحوجه للارتهان من يهودي؟
وكذلك حكم بأن كل من دخل النار سيسأل: ألم يأتكم نذير... وسيجيب بــ: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا...إلخ.
كيف تزول عني شبهة ضعف أغلب السنة؛ لأن الإمام مالكا -رحمه الله- بذل غاية جهده من أجل جمع كل ما صح له عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه -رضي الله عنهم- وتابعيهم -رحمهم الله- ومع ذلك لم يصل ما جمع إلا إلى مجلد واحد، متوسط الحجم، وعدد الأحاديث المرفوعة فيه حوالي 600 حديث.
ثم لاحظنا أنه كلما تأخر الزمن وكثر الكذابون وأهل الأهواء، جاء من العلماء من يروي مزيدا من الأحاديث، لتصل أحيانا إلى 7 آلاف حديث، و10 آلاف وأكثر!
فكيف نقتنع بأن كل هذه الأحاديث مما يجب على المسلم العمل به، في الوقت الذي صرح القرآن بأن السنة مفصلة فقط، ومبينة وموضحة، أما أن تعارض، أو تؤسس لشرع جديد، فهذا هو ما أريدك أن تقنعني به، أو تدلني على بحث في الموضوع لأعود إليه.
ثم إن المتقدمين كأحمد وابن مهدي والقطان...وغيرهم، صرحوا بأن جميع الحديث الصحيح لا يتجاوز 4 آلاف حديث، أو 4400. فما بال من تأخر بعدهم صحح ضعف هذا العدد، حتى وصلنا الآن لحوالي 20 ألف حديث صحيح، كما قال الحويني حول الصحيح من السنة!
فهل إذا طالت بنا الحياة، أو جاءت قرون بعدنا، سوف يصل الحديث الصحيح مائة ألف حديث مثلا؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد جمع السائل في سؤاله عدة أسئلة، وشبهات، يضيق المقام عن تتبعها، وأيضا فإننا ذكرنا مرارا أن من سياسة الموقع في الإجابة عن الأسئلة المتعددة، أن لا يجاب إلا عن سؤال واحد منها.
ولذا فسنجيبه عن بعض ما سأل، ونحيله إلى بعض الفتاوى التي أجابت عن مثل الشبهات التي ذكرها السائل.
فنقول: أما كون السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم شارحة للقرآن، ومبينة، ومفصلة له، وغير معارضة، ولا مناقضة له، فحق لا ريب فيه.
وأما كونها لم تأت بتشريع جديد، بمعنى أن ما أفادته من أحكام لم توجد في القرآن يعتبر لاغيا؛ لكونه ليس في القرآن، فباطل لا ريب فيه؛ فإن الله جل وعلا قال: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:3، 4] وقال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا {الحشر:7}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي رافع رضي الله عنه. وفي لفظ لأحمد والترمذي وابن ماجه: ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما حرم الله.
فما استفيد من الأحكام بنصوص السنة الثابتة، حكمه حكم ما استفيد من القرآن، ولا يقال إنه تشريع جديد، ولا أننا غير ملزمين بالعمل بمقتضاه.
وأما دعوى الحكم على الحديث بالوضع بمجرد كونه مناقضا للقرآن، ومتعارضا معه، فإن هذه الدعوى لا تصدق على السنة الصحيحة، فإن ما صحت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعارض مع القرآن؛ إذ كل ذلك وحي من عند الله تعالى كما سبق، فلا يجوز التفريق بين القرآن والسنة، ونصب الخلاف بينهما، فكلٌّ من عند الله تعالى من حيث المصدر.
قال الشاطبي -رحمه الله- في كتابه الاعتصام: فَعَلَى النَّاظِرِ فِي الشَّرِيعَةِ بِحَسَبِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ أَمْرَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِ الْكَمَالِ لَا بِعَيْنِ النُّقْصَانِ، وَيَعْتَبِرَهَا اعْتِبَارًا كُلِّيًّا فِي الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ، وَلَا يَخْرُجَ عَنْهَا الْبَتَّةَ؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ عَنْهَا تِيهٌ وَضَلَالٌ، وَرَمْيٌ فِي عَمَايَةٍ، كَيْفَ وَقَدْ ثَبَتَ كَمَالُهَا وَتَمَامُهَا؟ فَالزَّائِدُ وَالنَّاقِصُ فِي جِهَتِهَا هُوَ الْمُبْتَدِعُ بِإِطْلَاقٍ، وَالْمُنْحَرِفُ عَنِ الْجَادَّةِ إِلَى بُنَيَّاتِ الطُّرُقِ.
وَالثَّانِي: أَنْ يُوقِنَ أَنَّهُ لَا تَضَادَّ بَيْنَ آيَاتِ الْقُرْآنِ، وَلَا بَيْنَ الْأَخْبَارِ النَّبَوِيَّةِ، وَلَا بَيْنَ أَحَدِهِمَا مَعَ الْآخَرِ، بَلِ الْجَمِيعُ جَارٍ عَلَى مهْيَع وَاحِدٍ، وَمُنْتَظِمٍ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، فَإِذَا أَدَّاهُ بَادِئَ الرَّأْيِ إِلَى ظَاهِرِ اخْتِلَافٍ، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَقِدَ انْتِفَاءَ الِاخْتِلَافِ؛ لِأَنَّ الله تعالى قَدْ شَهِدَ لَهُ أَنْ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، فَلْيَقِفْ وُقُوفَ الْمُضْطَرِّ السَّائِلِ عَنْ وَجْهِ الْجَمْعِ، أو المسلم من غير اعتراض، إن كان الموضع مما لا يتعلق به حكم عملي، فإن تعلق به حكم عملي، التمس الْمَخْرَجَ حَتَّى يَقِفَ عَلَى الْحَقِّ الْيَقِينِ، أَوْ يبقى بَاحِثًا إِلَى الْمَوْتِ، وَلَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا اتَّضَحَ لَهُ الْمَغْزَى وَتَبَيَّنَتْ لَهُ الْوَاضِحَةُ، فلا بد لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَهَا حَاكِمَةً فِي كُلِّ مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا. وَيَضَعَهَا نُصْبَ عَيْنَيْهِ فِي كُلِّ مَطْلَبٍ دِينِيٍّ، كَمَا فعل من تقدمنا ممن أثنى الله ورسوله عَلَيْهِمْ. انتهى.
وأما قول السائل: ولا أتعب نفسي بأقوال البشر من العلماء الذين ملؤوا الدنيا بــ : قيل، وقال ... إلخ. فلا ريب أن في هذا الكلام تنقصا لعلماء الأمة، الذابين عن سنة سيد المرسلين، وحطا من مكانتهم التي نوه بشأنها القرآن والسنة. قال تعالى: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ {آل عمران:18}، وقال تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ {فاطر:28}، وفي الحديث: العلماء ورثة الأنبياء.
فنصيحتنا للسائل التوبة إلى الله، وأن يذكر العلماء بالجميل، خصوصا علماء السلف منهم.
قال الإمام الطحاوي -رحمه الله- في عقيدته المشهورة: وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْأَثَرِ، وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ، فهو على غير السبيل. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 8516. ففيها الكلام على كتابة الحديث وتدوينه.
وكذلك راجع الفتوى رقم: 137308، ففيها الرد على بعض الشبهات التي ذكرها السائل.
والله أعلم.

 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

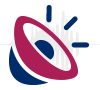
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات