خلاصة الفتوى:
عمر وخالد رضي الله عنهما من أجل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم إجلالهم وتعظيمهم وحبهم، ولا يُسمع لأصحاب الأهواء المضلة فيما يشيعونه عنهم من أكاذيب وافتراءات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عمر شهد بفضله وعلمه واستقامته على الطاعة وقوته في الحق النبي صلى الله عليه وسلم وخيار الصحابة ومنهم علي وابن مسعود وابن عباس، وقد قدمنا طرفاً من ذلك في عدة فتاوى فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 40659، 18130، 35953، 31042، 49891.
وما ذكر عن عمر في قضية الخمر من سؤاله الله أن يبين فيها بياناً شافياً عده أهل العلم من موافقات الوحي لعمر وعدوه من مناقبه، واتهامه بما سوى ذلك إفك وبهتان عظيم مدعيه هو المطالب بالبينة وأنى له ذلك، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 16296، والفتوى رقم: 62984.
وأما خالد بن الوليد رضي الله عنه فهو صحابي جليل وسيف من سيوف الله سله الله على الكافرين والمنافقين، فكرهوه وأبغضوه وافتروا عليه كما فعلوا بكبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مات وهو عنهم راض، فكانت فعلتهم هذه بينة على أمرهم ونفاقهم وكفرهم ولتستبين سبيل المجرمين، قال أبو زرعة وهو أجل شيوخ الإمام مسلم: إذا رأيت الرجل ينتقص امرأً من الصحابة فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به الحق، وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة، فيكون الجرح به أليق، والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق -قال العلامة ابن حمدان في نهاية المبتدئين: من سب أحداً من الصحابة مستحلا كفر، وإن لم يستحل فسق، وعنه يكفر مطلقاً، ومن فسقهم أو طعن في دينهم أو كفرهم كفر. انتهى.
وأما بخصوص ما ذكر عن خالد رضي الله عنه فالواجب الرجوع فيه إلى ثقات من أهل العلم ومحققي التاريخ الإسلامي والعدول من المؤرخين كالذهبي وابن كثير وابن الجوزي وابن الأثير... ولا اعتماد بأي شكل على قوم بهت ضلال كذبة، قال فيهم أهل العلم: هم أشد على الإسلام من اليهود والنصارى، لم يستطيعوا أن ينالوا من رسول الله فنالوا من دينه ومن صحابته، وقد أورد الإمام الذهبي خبر خالد رضي الله عنه وذكر أن هذا الرجل الذي قتله خالد كان قد اختلف الناس في إسلامه فلم يقدم خالد على قتله إلا وهو يظن كفره، وأن أبا بكر رضي الله عنه لما علم بقتل خالد له عذره، جاء في سير أعلام النبلاء: عن ابن أبي ذئب، عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قدم أبو قتادة على أبي بكر فأخبره بقتل مالك بن نويرة وأصحابه، فجزع وكتب إلى خالد، فقدم عليه فقال أبو بكر: هل تزيدون على أن يكون تأول، فأخطأ؟ ثم رده وودى مالكاً ورد السبي والمال. وعن إسحاق قال: دخل خالد على أبي بكر فأخبره واعتذر فعذره. انتهى.
وما قلناه في مسألة قتله لمالك نقوله في زواجه من زوجته كان ذلك مبني على ذلك، وهذا هو الظن بصحابة رسول الله خاصة أهل الفضل منهم كخالد سيف الله ونصر الإسلام وفخر المجاهدين، والذي ورد في مناقبه ما يخزي الأعداء، ويستحي منه الجبناء، جاء في تاريخ الإسلام للإمام الذهبي: مناقب خالد كثيرة ساقها ابن عساكر، من أصحها ما رواه ابن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت خالد بن الوليد أتي بسم، فقال: ما هذا، قالوا: سم، فقال: باسم الله. وشربه.
وروى يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال: قالوا لخالد: احذر الأعاجم لا يسقونك السم، فقال: ائتوني به، فأتى به، فاقتحمه وقال: بسم الله فلم يضره شيئاً، وقال الأعمش عن خيثمة قال: أتى خالداً رجل معه زق أحمر، فقال: اللهم اجعله خلاً فصار خلاً.
جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن أنس بن عباس قال: وقع بين خالد بن الوليد وعمار كلام، فقال عمار: لقد هممت أن لا أكلمك أبداً، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد ما لك ولعمار، رجل من أهل الجنة قد شهد بدراً، وقال: يا عمار؛ إن خالداً سيف من سيوف الله على الكفار، قال خالد: فما زلت أحب عماراً من يومئذ.
سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل قال: بلغ عمر أن نسوة من نساء بني المغيرة قد اجتمعن في دار يبكين على خالد بن الوليد، فقال عمر: ما عليهن أن يبكين أبا سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة.
وحشي بن حرب بن وحشي، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر عقد لخالد وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله على الكفار والمنافقين. رواه أحمد في مسنده. انتهى.
وأخيراً ننبه الأخ السائل إلى أن المسلم إذا لم يكن على قدم راسخة في العلم الشرعي فلا ينبغي له الاطلاع على كتب الضلالة أو مجادلة أهلها، لأن ذلك قد يوقع في قلبه شبهة يصعب عليه التخلص منها، كما ننبهه إلى أن أهل السنة لا يقولون بعصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكن مع ذلك يعرفون لأهل الفضل فضلهم ويقدرون الصحابة قدرهم ويؤدون لهم حقهم ويتأولون لهم زلاتهم ويسكتون عن هفواتهم ولا يشيعونها، ويردون الآثار المروية في مساوئهم من وجوه:
الوجه الأول: أن هذه الآثار منها ما هو كذب قد افتراه أعداؤهم ليشوهوا سمعتهم.
الوجه الثاني: أن هذه الآثار منها ما قد زيد ونقص فيه وغير عن وجهه الصحيح ودخله الكذب، فهو محرف لا يلتفت إليه.
الوجه الثالث: أن ما صح من هذه الآثار -وهو القليل- هم فيه معذورون لأنهم إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون- فهو من موارد الاجتهاد الذي إن أصاب المجتهد فيه فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور، لما في الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه.
الوجه الرابع: أنهم بشر يجوز على أفرادهم الخطأ، فهم ليسوا معصومين من الذنوب بالنسبة للأفراد، لكن ما يقع منهم فله مكفرات عديدة منها:
1- أن يكون قد تاب منه -والتوبة تمحو السيئة مهما كانت- كما جاءت به الأدلة.
2- أن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم -إن صدر- قال تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ {هود:114}.
3- أنهم تضاعف لهم الحسنات أكثر من غيرهم ولا يساويهم أحد في الفضل، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به أفضل من جبل أحد ذهباً إذا تصدق به غيرهم. متفق عليه...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم، بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم، والله تعالى يغفر لهم بالتوبة ويرفع لهم درجاتهم ويغفر لهم بحسنات ماحية أو بغير ذلك من الأسباب، قال تعالى: وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ* لَهُم مَّا يَشَاءونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ* لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. انتهى.
قال شارح الطحاوية: فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين، كما نطق به القرآن خصوصاً الذين هم ورثة الأنبياء، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدي بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم فإنهم خلفاء الرسول من أمته، والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقاً يقيناً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد له من تركه من عذر... إلى أن قال: فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق، وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ. انتهى.
والله أعلم.

 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 
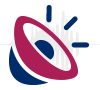

 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات